

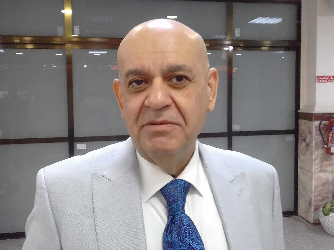
قصيدة ربيئة المعرفة للشاعر فرات صالح: مقاربة ادراكية
عادل الثامري
المقدمة:
تتأسس هذه المقاربة النقدية لقصيدة "ربيئة المعرفة" للشاعر فرات صالح على رؤية تأويلية تستثمر مفاهيم المقاربات الإدراكية لاستكناه التشكيل الدلالي العميق للنص. ينطلق المقال من فرضية أن الوضعية التأملية التي يتخذها المتكلم في القصيدة تمثل منظومة إدراكية استثنائية تُعيد بناء العلاقة المعرفية بين الذات والعالم. فمن خلال استعارة "الربيئة" المكانية المحورية، يتأسس فضاء شعري يكشف عن تناقض جوهري: أن الإدراك الأقصى للحقيقة لا يحرر بل يسجن، ولا يضيء بل يُظلم، ولا يؤنس بل يوحش. ان تحليل اليات الاستعارات التصورية وتقويض الخطاطات المعرفية المألوفة التي يوظفها النص تهدف للكشف عن البنية التحتية للتجربة الشعرية بوصفها مأساة معرفية.
ربيئة المعرفة بوصفها موقعًا إدراكيًا
يشكل الفضاء الشعري في قصيدة "ربيئة المعرفة" نقطة مراقبة معرفية عليا يتموقع فيها المتكلم في موضع إدراكي فريد يسمح له برؤية متجاوزة لما يتيحه الإدراك الحسي العادي. فصورة "الربيئة" — وهي نقطة رصد عسكرية عالية — تُستثمر بوصفها استعارة مكانية تكوّن موضع الإدراك أو وجهة النظر الإدراكية، وهي نقطة داخل فضاء الخطاب تتموضع فيها ذات واعية لكي تدرك، وتصف، وتؤوِّل معطيات محيطها ضمن إطار معرفي مخصوص
إن وضع المتكلم في "الربيئة"، وهو مكان يتمتع بعلو استراتيجي، لا يحيل إلى تفوق بصري أو قدرة كشف حسية فحسب، بل ينهض بوظيفة إدراكية ترميزية تتجلى في قدرته على النفاذ إلى البنى التحتية للواقع: "المخابئ تحت الأرض"، "السكين خلف الظهر"، و"الأشياء حين تولد وحين تفنى". هذا الموقع الإدراكي لا يُنتج إدراكًا حسّيًا مباشرًا بقدر ما يُستثمر كآلية تأويلية ضمن فضاء ادراكي موسع يُعاد فيه تأطير التجربة وفق نماذج استنتاجية وشبه-كلية تقوم على الربط بين المشهد الظاهري والنيّات أو الحقائق الكامنة خلفه. وتقترح هذه الصورة الشعرية أن موضع الإدراك ليس حياديًا أو بريئًا، بل هو محمّل فكريا، وينتمي إلى ما يمكن وصفه بـالنقطة الإدراكية المتعالية التي تمنح المتكلم قدرة خارقة على الإدراك، شبيهة بامتلاك "نظارة الأزل"، وهي استعارة زمنية تحيل إلى امتداد الرؤية عبر الزمن، من الولادة إلى الفناء.
وضمن هذا الإطار، تتحول الذات المتلفظة من فاعل شعري إلى ذات مراقِبة تتماهى مع سلطة المعرفة الكلية، لكنها في الوقت نفسه تُستلب من قِبل عبء هذه المعرفة. وهذا يتقاطع مع ما تقترحه نظرية الفضاءات الذهنية في أن وجهة النظر الإدراكية تُبنى عبر إسقاط فضاء مرجعي معرفي (فضاء الرؤية الكلية) على الفضاء الأساسي للنص الشعري، مما يولد طبقة إدراكية إضافية تُعيد تشكيل العلاقات بين الذات والعالم، وتعيد ترميز التجربة من منظور يتجاوز السياق المباشر. وبهذا، لا تعود "الربيئة" مجرد موضع مكاني، بل تتحول إلى مجاز إدراكي يفتح أفقًا معرفيًا مفرطًا في شمول رؤيته، لكنه في ذات الوقت يُنتج مأزقًا وجوديًا يرتبط بآثار هذا التموقع الإدراكي العالي، وهو ما سيمهد لاحقًا لجدلية الصعود والنزول في بنية النص.
الاستعارات التصورية وتمثيل المعرفة المؤلمة
ينبني النص الشعري على شبكة كثيفة من الاستعارات التصورية التي تُعيد تأطير التجربة الادراكية للمتكلم بوصفها عبئًا إدراكيًا وألمًا وجوديًا، لا كشفًا مريحًا أو استنارة مطمئنة. وتستند هذه الاستعارات إلى فكرة أن اللغة، في جوهرها، مؤسسة على استعارات تصورية كامنة تنبع من التجربة الجسدية والوجودية للإنسان، وتُسقط هذه التجربة على مفاهيم تجريدية مثل المعرفة، الزمن، أو الحقيقة. وفي هذا السياق، يمكن رصد عدد من البُنى الاستعارية المركزية التي تؤطر رؤية المتكلم:
المعرفة = رؤية: يتجلى هذا النموذج الاستعاري من خلال قول المتكلم: "ترى ما لا يراه الآخرون". هذه الصيغة تُفعل استعارة تصورية راسخة مفادها أن الفهم هو رؤية. وبذلك تصبح الرؤية فعلًا ذهنيًا، لا بصريًا، وتُعاد صياغة عملية الإدراك المعرفي باعتبارها قدرة على "الإبصار الداخلي" أو "الرؤية الكاشفة"، وهو ما يمنح الذات المتكلمة موقعًا معرفيًا متمايزًا لكنه مُثقل بالنتائج.
الحقيقة = أشياء خفية: تُستثمر في النص استعارات متفرعة من نموذج مركزي يُمثّل الحقيقة شئ مخفي يجب كشفه. تظهر هذه البنية في صور مثل: "المخابئ تحت الأرض"، "السكين خلف الظهر"، "الزوجة في أحضان صديقك". تمثل هذه الصور جميعها طبقات مضمرة من الواقع، تحجبها السطحيات، لكنها تنكشف بفعل "الرؤية العارفة" للمتكلم. تُشير هذه الاستعارات إلى بنية إدراكية تُعرف بـ “النموذج الإسقاطي"، حيث تُسقط نية أو حقيقة خفية على تمثيل مرئي مُضلل.
الزمن = حركة: يُعيد الشاعر تأطير الزمن بوصفه كيانًا متحركًا: "الأزمنة المتحركة". تستند هذه الصورة إلى استعارة تصورية شائعة ترى أن الزمن حركة. ولكن بدل أن يُقدَّم الزمن كخط تقدّمي أو كمجال للرجاء، فإنه يُطرح هنا كقوة متحركة غير مستقرة، تعزز الإحساس بانفلات المعنى وتآكل المرجع.
الوعي = عبء: على الرغم من أن هذه البنية لا تُذكر مباشرة، إلا أن حضورها مهيمن ضمنيًّا في النص. فكلما توسعت قدرة المتكلم على الرؤية (المعرفة)، ازداد شعوره بالألم، إلى أن يصل إلى عتبة الندم والرغبة في الانسحاب: "لكنه في الوقت نفسه مؤلم جداً لدرجة أنك ستتمنى النزول". هذه النهاية تُعيد تأويل تجربة الوعي الإدراكي الكامل باعتبارها تجربة مأساوية، وتنقل الاستعارة من طورها الإدراكي إلى طورها الوجودي. فالمعرفة ليست إنارة، بل لعنة.
تُظهر هذه الاستعارات أن البنية الإدراكية للنص لا تهدف إلى إنتاج معرفة مريحة، بل إلى كشف الفضاءات الذهنية المؤلمة، حيث تتولد المعاني عبر إسقاطات بينية بين فضاءات معرفية تتضمن عناصر متناقضة أو متصادمة. فالمعرفة تُنتج رؤيةً لصدمات لا يمكن التكيف معها إدراكيًا، مما يؤدي إلى مفارقة تصورية: المعرفة التي تُحرّر تصبح في النص ذاته قيدًا جديدًا.
انحراف الخطاطات الذهنية وتقويض السيناريوهات المألوفة
ينخرط نص "ربيئة المعرفة" في اشتغال مكثف على ما تُسميه اللسانيات الإدراكية بـالخطاطات الذهنية والسيناريوهات الادراكية، بوصفها أنماطًا تنظيمية مسبقة تُشكِّل إدراك الإنسان اليومي للواقع وتوجه توقعاته حول سير الأحداث. فالمعرفة البشرية، وفقًا لمدرسة Schank & Abelson (1977)، لا تُبنى فقط على معطيات جديدة، بل تُفهم عن طريق استدعاء بنى عقلية نمطية ترشد تفسير الظواهر بناءً على "توقعات مُضمنة".
في ضوء هذا المنظور، يقوم النص بتفعيل عدد من الخطاطات المألوفة — مثل خطاطة الأسرة، الصداقة، الطفولة، الحياة اليومية — ثم يعمل على تفكيكها أو تشويهها معرفيًا عبر الكشف عن مفارقات مأساوية تقع داخلها. فبدل أن تمثل هذه الخطاطات بيئة آمنة مستقرة، تتحول في سياق النص إلى فضاءات خادعة تتضمن خيانة، اختفاء، وانقلابًا في الأدوار القيمية.
خطاطة الأسرة وتحوّلها إلى مشهد تهديدي : تظهر هذه البنية في عبارة: "الزوجة في أحضان صديقك". هنا يتم انتهاك سيناريو معرفي مركزي يتمثل في أن الأسرة فضاء للأمان والعلاقة الزوجية مؤسسة على الثقة. لكن النص يُقوّض هذه الخطاطة عبر تقديم مشهد خيانة مزدوجة: من الزوجة، ومن الصديق. ينتج عن هذا الانحراف انهيار للثوابت الأخلاقية والادراكية، ويؤسس لتجربة إدراكية مشوشة يُعاد فيها تقييم القيم والعلاقات.
خطاطة الطفولة والموت المفاجئ للبراءة : في قوله: "وطفلك في ثياب الموت"، يفجّر النص خطاطة الطفولة بوصفها رمزًا للحياة، الاستمرارية، والنقاء. حين يُدمج "الطفل" بـ"ثياب الموت"، يُنتج النص استعارة صادمة تعكس مفارقة إدراكية حادة، يتم من خلالها تكسير التوقع المعرفي حول الفئات العمرية ومعانيها الرمزية. يُعاد هنا إنتاج سيناريو مأساوي ادراكي لا يستقيم مع النمط الإدراكي المألوف، مما يزرع داخل المتلقي شعورًا بالخلل الوجودي والمعرفي في آن.
خطاطة الصداقة وانكشاف الغدر الكامن : يُقدّم النص صورة الصديق — المفترض أن يكون ملاذًا وجدانيًا — في دور العاشق الخفي لزوجة المتكلم، مما يطيح بالخطاطة الادراكية التي تقوم على الثقة، الدعم، والانتماء العاطفي المتبادل. يُنتج هذا التحول بنية إدراكية مشحونة بالتضاد والتقويض، تتكامل مع مجمل المشهد المعرفي الذي يطرحه النص، بوصفه كشفًا لأقنعة اجتماعية زائفة.
هذه الانزياحات المتعمدة عن الخطاطات لا تمثل فقط تحولات في مضمون الصور، بل تؤسس لما يمكن وصفه بـالانهيار الإدراكي للسيناريوهات المرجعية، حيث لا تعود البنى الذهنية التقليدية صالحة لفهم الواقع الذي تكشفه "الربيئة". وهنا تظهر وظيفة الشاعر كمراقب إدراكي، لا يُعيد إنتاج العالم وفق ما هو متوقع، بل يكشف عن طبيعته المتشظية عن طريق التلاعب المنهجي بالبنى الذهنية المألوفة. تؤدي هذه التقنية إلى خلق المفاجأة الادراكية، وهي حالة ينتجها تصادم التوقعات مع الوقائع داخل الفضاء التخييلي، مما يُرغم المتلقي على إعادة بناء خطاطاته التأويلية بصورة أكثر تشكيكًا وتعقيدًا.
الخاتمة:
تقدم قصيدة "ربيئة المعرفة" محاولة لإعادة تعريف للمعرفة، إذ تزيح عنها رداء الاستنارة وتلبسها ثوب المأساة الوجودية. إن الربيئة—ذلك المرصد المعرفي المتعالي—لا تشكل امتيازًا إدراكيًا بقدر ما تمثل مصيدة معرفية تنصبها الحقيقة للعارف. فالنص، وهو يفكك استقرار الخطاطات الذهنية المألوفة ويعرّي البنى الاستعارية المطمئنة، يؤسس لشعرية الكشف المؤلم التي تقلب المفاهيم التقليدية رأسًا على عقب: فالجهل يغدو نعمة، والمعرفة تتحول إلى نقمة.


 - قراءة في كتاب ذاتك من المعرفة إلى المسؤوليَّة للدكتور زامل العريبي
- قراءة في كتاب ذاتك من المعرفة إلى المسؤوليَّة للدكتور زامل العريبي
 قراءة نقدية مختصرة : حين تُهزم التيجان أمام القصيدة:
قراءة نقدية مختصرة : حين تُهزم التيجان أمام القصيدة:
 ميدان الحرب الجديد.. مقاربة بين الإنسان والذكاء الإصطناعي
ميدان الحرب الجديد.. مقاربة بين الإنسان والذكاء الإصطناعي
 جدلية الحياة والموت في قصيدة (طَور)
جدلية الحياة والموت في قصيدة (طَور)
 الاستثمار في رأس المال البشري… من بناء المعرفة إلى صناعة الإنسان
الاستثمار في رأس المال البشري… من بناء المعرفة إلى صناعة الإنسان
 اعادة توظيف الرموز في (رمق الهالات) للشاعرسوران محمد
اعادة توظيف الرموز في (رمق الهالات) للشاعرسوران محمد
 رقصة الروح في قصيدة .. على أمَلٍ للشاعرة وداد الواسطي
رقصة الروح في قصيدة .. على أمَلٍ للشاعرة وداد الواسطي
 سؤال القصيدة لعذاب الركابي.. قراءة في إستفهام الذات
سؤال القصيدة لعذاب الركابي.. قراءة في إستفهام الذات
