

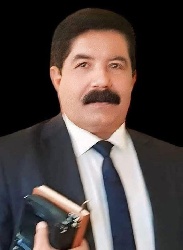
بلاغة الألم وصوت الذات
دراسة تاريخية وفلسفية حديثة لصرخة “يا ليل ... يا عين للشاعر حامد خضير الشمري
عبدالكريم الحلو
( 1 ) القراءة النقدية التاريخية :
---------------------------
من الندبة إلى القصيدة :
الذات والتاريخ معاً في شعر الشمري :
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تمهيد:
* تحمل قصيدة “يا ليل! يا عين !” للشاعر حامد خضير الشمري ملامح الانفعال الذاتي الممزوج بوعي تاريخي ووجداني يتكئ على تجربة مريرة تعبر الذات خلالها بوابة الرماد نحو التوهج، فتشتبك بالوجدان القومي، وتُحمّل الرمز الشعري أبعادًا تاريخية، فلسفية، دينية، وصوفية.
* إنها ليست مرثية ذاتية فحسب، بل صرخة عارفٍ في وجه الزمن، واحتجاج نبوي على التحول القيمي في المجتمعات.
⸻
أولاً: التشكيل التاريخي للوجع :
--------------------------
* في هذه القصيدة، يحضر التاريخ لا بوصفه خلفية زمنية،
* بل كمادة شعرية. إذ يرسم الشاعر جدلية القيم بين زمنين:
• زمن النقاء والمبدأ
• وزمن السقوط والمساومة
“ولا تبِعْ خيرَ ما أوتيتَ عن سَفَهٍ
لو السماواتُ فوق الأرضِ تنطبقُ”
* البيت يستعيد بنية الإنذار الأخلاقي، ويُحيل إلى نموذج الأنبياء والمرسلين في رفض المساومة على القيمة،
* وكأنّ الذات هنا تتقمّص صوتًا رساليًا، ينبّه من سقوط القيم الذي بلغ ذروته في زمنٍ “صارت بضاعةُ أهلِ الدينِ كاسدةً”.
⸻
ثانياً: الأنا الشعرية بين صراخ الفرد
ونبوءة الجماعة :
-------------------------------
* القصيدة ليست سردًا لتجربة عاطفية فردية، بل مشروع احتجاجٍ تاريخي.
* فـ “الأنا” لا تتحدث عن عاشق مكلوم فحسب،
* بل عن “إنسان” يعيش تغرّبًا قيميًا ويواجه طعنات من أقرب الناس:
“جنبي وسكينُكَ الأعمى بخاصرتي
وكنتُ أنزفُ في صمتٍ وأحترقُ”
* هنا تتقاطع الأنا المسيحية (رمز الألم والفداء) مع الأنا العرفانية (التي تتطهر بالألم)، فتخرج من حدود الشاعر الفرد إلى فضاء الإنسان الجمعي.
⸻
ثالثاً: من رمزية يوسف إلى حكمة سليمان :
-------------------------------------
* يحضر التراث الأنبيائي والتاريخي ضمن القصيدة بإشارات دقيقة:
• “نزلتُ للجُبِّ طوْعاً”
- هي استعادة لقصة يوسف، لكنها مقلوبة، فالشاعر نزل للجب بإرادته لأنه لم يرد التواطؤ مع الفساد.
“ جاءت سليمانَ قبل العرشِ
مرغَمةً وقد أتتنيَ طوعاً”
- تشير إلى ملكة سبأ، إلا أن الشاعر يحمّل الصورة هنا أبعادًا وجودية وعاطفية: أن تأتيك “الحبيبة” طوعًا، فذلك تجلٍّ لأنوثة مقدّسة لا تُخضعها العروش.
- بهذا يدمج الشاعر بين التكوين التاريخي والبعد الأنثوي الصوفي.
⸻
رابعاً: الوجع بين ليل الغربة وعين الهوى :
-----------------------------------
“يا ليل ! يا عين ! والصَّهباءُ قد رقصتْ
وكاد نصفينِ مني القلبُ ينفلقُ”
* البيت يحمل رمزية النداء الشعبي، فهو يستعيد تركيبة التراث الغنائي العراقي والمصري “يا ليل يا عين”، لكن المعنى يتجاوز التواشيح إلى تمزق الذات.
* وفي استخدامه للـ “صهباء”، لا يخاطب الخمر في بعدها الحسي،
* بل يرمز بها إلى السكر الوجداني، الذي لا يفصله عن طيف الحبيبة إلا الأرق الوجودي.
⸻
خامساً: البنية المكانية للمعنى: الجب، الصحراء، الفردوس :
-----------------------------------
تمثل الصور الثلاث:
• الجب:
الهبوط القيمي والأخلاقي، لكنه هبوط إرادي طاهر.
• الصحراء:
التية، التهلكة، الجفاف الروحي.
• الفردوس:
النعيم الممكن، وهو امرأة متجسدة.
* هذه الأمكنة ليست مجرد فضاءات، بل تمثيلات تاريخية للمعنى والنجاة والسقوط، في عقل الذات الباحثة عن خلاصها.
⸻
سادساً: الخاتمة – الشعر بوصفه
ذاكرة تاريخية :
--------------------------------
* هذه القصيدة وثيقة أدبية تحتفظ ببنية الاحتجاج التاريخي، فهي ترثي الزمن الرديء لا كما يفعله الرثائيون، بل كما يفعل الأنبياء حين يكشفون زيف المجتمعات، وتفعل الصوفية حين تُحوِّل الألم إلى إشراق.
* هكذا، يخطُّ حامد خضير الشمري نصًا تاريخيًا بطعم الشعر،
* وشعريًا بطبيعة التاريخ، فيكون نصه سفرًا من سفراء الحرف العربي في زمن التيه.
⸻
( 2 ) القراءة النقدية الفلسفية :
-------------------------------
بلاغة الألم وصوت الذات:
* تتجلى في قصيدة “يا ليل! يا عين!” مظاهر التوتر الوجودي والقلق المعرفي عبر مفردات مضمخة بالحيرة، والتشظي، والمواجهة، حيث تتكثف “الأنا” في مواجهة كل ما هو زائف، وتستدعي الشاعرية لتكون حقل مقاومة فلسفية ضد التكلس القيمي.
* ٠القصيدة لا تقول الحقيقة فقط،
* بل تشكّك فيها، وتفككها، وتعيد تأملها، من منطلق أن الوجود ليس جوهرًا بل صيرورة،
* وأن الذات في الشعر ليست ثابتة، بل تُنتج ذاتها باستمرار من خلال التجربة والاختيار والألم.
⸻
أولاً: الذات المتشظية…
بين نيتشه وكيركغارد
------------------------
“جنبي وسكينُكَ الأعمى بخاصرتي
وكنتُ أنزفُ في صمتٍ وأحترقُ”
* هذا البيت لا يصف فقط حالة خيانة،
* بل يعكس صراع الذات مع الآخر العدمي الذي يقتل بلا وعي.
* هنا تتجلى فلسفة نيتشه في الرفض الصارخ لكل ما هو خامل ومخادع،
* مقابل كيركغارد الذي يرى أن الألم هو السبيل الوحيد للوصول إلى “الذات الأصيلة”.
* الذات التي تنزف في صمت ليست منهزمة،
* بل تُعيد خلق ذاتها على نار المعاناة،
* وهي ما أسماه هايدغر “الوجود الأصيل” الذي يواجه العدم دون تبرير.
⸻
ثانيًا: جدلية الإيمان والفسق
دين بلا قداسة :
-----------------------------
“يا عاذلي ومسوحُ الدين تثقلُهُ
صحراءُ قلبِكَ لا يجري بها الغَدَقُ”
* هنا تتصادم المقولة الدينية الظاهرية مع الواقع الميتافيزيقي الأجوف، حيث تتحول القداسة إلى قناع.
* الشاعر يكشف عن زيف المعنى،
* ويعلن انتماءه إلى “الطيش والنزق”،
* لا لأنه يحتقر العقل،
*
* بل لأنه يرى في الجنون الطاهر انفلاتًا من مؤسسات القهر.
* الطيش هنا ليس فوضى، بل حريّة. الشاعر يمارس ما يسميه ميشيل فوكو:
“ اللاعقل بوصفه مقاومة للسلطة”.
⸻
ثالثًا: الحب كعقيدة ميتافيزيقية :
----------------------------
“لي رُكعتانِ بمحرابِ الهوى بهما
بابُ الخطيئةِ والآثامِ تنغلقُ”
* الحب هنا ليس علاقة شخصية،
* بل محراب وجودي.
* الركعتان لا تنتميان إلى طقس ديني،
* بل إلى طقس عشقي،
* يُغني الذات عن كل الذنوب
* حين تذوب في المطلق.
* في هذه اللحظة، تتحول الحبيبة إلى “المقدّس الآخر”، وتتحقق فيها فكرة الأنوثة المطلقة كما يراها “جورج باتاي”:
* “ المرأة هي الاتصال الوحيد بالمقدّس في هذا العالم المحكوم بالخراب”.
⸻
رابعًا: هيرمينوطيقا الخلاص:
من الجُبّ إلى النور
“نزلتُ للجُبِّ طوْعاً حينما تركوا
عندي المتاعَ أمامَ الذئبِ واستبقوا”
* نحن أمام إرادة هبوط واعٍ، على عكس يوسف الذي أُجبر على النزول.
* الشاعر يختار النزول إلى الجُب لا من باب الهزيمة، بل لأن في القاع وضوحاً لا يخدع، ولأن الذئب أوضح من الإنسان الزائف.
* هذا التمرد يُعيد تأويل مفهوم “الخلاص”،
* فالشاعر لا ينتظر قافلة تنقذه،
* بل يؤسس خلاصه من داخله.
* في عمق الظلام، يعثر على نوره، فيتجسد الوعي كابنٍ للهاوية.
⸻
خامسًا: فلسفة الجسد والأنوثة الكونية :
------------------------------------
“وللبنفسجِ في قلبي أميرتُه
منها إلى المُطْلَقِ القدسيِّ أنطلقُ”
* الأنوثة هنا ليست أنثى محددة، بل جوهر كوني خصب، يُعيد التوازن إلى الذات ويُعطي للوجود معناه.
* يتجسد في الأبيات المتأخرة من القصيدة نوع من الصوفية الإيروتيكية، حيث الجسد يرتقي ليصبح طريقاً إلى الروح.
“الشَّهْدُ والراح في أنفاسِها امتزجا
وذابَ من ثغرِها في ثغريَ العَبَقُ”
* بهذا، تنفصل المرأة عن جسدها الضيق، لتصبح جسرًا بين الأرض والمطلق، وهو ما يقاربه الشاعر كما يقاربه أفلاطون في “المأدبة”، حين يرى أن الحب هو الحنين إلى الكمال المفقود.
⸻
سادسًا: فلسفة الانكسار
وعي الذات بعد الانهيار
“عيناي ما بكتا يوماً بنازلةٍ
بل ادخرتُ دموعي حين نفترقُ”
* هذا البيت يكثف الوعي الفلسفي بالانكسار الجميل.
* إنّ تأجيل البكاء هو استثمار وجداني في لحظة لا تأتي إلا مرة واحدة: لحظة الانفصال.
* إنه وعي وجودي:
* فالمأساة الكبرى لا تكون في “الموت”،
* بل في “الفقد”،
* ولا يكون الخلاص في الهروب من الألم، بل في الاعتراف بوجوده.
⸻
خاتمة:
* قصيدة “يا ليل! يا عين!” ليست نصًا عاطفيًا أو وجدانيًا فقط،
* بل بيانٌ وجودي حادّ يتحدى ثقل الزيف، ويعرّي التواطؤ الديني، ويؤسّس لعشقٍ كونيّ لا يعرف الحدود.
* إنها قصيدة تحتضن التناقضات، تُصالح الذات مع سقوطها، وتجد المعنى في الحيرة، وتعلن – على طريقة الفلاسفة الشعراء –
* أن الخلاص لا يأتي من الخارج،
* بل من الذات وهي تحترق لتضيء.
الدكتور عبدالكريم الحلو
القصيدة :
يا ليل ! يا عين !
حامد خضير الشمري
جنبي وسكينُكَ الأعمى بخاصرتي
وكنتُ أنزفُ في صمتٍ وأحترقُ
" لا تشترِ العبدَ ! " كي تحظى بنُصرتِهِ
ظَنّاً بأنَّكَ نحو المجدِ تنطلقُ
ولا تبِعْ خيرَ ما أوتيتَ عن سَفَهٍ
لو السماواتُ فوق الأرضِ تنطبقُ
هم يشحذونَ بماءِ الوجهِ من زمنٍ
فكيف تسعى لهم طوعاً وترتزقُ
ورحتَ تنسجُ فوق الغيمِ أشرعةً
كأنما الملأُ الأعلى بك التحقوا
مُرٌّ مَذاقي إذا ما جئتَ تنهشُني
وكالرَّحيقِ تراني حين نتفقُ
ما كنتُ في غفلةٍ عما تخبئُهُ
فكِدْ وكيدُكَ قبل البَدْءِ ينمَحِقُ
إن كنتَ أهْلاً لها فالغابُ واسعةٌ
فاملأ سِلالَكَ وارتَعْ أيها الحَذِقُ
أضعتَ خطوَك في صحراءَ قاحلةٍ
حتى ضَلَلْتَ ومنِّي تبدأُ الطُّرُقُ
كذّبتُهُم وأنا أدري بأنَّهمُ
في كلِّ ما سطَّرتْ أقلامُهم صدقوا
يا عاذلي ومسوحُ الدِّين تثقلُهُ
صحراءُ قلبِكَ لا يجري بها الغَدَقُ
دعني فإنِّيَ لا أصغي لمَوعظةٍ
وخيرُ خِلَّينِ عندي الطَّيْشُ والنَّزَقُ
لي رُكعَتانِ بمحرابِ الهوى بهما
بابُ الخطيئةِ والآثامِ تنغلقُ
صارت بضاعةُ أهلِ الدِّينِ كاسدةً
لأنَّهم قبل كلِّ النَّاسِ قد فَسَقوا
كلُّ اللصوصِ أياديهم مُلوَّثةٌ
وسارقُُ الحرفِ يُخزي كلَّ من سرقوا
" يا ليل ! يا عين ! " والصَّهباءُ قد رقصتْ
وكاد نصفينِ مني القلبُ ينفلقُ
نام الندامى وكأسي بَعْدُ مترعةٌ
وكان يمرح في أجفانيَ الأرَقُ
أكادُ من فرْطِ خيباتي التي انهمرتْ
بكلِّ معجزةٍ في الكونِ لا أثِقُ
نزلتُ للجُبِّ طوْعاً حينما تركوا
عندي المتاعَ أمامَ الذئبِ واستبقوا
لعلَّ قافلةً تأتي وتنقذُني
من سجنِ أمّارَتي سوءاً فأنعتقُ
وللبنفسجِ في قلبي أميرتُه
منها إلى المُطْلَقِ القدسيِّ أنطلقُ
أميرة قدِّستْ سِرّاً وحضرتُها
فيها المذاهبُ والأديانُ والفِرَقُ


 إسترداد 6 مليارات دينار من شركات تتلاعب بسعر الصرف
إسترداد 6 مليارات دينار من شركات تتلاعب بسعر الصرف
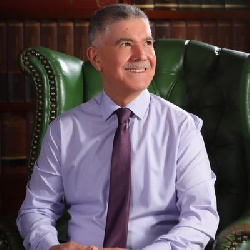 تحليل رقمي للانتخابات العراقية الأخيرة (1)
تحليل رقمي للانتخابات العراقية الأخيرة (1)
 التجارة: سياسة التصدير تسهم بتحقيق الإكتفاء الذاتي من الطحين
التجارة: سياسة التصدير تسهم بتحقيق الإكتفاء الذاتي من الطحين
 صحة ديالى تغلق معملاً للحلويات وتتلف مواد غير صالحة للإستهلاك
صحة ديالى تغلق معملاً للحلويات وتتلف مواد غير صالحة للإستهلاك
 العلمين يمد جسور التواصل والتعاون العلمي مع تركيا فرنسا
العلمين يمد جسور التواصل والتعاون العلمي مع تركيا فرنسا
 صورة الرئيس المعتقة.. من يعزف البيانو لجياع الصومال
صورة الرئيس المعتقة.. من يعزف البيانو لجياع الصومال
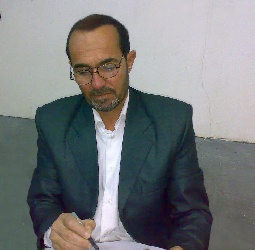 طبعة الزمان (الثانية) والمسؤوليات المضاعفة
طبعة الزمان (الثانية) والمسؤوليات المضاعفة
 حلمُ القيادة في مخيّلة السياسيين
حلمُ القيادة في مخيّلة السياسيين
