

طارق الدليمي .. الصديق اللّدود (1)
كلّمــا تختلف معه تزداد محبّة لــه
عبد الحسين شعبان
I
الصديق اللدود” ، عبارة كنت أذيّل بها رسائلي له حين تتباعد بنا السبل والمدن والقارات، وعندما كنت أزوره في منطقة الجسر الأبيض ” بداية حي العفيف” في طريق المهاجرين بدمشق، ولا أجده أترك له ورقة أكتب عليها ” صديقك اللّدود” ، وهي الإشارة التي كانت بيننا، أو كلمة السرّ التي تجمعنا، في حين كان هو يردّد “صديق الخلاف” وهو ما كتبه إلى لجنة حفل التكريم الذي أقيم لي بمناسبة منحي “وسام أبرز مناضل لحقوق الإنسان في العالم العربي” (القاهرة ، 20 آذار/مارس 2003).
يقول طارق الدليمي” … وفقط من هذا المنظور الملموس، بدأت رحلة علاقتنا الإنسانية التي أخذت صفة (أصدقاء الخلاف).
ومرّت هذه الأواصر بأجواء مفعمة بالتباين ومكتظّة بأنواع السجالات التي لا ترحم بالمعنى السياسي المجرّد، والذي يحتفظ علناً بقدراته على الإغناء والعطاء”.
ويضيف: “… وكان شعبان لديه الطاقة الخاصة على المبادرة ضمن عقله الأكاديمي الجديد المنصهر في بوتقة الحياة الثريّة والمندغم مع المنظومة الفكرية التي رعاها مبكّراً وبشجاعة تثير الإعجاب. (من كتاب عبد الحسين شعبان – صورة قلمية : الحق والحرف والإنسان، إصدار البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، القاهرة، 2004).
تواصل وجداني
لم أجد أمتع وأجمل من الحوار مع طارق الدليمي، وبقيت أفتقد ذلك حين تحرمنا الظروف من التواصل المباشر، على الرغم من التواصل الوجداني وعبر الانفعال الإنساني لكل ما نكتب أو نقرأ، فالجلسة معه لها نكهة خاصة وطقوس أكثر خصوصية وفضاء شديد الرحابة، فكل شيء لدى الدليمي ينبض بالحيوية والسؤال، خصوصاً حين تكون معه بضيافة على كأس عرق أو قدح نبيذ، حيث كان يتفنّن أبو زياد في صنع المازات اللذيذة شرقيها وغربيّها، وعنده تعرّفت على الأرضي شوكي ” الأنغنار” أو “الخرشوف”، و”الزيتون المكلّس” الذي لم أعرفه من قبل.
كانت شقته الصغيرة الجميلة مفتوحة لاستقبال الأحبّة في كل الفصول: في الشتاء والخريف حيث تجد الدفء يملأ المكان، وفي الصيف والربيع وبدايات الخريف أيضاً كان سطح شقته العامر هو المكان المناسب لأماسي الدليمي بنسماتها العذبة ، حيث يلتقي أدباء ومفكرون ومثقفون وسياسيون من شتى الألوان والأجناس: رجال ونساءً، عراقيون وسوريون وعرب، خليجيون ومن شمال أفريقيا في “منتدى ثقافي فكري جامع ومنبر مفتوح ومتنوّع تتعدّد فيه الرؤى والاختيارات”، وبقدر ما كانت همومه عراقية متميّزة كانت تطلعاته العربية مزدحمة باستمرار ، حتى أن السطح يزهو أحياناً بمتناظرين ، مختلفين ومتّفـقين، والمهم أن يكون الحوار جاداً ومســــؤولاً، حتى وإن اتّسم بالحدّة العراقية المألوفة.
II
شلّة طارق الدليمي التي كانت مستمرّة ومكانها محفوظاً، حتى وإن غابت أسابيع أو أشهراً تتكوّن من : مظفر النواب وقيس السامرائي وهادي العلوي وكاظم السماوي وجمعة الحلفي وسعدي يوسف وعدنان المفتي ومحمد عبد الطائي وعبد الحسين شعبان وآخرين.
ويتردّد عليها كثيرون منهم: جواد الأسدي ومنذر حلمي وماجد عبد الرضا وعبد اللّطيف الراوي وفوزي الراوي وعلي كريم وعادل مراد ومحمود عثمان ومحمود شمسه وهاشم شفيق ومحمد الحبوبي ومخلص خليل وشاكر السماوي وعزيز السماوي ورياض النعماني وعوني القلمجي وعامر بدر حسون ووائل الهلالي (حكمت) وشفيق الياسري (هاشم) وناهدة الرماح وزينب ولطيف صالح وشوقية وحميد البصري ووليد جمعة وجليل حيدر وعبد الكريم كاصد وأحمد المهنا وعبد المنعم الأعسم وسامي كمال وكمال السيد وكوكب حمزة وعلي عبد العال وأبو أيوب وساهرة القرغولي وقيس الزبيدي وفاضل الربيعي ورشاد الشيخ راضي وصاحب الحكيم ومحمد جواد فارس ورحيمة السلطاني وعبد الرزاق العاني وعلي الصرّاف ونبيل الحيدري، وقسم غفير من هؤلاء أعضاء في ” رابطة الكتاب والصحفيين والفنانين الديمقراطيين العراقيين” التي تأسست بعد هجرة اليساريين والشيوعيين أواخر العام 1979 وغيرهم، ومن كان قادماً من كردستان أو ذاهباً إليها يجد في شقّة طارق الدليمي الصغيرة الدافئة الأنيسة الأليفة ملاذاً في إحدى الأماسي.
وكان طارق الدليمي يستمع إلى القادمين ويحاورهم لمعرفة المزيد عن الأوضاع والساحات، لتبدأ جلسة حوار مفتوحة في موضوعات شتّى ونستمع أحياناً إلى قراءات شعرية أو عرض لمشهد مسرحي أو اقتراح لمشروع ثقافي، أو رؤية سياسية جديدة أو فكرة عن تحالف أو اتحاد أو انشقاق أو تكتّل… كل ذلك كان يجري بحميمية وإخلاص، حتى وإن كان الطريق الذي يتم اختياره والتوقيت والزمان خاطئاً، لكن منزل طارق الدليمي يجعل الكثيرين يبوحون بما يحتفظون به من أسرار، أو هكذا يتصوّرون حين يحاولون إخفاءها،وبعد حوارات ونقاشات بعضها أقرب إلى الاستنطاقات يبدأون بالحديث والبوح حتى وإن ترددّوا في بداية الأمر ، بفعل الأجواء الثقافية والفكرية الجادة والحميمية، فالأسرار للتنظيم فقط، لاسيّما ما هو ضروري، أما في الفكر والسياسة فكل شيء ينبغي أن يكون علانية وواضـــــــحاً ومفهوماً، بل وينبغي أن يكون منطقياً ومقنعاً وليس ثمة أسرار في ذلك .
كان بعض متشدّدي الأحزاب المعارِضة الموجودة في دمشق يرون تلك الجلسات خطراً عليهم ويحذّرون “أتباعهم” من الاقتراب منها، خصوصاً إذا ما تعرّضت لبيروقراطيتهم وكشفت بعض المخبوء أو المستور الذي لم يُسلّط عليه الضوء الكافي، ولاسيّما إذا كان جوهرياً وخارج دائرة الاصطفافات المُسبقة، ووصلت أخبار هذا المنتدى الثقافي – الفكري إلى أوساط غير قليلة، حتى ممن تم تحذيره فيزداد فضوله، فيغامر ويخادع ليجد فرصة لدعوته أو يلصق نفسه بأحد المدعوين في خميس أحد الأسابيع، فعلى الأقل يحظى بسهرة أو أمسية واحدة ليكتشف ذلك السر الدفين في محبّة أصدقاء كثر لطارق الدليمي، حتى وإن اختلفوا أو تخاصموا معه، لكن الرغبة في التواصل تبقى قائمة لديهم وتلمّست ذلك مع العديد منهم.
وعلى المستوى الشخصي لم يحصل أن حدث بيننا خصام طول نحو ستة عقود من الزمان عرفته فيها، حتى حين كانت تتأزم المواقف سياسياً وتتباعد التوجّهات، فأتجنب زيارته لأسبوعين أو أكثر، لكنه كان يتصل ويتواصل لنتناسى ما يحصل أحياناً من حدّة الخلاف، وفي أكثر الأحيان كنت أنا المبادر فيفتح طارق الدليمي صدره وقلبه وعقله وضميره وبيته ليستقبلني بالأحضان.
III
حين تعرّفنا على بعضنا كان الاختلاف هو الجامع، وتلك فرادة في الصداقة ذاتها، وكان اللقاء على منصّة الجدل ساخناً والسجال شديداً، حيث كان طارق الدليمي قد بدأ حياته في حزب البعث أواخر الخمسينات، وهو من الشخصيات العروبية الشديدة الاعتزاز بآرومته، إضافة إلى ثقافته الموسوعية وعقله الناقد، وأستطيع القول إنه مثقف رؤيوي بامتياز وصاحب مواقف متميّزة حتى وإن كانت خاطئة، وكان شجاعاً وغير هيّاب، جريئاً لا يخشى في الحق لومة لائم.
وبقدر ما كان مؤمناً بالأمة العربية ورسالتها الحضارية وبالهويّة الثقافية للقومية العربية في كل تحولاته وتقلّباته الفكرية، فقد كان في الوقت نفسه شديد الإيمان بالبعد الاجتماعي لقضية التغيير، لاسيّما وإن قضية الحرّية والعدالة جوهرا النهضة هما مسألتان كونيتان وأمميّتان، ولذلك ظلّ مع كوكبة لامعة من البعثيين يبحثون عن طريق آخر، ربما طريق ثالث، فالتغيير بالنسبة لهم وعلى حد تعبير المفكر ياسين الحافظ: “حفرٌ في العمق وليس نقراً في السطح”، لكن ذلك لم يشفِ غليله، فقد كان قلقه المعرفي وثقافته المتنوّعة وقراءاته الفلسفية مائزة ورائزة على أقرانه، بما فيها لغته الإنكليزية التي كان يقرأ بها، وكان يعتقد إن الجانب الاجتماعي لا بدّ أن يُضاف ويُستكمل ويتعمّق إلى الفكر العروبي.
وهكذا تململت تلك الثلّة المتميّزة من الشباب البعثي، فاختارت الطريق الوسط بين الحركة الشيوعية والحركة القومية بتأسيس “حركة الكادحين العرب” ومن أبرز رموزها قيس السامرائي وطارق الدليمي وغزايّ درع الطائي ومزهر المرسومي وهناء الشيباني (التي استشهدت بعد التحاقها في المقاومة الفلسطينية / أواخر العام 1969) وعبد الإله النعيمي وصادق الكبيسي وغيرهم، ثم اتخذ هؤلاء خطوة أخرى بالاتجاه نحو اليسار فأطلقوا على حركتهم اسم “المنظمة العمالية” التي دخلت انتخابات الطلبة ضمن قائمة اتحاد الطلبة في ربيع العام 1967 وفاز بعضهم ضمن تشكيلات الاتحاد، وقد انضم هؤلاء إلى “حزب القيادة المركزية” بعد انشقاقه عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في 17 أيلول (سبتمبر) 1967 خصوصاً وإن الاتجاه “اليساري” الذي اختطته القيادة المركزية، إضافة إلى التوجّه الجيفاري الذي عبّرت عنه باختيارها الكفاح المسلح، داعب مخيلتهم حتى قبل تأسيسها، الأمر الذي وجدوا مكانهم الطبيعي فيها مع بعض الاختلافات بشأن العروبة وجوهرها التقدمي، والتمييز بينها وبين الاتجاهات القومية المتعصّبة .
وكان طارق الدليمي قد سبقهم إلى ذلك، حين كان بصلة خاصة داخل التنظيم الحزبي منذ العام 1964 ومع حسين جواد الكمر تحديداً ، على الرغم من اعتراضاته على خط آب (أغسطس) العام 1964 الذي عُرف بالخط اليميني- الذيلي- التصفوي، كما اصطلح عليه ورفضته غالبية القواعد الحزبية، ويوم حدث الانشقاق كان طارق الدليمي في المواقع الأولى الذي دعمته، وكان قد أحيط علماً بتوجّهات لجنة منطقة بغداد التي كان على صلة بها وبالعديد من أعضائها، وقد عمل مع القيادة المركزية بخط خاص، وكانت له آراؤه الخاصة، ويومها كان طارق الدليمي طالباً في الصف الخامس في الكلية الطبية، وقبل أن ينتقل إلى الصف السادس، تم اعتقاله وبعد خروجه من المعتقل التحق بحركة الكفاح المسلح، ثم بدأت رحلته في الغربة التي منعته من إكمال السنة المتبقية له، سواء في دمشق أم عدن أم القاهرة، وشخصياً كنت وما أزال أعتبره أمهر طبيب، على الرغم من أنه لم يحصل على الشهادة النهائية، وكنتُ أثق بتشخيصاته وألتزم بنصائحه الطبية.
وعلى الرغم من مضي أكثر من 5عقود على تركه مقعد الدراسة ، لكنه ما يزال يقرأ وبنهم الكثير من المصادر والمجلات الطبية ، مثلما يقرأ القضايا الفكرية والأعــــمال الأدبية بطريقة منـــهجية تثير الإعجاب.
IV
حين كان طارق الدليمي بعثياً كنت شيوعياً، ويوم التحق بالقيادة المركزية، كنت على ملاك اللجنة المركزية، وكانت السجالات مستمرة بيننا بصورة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى كوكبة من الوجوه والشخصيات الطلابية والثقافية والمنشغلة بقضايا الأدب في مقاهي بغداد وحاناتها وكلّياتها وأروقتها الجامعية، ونتنقل أحيانا وفي اليوم الواحد لعدّة مقاهٍ: من البلدية إلى عارف آغا، ثم إلى البرلمان والشابندر والبرازيلية والمربعة ، وفي المساء نمرّ على مقهى ليالي السمر ومقهى المعقّدين، ثم نفترق لنتوزّع على الحانات التي نختارها: آسيا، بلقيس، كاردينيا، الجندي المجهول، الشاطئ الجميل، رومانس، فندق سميراميس، وأحياناً سرجون وحسب ثلّة الأصدقاء، وكان ذلك يحدث مرّة على الأقل كل عشرة أيام أو أسبوعين، ولكن النقاش يستمر هو ذاته ،وأتذكّر في إحدى المرّات والقصة بطلها سلام مسافر، احتدم النقاش بشأن أحقية القيادة المركزية أم اللجنة المركزية وأيهما أفضل عزيز الحـــاج أم عزيز محمد؟
ولا أدري كيف انتبه سلام مسافر إلى أن المتحاورين حملوا اسم عزيز، وهم كل من: عزيز حسون عذاب وعزيز السماوي وعزيز خيّون وعزيز السيد جاسم، فما كان منه الا أن يقول: قفوا عن أي عزيز تتحدّثون : فكل عزيز (كذا)، وضحكنا جميعاً وكأن قالباً من الثلج وزّع على المتحاورين أو المتلقّين في يوم قائظ وشديد الحرارة، وهي النكتة التي بقينا نردّدها ونقولها تورية أحياناً ” كل عزيز – كذا” واستعدتها مؤخراً مع سلام مسافر خلال زيارتي لموسكو، وكانت دعابة مثل تلك كافية لتحسم النقاش ودّياً، بدلاً من الاختصام .
V
في الذكرى الأولى لعدوان 5 حزيران (يونيو) 1967 قرّرت الأحزاب والقوى السياسية والنقابات الخروج بتظاهرات بالمناسبة ، ولم يتم الاتفاق بيننا وبين القيادة المركزية، فذهبت أنا إلى تظاهرة اللجنة المركزية بالاتفاق مع البعث اليساري (الجناح السوري) وذهب طارق الدليمي إلى تظاهرة القيادة المركزية ، وقد انطلقت بعد تظاهرتنا بساعة أو أكثر، وسارت متساوقة مع تظاهرة للحركة الاشتراكية العربية واتحاد نقابات العمال (هاشم علي محسن)، وحين انتهت تظاهرتنا في الباب الشرقي (ساحة التحرير) وكانت قد انطلقت من ساحة الأمين بدأت تظاهرة القيادة المركزية من ساحة الميدان، وعدت لأشاهد تظاهرة القيادة المركزية وشعاراتها لكي أرى حجم المتظاهرين وهتافاتهم التي كانت تردّد: “باسم القيادة ننادي يسقط الحكم العسكري” و”يا فاشي شيل إيدك كل الشعب ميرديك”.
وكنت قد ركبت الباص المتوجّه من الباب الشرقي عبر شارع الرشيد لأصل بالقرب من الشورجة، حيث كانت التظاهرة قد تجاوزت سوق الصفافير، وحين نزلت من الباص وجدت طارق الدليمي يسير بالقرب من نرجس الصفار في التظاهرة وسلّمت عليهما وكان معي ثلاثة أصدقاء قدموا من النجف والتقيت بهم بالصدفة في الباص، وجاءوا في زيارة خاصة إلى بغداد، وحين عرفوا وجهتي انضموا إليّ، خصوصاً وكان اثنان منهما يعتبران على ملاك الحركة الشيوعية وهما السيد علي الخرسان والسيد باسم كمونة، وهما ينتسبان إلى عائلتين دينيتين مثل عائلتي، والعوائل الثلاث لها حق الخدمة في حضرة الإمام علي منذ قرون بفرامين سلطانية من الدولة العثمانية.
وحين دوهمت تظاهرة القيادة المركزية وتفرّقنا ذات اليمين وذات الشمال، ولحظتها كنتُ أسير برفقة طارق الدليمي، لكننا قطعنا حديثنا إثر ظهور بوادر هجوم على التظاهرة، فقفز الدليمي إلى جهة اليمين وقفزت أنا نحو الشمال، وحسبما ما يبدو كان مرصوداً وربّما هناك من شاهده يودع مسدسه عند نرجس الصفار، فتجمّع حوله نحو خمسة رجال أمن وحاولوا سحبه إلى السيارة المتوقفة قرب مقهى البرازيلية، لكنه حاول مقاومتهم رافضاً ذلك، فانهالوا عليه ضرباً وأدموه، حتى سقط أرضاً فحملوه بقوة وهو يرفس مقاوماً الصعود إلى السيارة.
وقد أطلقتُ العنان لساقيّ كي تسابق الريح بالاتجاه الآخر، بعد أن خاطبني الصديق عبدالرزاق سلمان (السعدي) بقوله: اركض لكي لا يلقى القبض علينا، وبدوري نبّهت الخرسان وكمونة، بذات العبارة التي كلّمني بها السعدي، ودخلنا في الأزقة المتفرّعة حتى وصلت إلى شارع الجمهورية، وانتقلت إلى الرصيف الآخر، وبقيت أراقب خروج الصديقين الخرسان وكمونة، ولكنهما لم يخرجا وقلت مع نفسي لعلّهما استمرّا في نقاشهما أو تعبا من الركض ففضّلا المسير ببطء ، وسيتصلان بي في مساء اليوم ذاته أو في اليوم التالي، لكنهما لم يتّصلا وقلت مع نفسي ربما لم يسمح لهما الوقت للاتصال فعادا إلى النجف .
وحين زرت النجف بعد أكثر من شهرين لانجاز معاملة نقل النفوس التي ظلّت معلّقة، علمت من الصديق الثالث (محسن الشرع) أنهم دوهموا من شخص يحمل رشاشة وضعها في صدورهم، وكان اثنان آخران يحملان مسدساً حيث تم تفتيشهم، وقد أخلي سبيله بعد أن أعطاهم هويته وكان حينها معلّماً، أما هما فقد اقتيدا إلى جهة مجهولة، وفي المساء جيء بهما إلى فندق قصر النيل حيث كانا قد استأجراً غرفتين وتم تفتيش حقائبهما، ثم نقلا إلى سجن الفضيلية، وهناك إلتقيا بطارق الدليمي وتعرّفا عليه وعرفا منه أنه صديقي وعرّفاه بنفسيهما باعتبارهما من أصدقائي، ومن المفارقة أنهما حين اعتقلا احتسب أحدهما على ملاك القيادة المركزية والآخر على ملاك اللجنة المركزية، حتى أنهما افترقا في المعتقل، وتلك واحدة من أجواء الصراعات غير العقلانية التي عشناها.
ترك المعاملة
وحين عرفت بمعلومة اعتقالهما وبأن النجف عرفت القصة التي شاعت فيها وكيف التقيتهما في الباص واصطحبتهما معي إلى التظّاهرة، قرّرت العودة أدراجي وتركت المعاملة التي ظلّت معلّقة حتى عودتي من الدراسة في نهاية العام 1977 والتي لم تنجز إلّا في مطلع العام 1978 حيث كان والدي قد أضاع أولوياتها، ولم يطلق سراح طارق الدليمي بعد 17 تموز (يوليو) 1968 مباشرة حتى حين تم إطلاق سراح المعتقلين والسجناء ، وقد تأخّر بضعة أسابيع قياساً لأقرانه، وحين صدر الأمر بإطلاق سراحه وجاء شقيقه خالد لكفالته، وتم ترتيب الإجراءات القانونية، نقل إلى مديرية الأمن العام ، وبعد أن تكفّله شقيقه، أسرعا الخطى لمغادرة المبنى وفي الممر العريض فوجئا بأحد مسؤولي الأمن ينادي من خلفهما بصوت عال: طارق.. طارق ، وحاول أن يتجاهله بحجة أنه لم يسمع صوته، لكن هذا الأخير صرخ بأعلى صوته : أبو زياد.. أبو زياد ، فاضطرّ الدليمي التوقّف ملتفتاً إلى الخلف، حتى فاجأه ضابط الأمن بالقول: لدينا 6 طوابق تحت الأرض أتعلم ذلك؟ فلا تعد إلينا وإلّا سيكون مصيرك أسود، وردّد على مسامعه: أقولها لك محذّراً أتفهم ذلك “ستة طوابق” وهو ما كنّا نتندّر به وغالباً ما كان يغمز طارق بعينيه وبإشارة من يده ” ستة طوابق” .
حاول طارق الدليمي العودة إلى الكلية، وكنتُ قد تخرجت حينها، لكن أسر “الجملة الثورية” من جهة والخشية من الاعتقال مجدّداً من جهة أخرى، لاسيّما وأنه كان معروفاً وناشطاً ، هما وراء تغيير مسار حياته، علماً بأن القيادة المركزية استمرت في رفع شعار إسقاط السلطة مندّدة بالانقلاب المشبوه، وهو ما دفعه للتفتيش على مكان آمن لممارسة عمله فاختار منطقة الأهوار، وحاول التوجه إلى الريف تحضيراً لبدء عملية كفاح مسلح من تلك البؤر الثورية، وبقي هناك لبضعة أسابيع حتى وصلته التعليمات بضرورة السفر إلى الخارج، فتوجّه إلى دمـــــــشق، التي ظلّت قاعدته الأساسية مهما تغيّرت الاختيارات من الــــــــقاهرة إلى عدن ثم إلى صوفيا، لكن الشـــــــام هي التي حظيت بعشق طارق الدليمي فاختـــــــارها إقامة “عشاً” له ، مثلما اختار “قدس” اسماً لابنته.


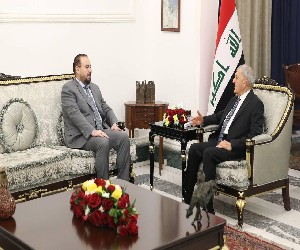 مرسوم بتعيين كامل كريم الدليمي رئيساً لديوان الرئاسة
مرسوم بتعيين كامل كريم الدليمي رئيساً لديوان الرئاسة
 الدليمي يتوّج ببطولة حاجز الدولية في السعودية
الدليمي يتوّج ببطولة حاجز الدولية في السعودية
 فنانون يستذّكرون طارق الربيعي في ذكرى رحيله الثانية
فنانون يستذّكرون طارق الربيعي في ذكرى رحيله الثانية
 إصدار جديد لطارق حربي.. قراءة في كتاب الطريق إلى الناصرية
إصدار جديد لطارق حربي.. قراءة في كتاب الطريق إلى الناصرية
 وثيقة تكشف سلسلة من الإجراءات.. الكاظمي يوبّخ الدليمي على خلفية تسريب الأسئلة
وثيقة تكشف سلسلة من الإجراءات.. الكاظمي يوبّخ الدليمي على خلفية تسريب الأسئلة
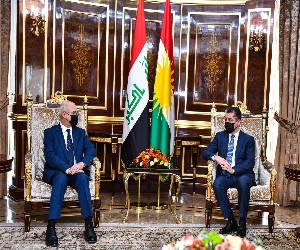 الدليمي يناقش في أربيل التعاون التربوي
الدليمي يناقش في أربيل التعاون التربوي
 سياسة المحتكر وسيادة الصديق
سياسة المحتكر وسيادة الصديق
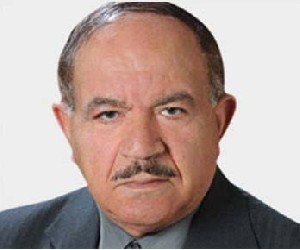 فؤاد الشمس.. الصديق الجميل والزميل النبيل
فؤاد الشمس.. الصديق الجميل والزميل النبيل
