
العتبات بين الأصل والترجمة : تلقي المصطلح وتحولاته الدلالية
عادل الثامري
يُعدّ كتاب ( العتبات) (1987) Seuilsلجيرار جينيت من أهم المساهمات في حقل السرديات والسيميائيات النصية، إذ أسّس لمفهوم العتبات الذي يحيط بالنص الأدبي ويوجّه عملية تلقيه. غير أنّ انتقال المصطلح من الفرنسية إلى الإنكليزية لم يكن انتقالًا حرفيًا محايدًا، بل أحدث تحوّلاً دلاليًا ومعرفيًا ملحوظًا، انعكس على فهم النظرية وتوظيفها في حقول البحث المختلفة عبر الثقافات. حين تُرجم الكتاب إلى الإنكليزية عام 1997 على يد ريتشارد ماكسي من جامعة جونز هوبكنز، لم يُترجم العنوان إلى Thresholds وهي الترجمة الحرفية المباشرة لـ Seuils بل إلى Paratexts ، مع الإبقاء على كلمة Thresholds في العنوان الفرعي: Thresholds of Interpretation (عتبات التأويل). هذا التحول الاصطلاحي ليس مجرد اختيار ترجمي عملي، وانما يعكس توجهًا نظريًا ومنهجيًا مختلفًا في تصور العلاقة بين النص ومحيطه، وبين القارئ والعمل الأدبي. من هنا تنبع أهمية الوقوف عند الفوارق الدلالية والمفاهيمية بين المصطلحين، وتتبع أثر هذا التحول في استقبال النظرية عبر السياقات الثقافية المختلفة. الإشكالية الحقيقية هي: لماذا استُبدل العنوان الاستعاري "Seuils" بالمصطلح التقني "Paratexts"؟ فالقضية ليست أن الإنكليزية "اخترعت" مصطلحًا جديدًا، بل أنها رفعت المصطلح التقني الداخلي (Paratexte) إلى مستوى العنوان وخفّضت الاستعارة الشعرية (Seuils) إلى مستوى العنوان الفرعي التوضيحي وهذا انقلاب في التراتبية بين الشعري/الاستعاري والتقني/المفهومي.
الاستعارة المكانية وفلسفة العبور
في الأصل الفرنسي، اختار جينيت عنوان Seuils وهي جمع كلمة seuil التي تعني "عتبة" بالمعنى المعماري المباشر: عتبة البيت أو المدخل أو الباب. هذا الاختيار لم يكن اعتباطيًا أو مجرد استعارة جمالية، بل أراد به جينيت أن يستثمر البعد الفلسفي والظاهراتي للمكان الحدّي الذي يقف عنده الداخل قبل العبور إلى فضاء آخر. ان العتبة، في التصور المعماري والأنثروبولوجي، ليست مجرد خط فاصل بين داخل وخارج، بل هي فضاء وسيط يحمل دلالات رمزية وطقوسية عميقة:
1. فضاء الانتقال والتحول: العتبة هي المكان الذي يتم فيه الانتقال من حالة إلى أخرى، من الخارج إلى الداخل، من العام إلى الخاص، من المألوف إلى المجهول.
2. منطقة التردد والتأمل: عند العتبة، يتوقف الداخل، يتردد، يستعد نفسيًا ومعرفيًا لما سيأتي. إنها لحظة ترقب وتهيؤ.
3. الحد الذي يحمل خصائص الطرفين: العتبة ليست داخلًا تامًا ولا خارجًا كاملًا، بل تحمل من كليهما، مما يمنحها طبيعة هجينة ومزدوجة.
4. البعد الطقوسي: في مخيال الثقافات المختلفة، تتحول العتبة من مجرد حجر عادي إلى فضاء رمزي يفصل بين عالمين: الداخلي المقدس والخارجي الدنيوي.
وهكذا، أصبحت العتبة في النص الأدبي تشير إلى كل ما يُشكّل فضاءً وسيطًا بين النص المركزي والقارئ: من العنوان، والعنوان الفرعي، والإهداء، والتصدير، والمقدمة، والتمهيد، إلى الغلاف، والحواشي، والتعليقات، واسم المؤلف، ودار النشر. كل هذه العناصر تُشكّل عتبات يعبرها القارئ قبل الدخول إلى النص الأساسي، وتؤثر في طريقة قراءته وتأويله.
الطابع الأساسي لهذا التصور هو الطابع المكاني-الاستعاري الحركي، أي أنّ العتبات تمثل مناطق عبور وانتقال وتفاعل، وليست مجرد عناصر نصية ثانوية أو ملحقة بالنص. إنها تحمل وظيفة تواصلية أساسية في توجيه التلقي.
التقنين والتجريد المفهومي
يرتكز الاختيار الترجمي الى الانكليزية على عدة اعتبارات:
1. الاتساق مع المصطلح المفهومي الداخلي: جينيت نفسه استخدم داخل الكتاب مصطلح paratexte كمفهوم نظري محدد، فرأى المترجم أن يجعله العنوان الرئيسي لتحقيق الاتساق الاصطلاحي.
2. التوافق مع التقاليد الأكاديمية الأنجلوسكسونية: في السياق الأكاديمي الإنكليزي والأمريكي، هناك تفضيل للمصطلحات التقنية الدقيقة على الاستعارات الأدبية، خاصة في الدراسات النظرية.
3. تجنب الغموض الدلالي: كلمة Thresholds بمفردها قد تبدو غامضة أو شعرية للقارئ بالإنكليزية، بينما Paratexts تحدد المجال الدراسي بوضوح.
اما بشأن الخصائص الدلالية ، فان كلمة Paratext مشتقة من البادئة اليونانية/اللاتينية para- (بجوار، إلى جانب، موازٍ) وtext (نص)، ما يجعل دلالتها تقنية وتجريدية وعلائقية أكثر من كونها استعارة مكانية حسية:
1. التركيز على العلاقة المكانية الثابتة: "ما هو بجوار النص" بدلاً من "ما يُعبر إليه".
2. التصنيف والفهرسة: المصطلح يدعو إلى رؤية العتبات كـفئة أو مجموعة من العناصر النصية القابلة للتصنيف والدراسة المنهجية.
3. التجريد النظري: يبدو Paratext مصطلحا نقديا تخصصيا، يُستخدم في الخطاب الأكاديمي البحت، بعيدًا عن الحمولة الشعرية أو الفلسفية.
4. التركيز على الجهاز النصي: لم يعد التركيز على فعل العبور أو تجربة الانتقال، بل على الجهاز النصي الذي يحيط بالكتاب ويشارك في تشكيل معناه وتلقيه.
يمكن تلخيص الفوارق بين المصطلحين في الجدول المقارن الآتي:
|
الترجمة الإنكليزية (Paratexts) |
الأصل الفرنسي (Seuils) |
المعيار |
|
من البادئة اليونانية para- بجوار + نص |
من الفرنسية القديمة، يعود إلى اللاتينية solum )أرضية، قاعدة( |
الأصل اللغوي |
|
مصطلح نصي-نظري تجريدي |
استعارة مكانية معمارية حسية |
الطبيعة الدلالية |
|
يركّز على مجموعة العناصر المواكبة للنص |
يركّز على فضاء العبور والانتقال بين النص والقارئ |
البعد الأساسي |
|
ثابت، تصنيفي، بنيوي |
حركي، تجريبي، ظاهراتي |
طابع المفهوم |
|
يمنح المفهوم طابعًا تقنيًا ووظيفيًا |
يحافظ على الطابع المجازي والحسي والفلسفي |
الحمولة الرمزية |
|
القارئ يواجه عناصر نصية محددة |
القارئ يعبر العتبات في رحلة تأويلية |
علاقة القارئ بالنص |
|
يوحي بالثبات والوضع المكاني الراهن |
يوحي بالحركة والزمن (اللحظة قبل الدخول) |
البعد الزماني |
|
يُسهّل الدراسة المنهجية والتطبيق التحليلي |
يبقي المفهوم مفتوحًا على التأويلي |
الاستخدام الأكاديمي |
تلقي النظرية عبر السياقات الثقافية
هذا التحول في التسمية والمفهوم لم يمر دون تأثير معرفي وأكاديمي، إذ أسفر عن فروق واضحة في كيفية استقبال النظرية وتوظيفها عمليًا. فقد ظلّت الاستعارة المكانية، في السياق الفرانكفوني، حاضرة بقوة في الدراسات الفرنكوفونية، مما أبقى النقاش مفتوحًا فيما يخص:
- البعد الحدّي والوسيط للعتبات بوصفها فضاءات انتقالية غنية بالدلالات.
- الأبعاد الأنثروبولوجية والفلسفيةللعتبة بوصفها مفهوما ثقافيا وإنسانيا عاما.
- العلاقة الدينامية بين النص ومحيطه بوصفها علاقة تفاعلية حية.
- التأويل الظاهراتي لتجربة القراءة بوصفهاعملية عبور وانتقال معرفي.
واستمر الباحثون الفرنسيون والفرانكفونيون في استكشاف الإمكانات الاستعارية للمفهوم، واستخدموه في دراسات متنوعة تتجاوز النقد الأدبي إلى حقول السيميائيات الثقافية ودراسات الصورة والإعلام.
أما في السياق الأنكلوسكسوني، فقد أصبح التركيز في الدراسات الإنكليزية والأمريكية منصبًا على:
- الجانب التقني والوظيفي للنصوص المحيطة بوصفها عناصر قابلة للفهرسة والتصنيف.
- التطبيقات المنهجية والتحليلات البنيوية لمختلف أنواع النصوص الموازية(المناص).
- الدراسات التجريبية والإحصائية عن تأثير عناصر محددة (كالعناوين والأغلفة) على التلقي والمبيعات.
- توسيع المفهوم ليشمل الوسائط الجديدة مثل النصوص الرقمية والمواقع الإلكترونية.
وسهّل المصطلح الإنكليزي Paratexts دمج المفهوم في منهجيات نقدية مختلفة، مثل الدراسات الثقافية، ونظرية التلقي، ونقد استجابة القارئ، ودراسات النشر. لكنه، في الوقت نفسه، قلّص من البعد الشعري والفلسفي للمفهوم الأصلي.
الخيارات الترجمية في السياق العربي
ولهذه الاسباب المفهومية والدلالية، نجد أن العديد من المترجمين والباحثين العرب اختلفوا في نقل المصطلح:
1. "العتبات": الترجمة الأكثر شيوعًا، تحافظ على روح الاستعارة الأصلية وقوتها التخييلية. استخدمها باحثون مثل عبد الحق بلعابد وسعيد يقطين.
2. "النص الموازي" أو "النصوص الموازية": ترجمة أكثر حرفية لـ Paratexte وتركز على البعد التقني. استخدمها بعض الباحثين المتأثرين بالمدرسة الأنجلوسكسونية.
3. "المناص": ترجمة اقترحت كمقابل عربي يحافظ على البنية الاصطلاحية
4. "عتبات النص": ترجمة توفيقية تجمع بين الاستعارة المكانية والتحديد الوظيفي.
في مسعى تعريب المصطلح النقدي الفرنسي "Paratexte"، شكّل نحت مصطلح "المناص" خطوة في الهندسة اللغوية العربية. يعود الفضل في صياغة هذا المصطلح إلى الباحث عبد الحق بلعابد في كتابه "عتبات - جيرار جينيت من النص إلى المناص" (2008)، حيث مثّل محاولة جريئة لتقديم مصطلح عربي مكثف بديلاً عن الترجمة الحرفية "النص الموازي".
تقوم البنية الاشتقاقية للمصطلح على عملية نحت تجمع بين البادئة والدلالة. فالمقطع "Para" في الأصل الفرنسي يحمل دلالات المصاحبة والموازاة، ما يعادل في العربية "م" أو "ما" الدالة على المصاحبة كما في كلمات مثل "معاصر" و"موازي". أما الجذر "نص" فيمثل المتن الأساسي. ينتج عن هذا الدمج مصطلح "المناص" الذي يسير على الوزن الصرفي "مَفْعَل" المشابه لكلمات مثل "مَدْخَل" و"مَخْرَج"، مما يضفي عليه الشرعية الصرفية في النظام اللغوي العربي.
يتميز مصطلح "المناص" بقدرته على تقديم مفهوم تقني مكثف، إذ يحول العبارة الوصفية "النص الموازي" إلى مصطلح واحد سهل الاستخدام في السياقات الأكاديمية والعناوين. كما يسمح بقابلية اشتقاق مصطلحات فرعية مثل "المناص المحيط" و"المناص الخارجي"، مما يخلق نظاماً مصطلحياً متكاملاً. ورغم هذه المزايا، يواجه المصطلح تحدي الغموض الاشتقاقي وعدم الوضوح الدلالي المباشر، مما يجعله بحاجة إلى شرح وتوضيح للقارئ غير المتخصص.
في المشهد المصطلحي العربي، يتعايش "المناص" مع ترجمات بديلة مثل "العتبات" و"النص الموازي" و"المحيط النصي"، ما يعكس تعددية طبيعية في مراحل استقبال المفاهيم النقدية الحديثة. لكنه يظل بحاجة إلى توحيد تدريبي لضمان الاتساق في الكتابات الأكاديمية العربية.
|
سياق الاستخدام |
المصطلح العربي |
المصطلح الفرنسي |
|
يُستخدم كاستعارة شعرية وعنوان لكتاب جينيت الأساسي، مع التركيز على البعد الاستعاري للعتبة كمنطقة انتقالية |
العتبات |
Seuils |
|
مصطلح تقني يشمل كل ما يحيط بالنص من عتبات ومقدمة وغلاف وهوامش وفهارس |
المناص |
Paratexte |
|
يشير إلى العناصر الموجودة داخل الكتاب نفسه (العناوين، الإهداء، المقدمة، الهوامش) |
المناص المحيط أو المناص الداخلي |
Péritexte |
|
يغطي العناصر خارج النص الرئيسي (مقابلات المؤلف، المراجعات النقدية، الرسائل، التصريحات الإعلامية) |
المناص الفوقي أو المناص الخارجي |
Épitexte |
لقد أثار انتقال مصطلح Seuils (عتبات) إلى التداول النقدي العربي إشكالًا دلاليًا وثقافيًا في آن واحد. ففي الاستعمال اليومي، تُحيل كلمة "عتبة" إلى ما هو أدنى أو ثانوي، وهو ما جعل بعض الباحثين يرون فيها مفهومًا يُقزِّم من قيمة العناصر المحيطة بالنص ويضعها في مرتبة تابعة للمتن. غير أن هذه الحمولة السلبية لم تكن مقصودة في تصور جينيت، الذي استعمل "عتبة" استعارة معمارية تشير إلى منطقة العبور بين الداخل والخارج، بينما اعتمد في المتن الأكاديمي مصطلح paratexte الأكثر تجريدًا ودقة. ولتفادي هذا الالتباس، لجأ بعض المترجمين مثل عبد الحق بلعابد إلى تعريب المصطلح بـ"المناص"، غير أن الشيوع الاصطلاحي ظل لصالح "العتبات" رغم ما يثيره من إشكاليات.
ويبدو أن هذا التفضيل ليس مجرد خيار لغوي بل يعكس أيضًا قيمًا ثقافية مرتبطة بمفردة "العتبة" في المخيال العربي. فالعتبة في التراث تُحيل إلى الفضاء الفاصل بين الداخل والخارج، إلى عتبة الدار التي يقف عندها الزائر، وإلى مكان الانتظار والتأمل والانطلاق. كما أنها في الشعر العربي القديم والمعاصر موضع يستدعي الحنين والذكرى، ويرمز إلى بداية الدخول في فضاء النص أو الحياة. من هنا، يكتسب المصطلح قوة مجازية قريبة من القارئ العربي، حتى وإن حمل في بعض استعمالاته إيحاءات بالهامشية أو التبعية، مما يفسر هيمنته في التداول النقدي العربي على حساب مصطلح "المناص" الأكثر تجريدًا وبُعدًا عن الحس الثقافي المشترك.
المراجعات النظرية
لقد وجّهت انتقادات إلى الثنائية الصارمة التي يفترضها مفهوم العتبات بين "النص" و"ما حول النص". فهذه القسمة ليست دائمًا واضحة؛ إذ إن بعض العناصر، مثل الحواشي والتعليقات، يمكن أن تُعتبر في آن واحد جزءًا من النص ومحيطه الخارجي. كما أن الطابع التراتبي الذي يفترضه المفهوم يظل إشكاليًا، لأنه قد يوحي بأن العتبات مجرد عناصر ثانوية أو تابعة لـ"النص الأساسي"، بينما تبرهن الممارسة القرائية على أنها قد تكون أكثر أهمية في تشكيل المعنى من المتن نفسه. يضاف إلى ذلك أنّ النظرية الجينيتيّة كثيرًا ما تُغفل البعد التاريخي للعتبات، فهي ليست كيانات ثابتة، بل تخضع للتغير المستمر تبعًا للسياقات الثقافية والزمنية التي تنتج فيها .
إزاء هذه الملاحظات، اقترح باحثون مثل جيرالد برنس، وجوناثان غراي، وماري-لور ريان، إعادة النظر في المفهوم من خلال ثلاث مقاربات أساسية. أولًا، النظر إلى العتبات بوصفها أجزاء مُكوّنة للنص وليست مجرد إطار خارجي ل. ثانيًا، التعامل معها كممارسات تواصلية حية، وليست كعناصر نصية ثابتة أو شكلية . وثالثًا، فهمها بوصفها مواقع للصراع والتفاوض، حيث يتقاطع عمل المؤلف والناشر والناقد والقارئ في تحديد معنى العمل الأدبي وتوجيه مسارات تلقيه .
لا يمكن مقاربة مفهوم العتبات بمعزل عن النظام المؤسسي والاقتصادي للنشر. فالعتبات النصية تخضع بدرجة كبيرة إلى استراتيجيات تسويقية تستهدف جذب القارئ وتحفيز عملية الشراء، كما يظهر جليًا في الأغلفة والعناوين والملخصات الخلفية. وهي كذلك نتاج لمفاوضات بين المؤلف والناشر، حول طبيعة العناصر المحيطة بالنص وحدود السيطرة عليها. علاوة على ذلك، تؤثر هذه المكونات في التلقي النقدي والأكاديمي للعمل، إذ تشكل المقدمات والتمهيدات أدوات لتأطير القراءة وتحديد أفقها .
خاتمة
يتضح من دراسة مسار مصطلح Seuils (عتبات) بين الفرنسية والإنكليزية والعربية أنّ الترجمة فعل ثقافي معرفي يعيد تشكيل المفاهيم بحسب السياق والخيال الثقافي للمتلقي. ففي النسخة الفرنسية الأصلية، حافظت الاستعارة المعمارية على بعدها الفلسفي والظاهراتي، موضحة العتبة كفضاء عبور، ومنطقة تأمل، وحد فاصل مزدوج يجمع بين الداخل والخارج، بين التجربة الذاتية للقراءة والمحيط النصي. أما في الترجمة الإنكليزية، فقد تم تحويل هذا المجاز إلى مفهوم تقني تجريدي (Paratexts)، ما منح المصطلح وضوحًا منهجيًا وعمومية مناسبة للأكاديميا الأنجلوسكسونية، لكنه قلل من طاقته الاستعارية وحمّلته طابعًا ثابتًا وتصنيفيًا، مركزًا على البنية النصية بدل تجربة العبور والانتقال.
وفي السياق العربي، أدى هذا التباين إلى تعددية اصطلاحية، حيث تعايشت الترجمات المختلفة بين "العتبات"، و"النص الموازي"، و"المناص"، وهو ما يعكس التقاطع بين الترجمة، والخيال الثقافي المحلي، والاستقبال النقدي. فالمصطلح "عتبات" يحتفظ بقوة مجازية قريبة من المخيال العربي، يستحضر الصور الذهنية المرتبطة بالانتقال، والحدود، والتأمل، والطقوس الرمزية، رغم حمولة سلبية محتملة مرتبطة بالإحساس بالثانوية أو التبعية. بينما يقدم "المناص" حلاً اصطلاحيًا أكثر تجريدًا ودقة، لكنه أقل ارتباطًا بالحس الثقافي المشترك.
تُظهر هذه الحالة أن المجاز الاصطلاحي يعمل كحلقة وصل بين النص والمخيال الثقافي، اذ يشارك المخيال في تفعيل الدلالات الرمزية والفلسفية، ويؤثر في تلقي النص واستجابته النقدية. ومن ثم، فإن دراسة التفاعل بين المجاز الاصطلاحي والمخيال الثقافي لا تفسر فقط اختلافات الترجمة، بل تفتح أيضًا أفقًا لفهم كيفية تشكل النظرية النقدية وتطبيقاتها عبر الثقافات، وكيف يمكن للمصطلحات أن تحمل، أو تفقد، قدراتها الرمزية بحسب البيئة اللغوية والثقافية التي تُستقبل فيها.


 فرانكشتاين.. مرآة الإنسان الحديث بين قلق الخلق واغتراب المعنى
فرانكشتاين.. مرآة الإنسان الحديث بين قلق الخلق واغتراب المعنى
 أردوغان يبلغ بزشكيان إستعداده للمساعدة في خفض التصعيد بين واشنطن وطهران
أردوغان يبلغ بزشكيان إستعداده للمساعدة في خفض التصعيد بين واشنطن وطهران
 غزّة بين أسنان متوحّشة وحلول متقطّعة
غزّة بين أسنان متوحّشة وحلول متقطّعة
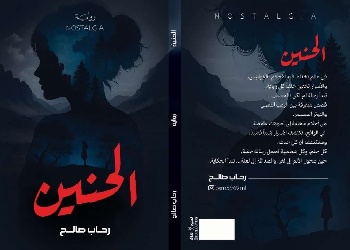 الحنين رواية تمزج بين رِقّة الإسم وظلال الرعب
الحنين رواية تمزج بين رِقّة الإسم وظلال الرعب
 التشاؤم الوجودي بين المعري وشوبنهاور
التشاؤم الوجودي بين المعري وشوبنهاور
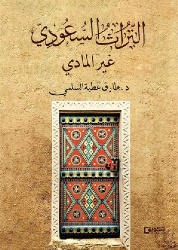 طارق السلمي يصدر كتاب التراث السعودي غير المادي بين الأصالة والمعاصرة
طارق السلمي يصدر كتاب التراث السعودي غير المادي بين الأصالة والمعاصرة
 طريق الهلاك بين واشنطن وطهران
طريق الهلاك بين واشنطن وطهران
 تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة
تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة
