



أبو نواس بغداد... حافظ جميل، شاعر الجمال والخمر والوجدان
محمد علي محيي الدين
في زقاقٍ من أزقّة بغداد القديمة، في محلة قنبر علي، وُلد عام 1908 شاعرٌ كُتب له أن يكون صدى لأبي نواس في القرن العشرين، ذلك هو حافظ عبد الجليل آل جميل، الذي عاش للشعر والجمال ومات وفي قلبه بقايا من أغنية لم تكتمل. لم يكن مجرد شاعر غزلٍ وخمر، بل كان روحًا معلّقة بين اللذة والقداسة، وبين الحنين والتوبة، وبين الجسد والروح، فاستحق أن يُلقَّب بأبي نواس بغداد.
تلقى حافظ جميل تعليمه في مدارس بغداد، لكنه منذ الصبا كان أسيرًا للكلمة، يسكب وجدانه في أبياتٍ عذبة، ويُدهش أساتذته بموهبته المبكرة. وهو على مقاعد الثانوية أصدر مجموعته الأولى "الجميليات"، ثم غادر إلى بيروت وهو في السابعة عشرة من عمره، ليكمل دراسته في الجامعة الأمريكية. هناك، وجد في المدينة وما فيها من انفتاحٍ وفكرٍ ما غذّى روحه الشاعرة. أنشأ مع زملائه من الطلاب ندوة أدبية سموها "دار الندوة"، يتناوبون فيها على كتابة القصائد بأسماء مستعارة من رموز الشعر القديم؛ فاختار إبراهيم طوقان لقب "العباس بن الأحنف"، ووجيه البارودي "ديك الجن"، وعمر فروخ "صريع الغواني"، أما هو فاختار أن يكون "أبا نواس"، ليعلن منذ مطلع شبابه انحيازه للجمال والبوح والتمرد.
تخرج حافظ جميل في كلية العلوم عام 1929 متخصصًا في التاريخ الطبيعي، وعاد إلى بغداد ليمارس التعليم في الثانوية المركزية ثم في دار المعلمين الابتدائية، قبل أن يتنقل بين الوظائف حتى صار مفتشًا عامًا في البريد. غير أن الوظيفة لم تطفئ جذوة الشعر فيه، فقد ظلّ يرى العالم بعين الشاعر ويستشعره بقلبٍ مترفٍ بالصور والإيقاعات. نال وسام الأرز اللبناني عام 1960، وكرمته بغداد عام 1975، وكان من مؤسسي اتحاد المؤلفين والكتّاب العراقيين. ومع ذلك بقي بعيدًا عن الأضواء، قليل الحضور في المنتديات الأدبية، وكأنّ العزلة كانت قدره منذ البدء، فظلّ شاعر الظلال، تهمس باسمه القلوب أكثر مما تتردده الألسن.
بدأ حافظ جميل شعره غزليًا، ثم انحدر مع العمر نحو صوفيته الخاصة، يسكب خمرة شعره لا في كؤوس اللذة بل في كؤوس التوبة. يقال إن الرصافي، حين سمع قصيدته الأولى وهو في الثامنة عشرة، تنبأ له بمستقبلٍ شعري باهر، وإن أحمد شوقي رأى فيه خليفةً له. وقال بعضهم إنه جمع بين ديباجة المتنبي وفلسفة المعري. وكان لا يخفي تأثره بأبي نواس، غير أنه خالفه في مجونيته، فجعل من الخمر رمزًا للتطهر لا للمتعة.
أصدر خمسة دواوين تمثل مراحل روحه الشعرية: "الجميليات"، "نبض الوجدان"، "اللهب المقفّى"، "أحلام الدوالي"، و"أريج الخمائل". في هذه المجموعات تبلورت تجربته بين الغزل والخمرة والوطن، فقصيدته "يا تين يا توت يا رمان يا عنب" التي كتبها وهو طالب، أطلقت اسمه في الأوساط الأدبية، وتتابعت بعدها قصائد تصوّر المرأة والخمر والحبّ والوطن بروحٍ حديثة وصورٍ مدهشة.
كتب الدكتور عبد الرزاق محيي الدين مقدمة ديوانه "الخمائل" فقال فيه: «حافظ جميل شاعر فحل من شعراء العربية في هذا القرن، سمع الناس شعره وحفظوه وذهب على ألسنتهم مذهب المثل... وهو مفضل على كثير من معاصريه إن لم يكن على جلهم». أما الأديب يعقوب مسكوني فقال: «تدعو أشعاره إلى العطف والرحمة والحكمة والشجاعة مثل قصائد صرخة الشريد، وموكب العيد، والجميل الضائع، وحق القوي، وتحت الدخان وضحايا الآلام".
لقد استأثر بشعره غرضان هما المرأة والخمرة، وهما في حقيقتهما عنده وجهان لجمالٍ واحدٍ يتلون بالحياة والوجد. خمريته ليست لهوًا ولا عبثًا، بل شوق إلى المطلق، واحتراق في لذّة النور، واعتراف بضعف الإنسان أمام سرّ الخلق. أما المرأة، فهي جنةٌ أرضية يستعيد فيها براءة البداية، فيراها مرةً عنقودًا ومرةً نجمةً ومرةً وطنًا، وتظلّ تسكن قصيدته كما تسكن الروح جسدها.
وحين كتب عنه الدكتور محيي الدين، أشار إلى أنه شاعر لم يعرف الطفرة ولا الهبوط، بل حافظ على طاقته الشعرية ثابتةً لا تنطفئ، تفيض في كل عمرٍ بصفاءٍ واحدٍ وصدقٍ لا يتغير. وهو ما جعل النقاد مختلفين فيه: أهو شاعرٌ متميز فريد، أم شاعرٌ راسخٌ لم يغادر مكانه في صفوف الكبار؟ لكنّ الجميع اتفق على أنه من فحول شعراء جيله، يمتاز بعبارةٍ جزلة وصورٍ موحية تنضح بالحياة.
قال عنه الباحث عبد الحميد الرشودي إنه شاعر عاش في الظل بعيدًا عن ضجيج الإعلام، وإن كثيرًا من النقاد يجهلون نشأته لأنّ حياته كانت عالماً مغلقًا على ذاته. وأكد الناقد شكيب كاظم أن حافظ جميل من القلة الذين وهبوا حياتهم للجمال والحبّ والمرأة، مستشهدًا به إذا ذُكر الغزل في الشعر العربي من امرئ القيس إلى نزار قباني. لقد ظلّ، كما قال، أسيرًا لمحراب الجمال والأنوثة والحياة، متنقلًا بين خمائل الهوى وأحلام الخمر، لا يغادر عتبة اللذّة ولا يملّها.
بعد التقاعد، انصرف حافظ جميل إلى عزلته، وعاش في داره ببغداد وحيدًا هادئًا، مستغرقًا في تأملاته، حتى وافاه الأجل يوم الجمعة الرابع من أيار 1984، عن عمرٍ ناهز الثمانين عامًا. دُفن في مقبرة الشيخ معروف الكرخي إلى جوار والده، ونعتته الصحف، ورثاه الشعراء، وكأن بغداد ودّعت معه آخر الشعراء الرومانسيين الذين وحّدوا بين جمال المرأة وقداسة الروح.
وهكذا رحل حافظ جميل كما عاش، صامتًا في حضرة الجمال، لا يطلب من الدنيا إلا بيتًا من الشعر يهديه الخلود. ترك وراءه خمسة دواوين تعبق بأريج الوجد، وتلمع فيها خمرة الروح وبهجة المرأة ودمعة العاشق، لتبقى قصيدته جسرًا بين أبي نواس والمتنبي، بين صخب الحياة وصفاء التصوف، بين جسدٍ يحنّ إلى لذته وروحٍ تهفو إلى السماء.
لقد كان حافظ جميل، بحق، آخر العاشقين الكبار في الشعر العربي، شاعرًا لم يبدّل إيمانه بالجمال ولا تنكّر لفتنته الأولى، مؤمنًا أن الحياة مهما أوجعت، تظلّ تستحق أن تُغنّى.


 خلف الأبواب الموصدة بنسختين عربية وكردية
خلف الأبواب الموصدة بنسختين عربية وكردية
 محافظة بغداد: المباشرة بإنشاء 9 مدارس جديدة في قضاء الزوراء
محافظة بغداد: المباشرة بإنشاء 9 مدارس جديدة في قضاء الزوراء
 مختارات عبد المنعم حمندي.. الشاعر يختزل المأساة ويرسم مركز العالم
مختارات عبد المنعم حمندي.. الشاعر يختزل المأساة ويرسم مركز العالم
 اللـه الحافظ
اللـه الحافظ
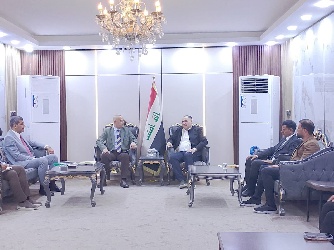 الشباب تبحث مع محافظ الديوانية تطوير البنى التحتية الرياضية
الشباب تبحث مع محافظ الديوانية تطوير البنى التحتية الرياضية
 من ذاكرة المسرح.. اللجنة تفتح أبوابها متأخّرة
من ذاكرة المسرح.. اللجنة تفتح أبوابها متأخّرة
 محافظ المثنى يحصل على أمر ولائي بإيقاف إقالته
محافظ المثنى يحصل على أمر ولائي بإيقاف إقالته
 محافظة بغداد: بدء أعمال تأهيل مدخل ناحية الرشيد
محافظة بغداد: بدء أعمال تأهيل مدخل ناحية الرشيد
