

بشار نديم الباجة جي لـ(الزمان ) عن قدرة المدينة تجاوز التحديات: المحن ومحطات الألم عناوين لصلابة الموصل
سامر الياس سعيد
من النخب المعروفة على صعيد مدينة الموصل بابرازها لعناوين التعايش والتلاحم اضافة للدور التنويري الذي تضطلع به سواء من خلال اصداراتها او توظيف مواقعها التواصلية في استنارة هذا الدور الحيوي حيث يضطلع الدكتور بشار نديم الباججي بهذا الدور الحيوي من خلال ما يسهم بنشره سواء من خلال ما داب على اصداره من مؤلفات الى جانب مقالاته التي تدور في المحور التنويري والمعرفي .. الزمان التقت الباججي وكان لها هذا الحوار :
{ صدر لك مؤخرا كتاب حول ريادة رابعة العدوية في الشعر الصوفي ، ماهي الأفكار التي يضمها إصداركم الجديد وهل هنالك ريادات لافتة في محطات الشعر الصوفي يمكن ابرازها في هذا السياق ؟
-سبق لي هذا العام أن اصدرتُ الى جانب الكتاب الذي اشرت اليه كتابين يتعلقان بالتصوف، الكتاب الأول ،كان كتابا مشتركاً صدر لي عن إحدى الجامعات الجزائرية تناولت فيه محاولات تجديد الخطاب الصوفي وتناولت تجارب معاصرة في هذا المجال كتجربة الشيخ النورسي في تركيا وتجربة جماعة التبليغ والهجرة في باكستان ، وتجربة الشيخ سعيد حوى في سوريا، والكتاب الثاني كان بعنوان ( الرمز في شعر الشيخ محيي الدين بن عربي ت638هـ) والكتاب يتعرض للغة الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي وهو شخصية إشكالية أثارت الكثير من الجدل واللغط ، وأظن أن المدخل اللغوي الذي عالجته في الكتاب يمكن أن يكون مدخلا ناجحا لفهم فكر وأدب هذا المتصوف والفيلسوف العظيم. والكتاب الثالث الذي صدر لي مؤخرا فكان عن المتصوفة رابعة العدوية التي كانت من أوائل الزهاد الذين حمَّلوا زهدهم خصوصيةً فكريةً ومنهجية، الأمر الذي جعلها رائدةً من رواد التصوف الإسلامي، فهي حلقة الوصل بين الزهد الذي كان شائعاً آنذاك وبين التصوف الذي بدأت ملامحه تظهر "وبظهور رابعة تطور مفهوم التصوف، فقد أصبح الزهد وسيلة من الوسائل التي يستعان بها على معرفة الله ومشاهدة جماله الأزلي .ورابعة أولُ من تحدث في الحبِّ الإلهي وصار أساساً من الأُسس التي يقوم عليه التصوف
{ تنتمي لمدينة عانت خلال ادوار تاريخها من محطات الاستهداف والمحن وتعول على تلاحمها الفكري والانساني ، برايك ما هي اهم خصائص هذا التلاحم وكيف بإمكاننا أن نرسخ لركيزة ودعائم تصون مثل ملامح هذا التلاحم والتعايش ؟
-مدينة الموصل كانت عبر تاريخها الطويل مركزا للتواصل بين حضارات وثقافات متنوعة ، واستطاعت عبر سلسلة طويلة من التجارب والمعاناة صهر هذه الثقافات في بوتقة واحدة وأنتجت هوية موصلية مميزة يمكن أن نجد صداها في الكثير من الشواهد الحضارية كفن العمارة الموصلي واللهجة الموصلية والمطبخ الموصلي والأزياء الموصلية، كانت هنالك هوية وحَّدت ساكني هذه المدينة . وبقيت الموصل منفتحة على ما يفد إليها من تيارات وكانت قادرة على احتوائها وفرزها واستقبال الصالح منها ، لذا تجد المدينة متواصلة مع ثقافات عدة ، هذا ملمح من ملامح التحضر والمدنية، وعلينا أن نعزز هذا الانتماء عبر التأكيد على القيم الحضارية والثقافية المؤسسة لهذه المدينة. وأظن أن الجهد الأكبر يقع على مثقفي المدينة وفنانيها ورجال الدين والجهات الفاعلة المؤثرة في الحفاظ على الإرث الحضاري والمدني للموصل وهي كفيلة بتعزيز روح التآلف والتعايش بين مكونات المدينة وقادرة على مواجهة أية تداعيات طائفية أو عنصرية تحاول عرقلة مسيرة المدينة الحضارية. والموصل تعرضت عبر تاريخها الطويل لكثير من الحملات العدائية باءت جميعها بالفشل حين عمل أبناء المدينة بروح الفريق الواحد وتجاوزوا هوياتهم الفرعية ، وهنالك الكثير من الشواهد على ذلك فكتب التاريخ تحكي أن الموصل احتضنت أبناء عشرات القرى والبلدات المسيحية والايزيدية والشبكية والكردية في غزوة نادر شاه ، وتحكي كتب التاريخ عن تعاون وثيق بين هذه الطوائف أجمع في صد هذا العدوان ومواجهته. وهنالك اكاديمية تدريسية في جامعة الحمدانية نشرت بحثا أكّدت فيه على الموقف الوطني المميز للطوائف المسيحية في صد عدوان الشاه الصفوي ، ولا ننسى أيضا قدرة المدينة على مواجهة المخاضات السياسية الصعبة خلال الخمسينات والستينات ومرحلة ما بعد الاحتلال الاميركي وسيطرة عصابات داعش . هذه التجارب بالرغم مما تحمله من ألم ومعاناة لكنها كانت عنوانا بارزاً من عناوين صلابة المدينة وتلاحمها .
{ تعمل كثيرا على إبراز دور مواقع التواصل في إيصال الافكار وإبراز ملامح الفكر الاكاديمي بالاستذكار و إبراز البصمات الموصلية الراسخة ، إلى أي مدى يمكن أن نوظف مثل تلك الوسائل في مخاطبة الأجيال الجديدة وإدراك أهمية دورها في قيادة البلد وتجاوز الازمات ؟
-الكل يعلم جيدا أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تتسيد الموقف الإعلامي، وهنالك تراجع واضح للصحافة المقروءة وللاعلام المرئي والمسموع لصالح وسائل التواصل، وصارت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير على ثقافة المُجتمع، واقتصاده، ونظرته الشاملة للعالم، كما أنّها تحولت على ساحة لطرح القضايا المُجتمعية ومُناقشتها؛ كالقضايا الصحية، والاختلافات الثقافية، والعلاقات العامة، حيث تتباين تأثيرات هذه الوسائل على المُجتمعات ما بين سلبية وإيجابية.، و لوسائل التواصل العديد من الآثار السلبية، كالتأثير على صحة الأفراد النفسية كالإصابة بالقلق والاكتئاب، وتأثيرها على ثقافة المجتمع، وانتشار الأخبار الكاذبة، وزيادة التنمر الإلكتروني، وزيادة الشعور بالوحدة، والبعد عن التواصل المباشر مع الآخرين وكما لها دور في تراجع العلاقات الاجتماعية، والفراغ العاطفي، وصارت وسائل التواصل الاجتماعي من اسباب تفكك الأسرة والمجتمع، وغيرها. فالواجب يقتضي من مثقفي المدينة عدم ترك الساحة لكل من هب ودب ، فهذه الوسائل بالرغم من فائدتها العظيمة في سرعة نقل الخبر والمعلومة وإيصالها إلى أكبر عدد من المتلقين إلا أن لها مخاطرها ، فالجميع أصبح قادرا على النشر فيها دون مراعاة لأهمية أن يكون الناشر يمتلك المؤهلات اللازمة للتأثير الحقيقي والفاعل ، واليوم نجد أن الشباب أصبحوا من المبدعين في هذا المجال فلديهم الامكانات الكافية من برامج مونتاج ومؤهلات فنية ، لكنهم يبقون بحاجة إلى إرشاد وتوجيه ، فاللعبة قد تكون خطرة وتنقلب إلى الضد .
{ تتخصص اكاديميا بالأدب الاندلسي ، هل أوفى المستشرقون لملامح تلك المحطات المهمة من الادب المتعلق بالعرب في اهم محطاتهم الزاخرة .. وهل ادركت المؤسسات الاكاديمية ثقل تلك المحطات وتأثيرها لإبرازها في الفنون المعرفية والعلمية اللاحقة ؟
-الاستشراق الإسباني قدَّم خدماتٍ جليلةً للتراث العربي الإسلامي، في مجالات الفكر والأدب والعلوم ، ولاسيما ما يتعلق منه بالحقبة التي قضاها المسلمون في بلاد الأندلس. وتناول كثيرٌ من المستشرقين الإسبان الوجود الإسلامي وتحدثوا عن أهميته بالنسبة إلى إسبانيا، وللاستشراق الإسباني خصوصيات تميّزه من باقي الحركات الاستشراقية في الغرب، منها احتكاكُه المباشر بالتراث العربي الإسلامي في بلاد الأندلس ، وتناوله كثيراً من متونها الأدبية والفكرية والعلمية، بالدرس والتحليل، باعتماده جملة من الرؤى المنهجية الفعّالة. وكان دافع المستشرقين الإسبان يتمثل بوعيهم بضرورة استحضار الآخر لدى إرادة تحديد هُويتهم، لاسيما وأنه يشكل جزءاً لا يتجزّأ من ذاكرة إسبانيا وهويتها الحضارية الممتدّة في أعماق التاريخ. وعناية المستشرقين الإسبان بهذا التراث اقتضتْه منهم الحاجة تعرُّفهم إلى ذاتهم، وتحديد هويتهم ، وتأسيسها بالنظر إلى نقيضها والمختلف عنها؛ أي إلى آخَرها: الشرق، وفكرة الأنا، في الدراسات الحديثة لا تكتسب معناها إلا في مقابل مفهوم الآخر، ومفهوم الأنا يقتضي في ذاته ضرورة وجود آخر، ليكون موضوع سيطرة هذه الأنا وهيْمنتها عليه. ومئات بل آلاف الشواهد الحضارية الأندلسية التي لاتزال قائمة كانت ولاتزال حاضرة في الوعي والذاكرة الاسبانية ، وفي طليعة المستشرقين الاسبان يبرز اسم المستشرق الكبير " أسين بلاسيوس" الذي كان له الدور البارز في التعريف بالتصوف الاندلسي وكشفت دراساته وبحوثه القيمة عن المؤثرات الاسلامية في أعظم أثر أدبي إيطالي الكوميديا الإلهية لدانتي ، وهنالك دور كبير للمستشرق الاسباني إميليو غرثيا غومث في التعريف بالمؤثرات الاجتماعي في الأدب العربي الأندلسي، وهنالك دراسات قيمة للمستشرق الهولندي " دوزي" عن طبيعة المجتمع الأندلسي التي اتسمت بالتنوع والانفتاح والتواصل.
عموما أرى أن المستشرقين الاسبان كانوا أكثر موضوعية وأقرب إلى روح الحضارة الأندلسية وكانوا بشكل كبير الأقدر على الناي بأنفسهم عن روح التعصب والاستعلاء الديني والحضاري.
{ وفي ضوء السؤال السابق ، ما الذي يمكن إدراكه في إبراز تأثير الادب المقارن بتلك المحطة عبر تأسيس مراكز معرفية علمية تستخلص مادتها من هذه المحطات ؟
-كان الأدب ولا يزال وسيلة مهمة من وسائل التواصل بين الثقافات والشعوب، والأدب المقارن فيه آليات يعرفها المختصون تدرس التأثيرات المتبادلة بين أدبين مختلفين في اللغة والنسق الثقافي، والأدب المقارن يؤدي بالتالي وسيلة من وسائل درس التبادل الحضاري والتنوع وتخطي حدود الانغلاق القطرية والقومية . الأدب العربي كان متأثرا بشكل من الأشكال بمحيطه السرياني والعبري والفارسي والروماني والهندي والحبشي ، وظهر هذا التأثر في الشعر والأدب ، مثلا لا يمكننا أن نغفل تأثر الفراهيدي حين وضع معجمه " العين " وهو أول معجم في العربية بمؤثرات خارجية ، فالفراهيدي عاش في البصرة في وقت كانت فيه هذه المدينة منفتحة على ثقافات متنوعة كالهندية والفارسية.
والأندلس جسرا من جسور التواصل بين الشرق والغرب ، فقد عُرف عن الأندلسيين شغفهم باستكشاف محيطهم الأوربي فهنالك أدب الرحلة ، وأدب السفارات المتبادلة ، ولا ننسى أن الأندلس كانت تضم تنوعا سكانيا ( عرب، بربر، يهود، المسيحيين، القوط) منحها قدرة على التعرف على الآخر والتواصل معه، وكانت الموانيء الأندلسية تستقبل يوميا عشرات السفن القادمة من البندقية وسردينيا وصقلية وغيرها من الموانيء الأوربية، فالأندلس عاشت نموا اقتصاديا مذهلا خلال الوجود الاسلامي فيها ، وهذا شجع الاوربيين على إقامة علاقات تجارية معها ، ولا ننسى أيضا أن المسيحيين الأندلسيين كانوا يتصلون مذهبيا بفرنسا فالأديرة الاسبانية كانت تدرس اللاتينية والفرنسية والعربية ، وهكذا نشأ أول جيل من المستعربين ، وظهرت أولى التراجم اللاتينية للقرآن .
واليوم هنالك نهضة غير طبيعية في المراكز البحثية الاسبانية والبرتغالية والمراكز الأكاديمية لدراسة التاريخ الأندلس المادي والفكري ، بعد أن تخلص الباحثون من هيمنة روح التعصب المنغلقة التي كانت تفرضها الكنيسة، والاسبان والبرتغال ينظرون اليوم بإعجاب وتقدير إلى منجزات الحضارة الاندلسية ويشمرون عن سواعد الجد للكشف عن المزيد من خفاياها . وهو أمر صرنا نحسدهم عليه حين نرى مراكزنا الأكاديمية والبحثية تقف مبهورة بهذا النشاط العلمي


 الأمن الوطني يفصح عن خفايا سرقة نفط البصرة: أبطالها ضبّاط ومنسّق ومهرّبين
الأمن الوطني يفصح عن خفايا سرقة نفط البصرة: أبطالها ضبّاط ومنسّق ومهرّبين
 توصية بالإبتعاد عن شراء ألعاب الصجم وتجنّب مزاح المفرقعات
توصية بالإبتعاد عن شراء ألعاب الصجم وتجنّب مزاح المفرقعات
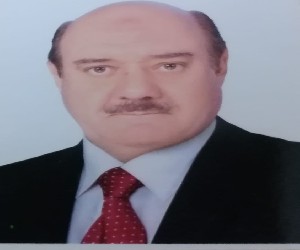 تقرير استراتيجية الامن القومي الامريكي لسنة 2022.. تحديات مركّبة لتشكيل نظام دولي جديد
تقرير استراتيجية الامن القومي الامريكي لسنة 2022.. تحديات مركّبة لتشكيل نظام دولي جديد
 باسم جيفارا ولقاء المصادفة
باسم جيفارا ولقاء المصادفة
 جهود إفتتاح خليجي 25 تصل النهاية واليوم إنطلاق بيع التذاكر
جهود إفتتاح خليجي 25 تصل النهاية واليوم إنطلاق بيع التذاكر
 معن: البصرة آمنة والبطولة بوابة لمنافسات أخرى
معن: البصرة آمنة والبطولة بوابة لمنافسات أخرى
 وفاة البرازيلي بيليه أسطورة كرة القدم العالمية عن 82 عاماً
وفاة البرازيلي بيليه أسطورة كرة القدم العالمية عن 82 عاماً
 قاتل الكرد الثلاثة في باريس عنصري أم إرهابي أم مريض نفسياً ؟
قاتل الكرد الثلاثة في باريس عنصري أم إرهابي أم مريض نفسياً ؟
