
عزيزي البروفيسور
سعد صبّار السامرائي
في جامعة بازل السويسرية، ما بين عامي 1869 و1879، تجاور في أروقتها شابّان لم يتجاوزا الرابعة والعشرين من العمر؛ جمع بينهما الاسم والعزم، وفرّق بينهما المزاج والمنهج.
أحدهما: فيلسوفٌ متّقد الذهن، مشبوب الروح، كثيف الشارب، كأنما يُسدل عليه ستارٌ من القلق؛ جبينه موصولٌ بسؤال الوجود، ونظرته تنفذ إلى ما وراء الظاهر، تبحث عن المعنى في العدم.
والثاني: عالم كيمياء نحيل البنية، ساكن الحركات، لا يعلو صوته ولا يضطرب سكونه؛ يعمل في المختبر كما يعمل الناسك في صومعته، ينقّب بصمت عن سرّ الحياة في الصديد والدم.
لم يكن هذان الموهوبان سوى (فريدريك نيتشه وفريدريك ميشر)؛ وُلد الاثنان في العام ذاته، 1844، وبلغا معًا لقب "بروفيسور" قبل أن يبلغ أحدهما الخامسة والعشرين.
لم يكن اللقب آنذاك زينةً اجتماعية، ولا سلّمًا وظيفيًا يخضع لمحاباة الأقارب، أو لحسابات الأقدمية، أو لتراكم الملفات الصفراء؛ بل كان شهادةً على عبقريةٍ مبكرة، وعلى مؤسساتٍ أكاديمية تراهن على الكفاءة الخالصة، لا على عدد البحوث "الهزيلة"، ولا على سنوات الخدمة، ولا على لوائح الترقية البيروقراطية.
أتساءل أحيانًا: هل التقيا في أروقة الجامعة؟ هل تبادل الفيلسوف والعالِم تحيةً عابرة بين القاعات؟
هل لمح نيتشه ميشر وهو يستخلص خلايا الدم البيضاء من جروح الجنود أو من حيامن أسماك السلمون؟ تلك التجارب الصامتة التي ستقوده، دون أن يتنبّه آنذاك، إلى عزل مادةٍ غامضة تُدعى "النيوكلين" — التي ستُعرَف لاحقًا بأنها نواة سرّ الحياة. وهل قرأ ميشر كتاب نيتشه الأول "ولادة المأساة من روح الموسيقى"، وشعر بثقل اللغة الفلسفية وهي تنقّب في أعماق الروح الإغريقية؟
أتخيّلهما — حين أترك للعقل فسحة الخيال — وقد التقيا فعلًا؛ في ركنٍ قصيّ من باحة الجامعة، ذات صباح رماديٍّ بارد، جلسا إلى طاولةٍ خشبية، وانبعث البخار من فنجانَي قهوةٍ سوداء.
كان نيتشه، بصوته الهادئ ونظرته المستقصية، يتأمل ميشر كمن يفتّش عن المعنى خلف الظواهر.
قال: "عن ماذا تبحث، يا ميشر؟ أترى في هذا الصديد حكمةً لا نراها؟"
فأجابه ميشر، وهو يتناول آخر رشفة من فنجانه: "أبحث عن ضابط إيقاع هذه الحياة؛ هناك شيءٌ أسود في خلايانا يُدعى النواة... أريد أن أعرف ما بداخلها."
قال نيتشه، بعد صمتٍ ثقيل: "أنت تعرف نفسك، ها أنت تنبش في طين الخلايا؛ بحثك وعدٌ بالمعرفة، وشديد الإنسانية... فقلوب أنويتنا معتمة، غامضة، مخادعة، تشبهنا. وأنا أنبش في المأساة، لأرسم حدود الروح؛ كلا الطريقين موحش."
كان أحدهما يغوص في أصل التراجيديا، يتتبّع أثر ديونيسوس في النفس، ويتحدّى أسس الأخلاق؛
والآخر يحفر بإبرةٍ دقيقة، يقشّر أغشية النواة، ويبحث عن الأصل البيولوجي للوجود.
كلاهما، دون أن يدري، كان يحاول فكّ شيفرة الحياة: أحدهما من جهة الروح، والآخر من جهة الجسد.
بعد سنوات، سيقلب نيتشه وجه الفلسفة الأوروبية، مفجّرًا أسئلة الذات والقيم والسلطة؛ وسيفتح ميشر بابًا لعصرٍ جديدٍ في البيولوجيا، حين عزل مادةً لم تُفهم أهميتها إلا بعد عقود، لكنها كانت الشرارة الأولى لثورةٍ جينيةٍ ما تزال تتقد حتى اليوم.
أتساءل أيضًا، من دون الحاجة إلى خيال:
كيف تحوّل اللقب الأكاديمي من شهادةٍ على الفكر والابداع إلى لافتة تُعلَّق على الأبواب، وتُجرّ إلى المجالس والمقاهي، حتى إذا صادفت أحدهم في الشارع، وجب عليك أن تقول: "كيف حالك يا بروف؟"
أرى الحروف "أ.د" تتدلّى على بابٍ مغلق، ولوحة أخرى تلمع فوق طاولة صامتة.
وحين أفتّش عن الأثر — عن فكرةٍ حية، أو سؤالٍ يوقظ السكون — لا أجد إلا عناوين مترهلة، وأفكارًا مستهلكة، لا تُضيف حرفًا إلى هرم المعرفة، ولا تسند عقلًا يبحث عن المعنى.
في زمنٍ يتضخّم فيه عدد من يحملون لقب "الأستاذ الدكتور" في جامعاتنا، وتتهاوى فيه المعايير تحت ضغط المجاملة، أو التساهل، أو المحسوبية — يحقّ لنا أن نسأل:
هل ما زال لهذا اللقب معنى؟
هل بقي رمزًا للتميّز الفكري والتأثير العلمي؟
أم غدا مجرّد رتبةٍ إداريةٍ تُمنح بالتقادم والرضا؟
العِلم، حين يُختزل في الترقية، يفقد روحه؛ والفكر، حين يُحاصر بملفّات التقييم، يُصاب بالتيبّس؛ والمعرفة، كما يتّضح في فلسفة نيتشه، تنبت من الصراع، لا من الطمأنينة؛ والحياة، كما اكتشف ميشر، ليست إلا شيفرة تُعاد كتابتها في كل خلية.
فهل نملك اليوم من يقرأ هذه الشيفرات الجديدة؟
من يتأمل المأساة؟
من يبحر في النواة؟
هل لا تزال جامعاتنا تصنع الروّاد، أم تعيد إنتاج العناوين؟
نحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى مراجعة معيار القيمة الحقيقية لصناعة الأفكار، لا عدد الألقاب؛ فالألقاب التي لا تسندها المعرفة، لا تلبث أن تسقط من شجرة الذاكرة.
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، سلطنة عُمان.


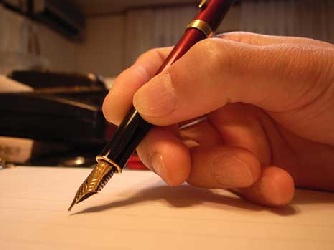 في مديح التطبيل: يا عزيزي كلّنا مطبّلون
في مديح التطبيل: يا عزيزي كلّنا مطبّلون
