
الشاعر والبلاد (37)
حسن النواب
في مسرح الرشيد كانت تعرض مسرحية قصة حب معاصرة التي كتبها فلاح شاكر وأخرجها هاني هاني؛ فيما تقاسم بطولة تلك المسرحية جواد الشكرجي وسهير إياد، دخل صديق الغجري إلى صالة الاستقبال بملابسه العسكرية؛ كان قادماً بإجازةٍ من وحدته العسكرية في البصرة، لم يذهب إلى أهله في كربلاء، إنَّما توجَّه الى بغداد لمشاهدة المسرحية. في زقاق من الحيدر خانة احتسى خمراً محليَّاً وترك حقيبته مع بائع ابنة الكروم، ويمَّمَ وجههُ إلى مسرح الرشيد، كان قبل شهر قد دخل إلى مبنى السينما والمسرح ليستعلم عن مصير مسرحية كتبتها للأطفال، قابل الفنان قاسم الملاك الذي كان نائباً للفرقة القومية للتمثيل وكان منشغلاُ بتناول وجبة فطور من اللحم المشوي؛ ومع ذلك أجابه بطريقةٍ مهذّبة:
- اصعد للطابق السادس غرفة 12.
ذهب إلى هناك فوجدها مغلقة، فتح باباً بجوارها، وإذا به أمام قاعة فسيحة يرى فيها الفنان جواد الشكرجي والفنانة سهير مع المخرج هاني هاني منهمكين في تدريبات على المسرحية، توقفوا عن العمل وهم يبصرون هذا الكائن الغريب الذي اقتحم محرابهم المقدَّس؛ فشعر بالارتباك إلاَّ أنَّ المخرج هاني هاني سألهُ عن مبتغاه؛ لبث صامتاً سرعان ما أغلق الباب وفرَّ من المكان. كان يتمنى رؤيتهم وهم يتدربون على المسرحية؛ لكنَّه قرر مشاهدة قصة حب معاصرة عندما يحين عرضها على المسرح؛ وها هو قد جاء الآن ثملاً، أمسك به الجنود وحماية المسرح، وأرغموه على الخروج وحرموه من مشاهدة المسرحية بذريعة ثمالته. بعد شهور حضر إلى معرض للفنان ستار كاووش في قاعة الرواق، وكتب عن المعرض مقالاً مثيراً اعتمد فيه على آراء نخبة من المثقفين والفنانين بلوحات كاووش، كان من بينهم يوسف الصائغ والناقد سامي محمد والمخرج هاني هاني الذي أخبره عن قصة حرمانه من مشاهدة المسرحية؛ فيما ذاعت شهرة كاووش بعد نشر المقال على أخيرة جريدة العراق؛ وكان ذلك أول استطلاع صحفي في حياة كاووش عن لوحاته الأنيقة. أما الفنانة سهير إياد فقد حانت فرصة اللقاء بها بعد مضي عام تقريباً؛ حين وجدها تجلس مع الفنان رائد محسن في صالة المنصور ميليا، عرض عليها ما كتبهُ عن مسرحية قصة حب معاصرة بعد مشاهدتها من شاشة التلفاز، وفيما كانت تقرأ بسطور مقاله انهارت بالبكاء؛ كان في حينها المخرج هاني هاني قد توفى بحادثة مفجعة، لم يستطع رائد محسن إيقاف الدمع المنهمر من عيني سهير؛ فتساءلَ بأسى:
- ماذا فعلتَ بها يا هذا؟
إثر تلك الواقعة نشر صديق الغجري قصيدة بجريدة القادسية بعنوان أدركني أيها الألم، وفي منتدى المسرح كانت الفنانة سهير أياد مستغرقة بمطالعة القصيدة وتداري الدمع الذي تلألأ في مآقيها؛ ولم يرها بعد ذلك أبداً. كانت تلك المشاهد تصهل في براري ذاكرة صديق الغجري وهو لم يزل يجلس على مصطبة في حديقة جرداء حولتها الحرب وسنوات الحصار إلى ركام من النفايات؛ وتذكَّر ذلك الصباح الذي أيقظه رضا المصري نادل فندق الصياد في الميدان وأمره بمغادرة المكان قبل حضور صاحب الفندق؛ كان برفقة الشاعر كزار حنتوش وقد سمح لهما المصري بالمبيت تحت سلَّم الفندق لأنَّ جيوبهم تصفر فيها الريح. تركا الفندق ونعاس مزعج مازال عالقاً في أجفانهم، قطعا الطريق نحو جسر حافظ القاضي المؤدي إلى الصالحية؛ لقد عزما زيارة الشاعر يوسف الصائغ حين كان مديراً للسينما والمسرح، رفعهما المصعد إلى مكتبه؛ وإذا بالفنان طعمة التميمي يجلس خلف مكتبه بغرفة جانبية، نظرتهُ الحائرة ذكرتهما بدور رحومي الذي جسَّدهُ في مسلسل الذئب وعيون المدينة، كان في حينها نائباً للصائغ، دخلا إلى غرفة المدير العام سرعان ما جاء لهما العامل بفنجانين من القهوة، بينما كان الشاعر يوسف الصائغ يرفع نظره نحو كزار بين لحظة وأخرى ويحرك قلم الحبر على ورقة أمامه؛ ماهي إلاَّ دقائق حتى رفع الورقة وطلب من كزار أنْ يراها؛ ذهل الاثنان عندما أبصرا الورقة، كانت تخطيطاً بالحبر لوجه كزار ممهورة بتوقيع الصائغ. كان البورتريه بغاية الروعة والاتقان؛ كأنهُ رسم روح كزار مع ملامحه التعيسة، لكنَّ كزار لم يكتف بالتخطيط إنما استدان من الصائغ مبلغاً من المال يكفيهما لجلسة النهار؛ فيما احتفظ صديق الغجري بذلك البورتريه الثمين. في طريق العودة صادفا الفنان نصير شمة؛ صافح كزار نصير شمّه قائلاً:
- كأني أصافح شمعة؛ وليس شمَّه.
ضحك عازف العود الأمهر وطبع قبلة على خد كزار بمحبة غامرة؛ حين انصرفا عنهُ كانت الحيرة ترافقهما؛ فهما لا يعرفان أين الملاذ الذي يحتسيان به ابنة الكروم؛ فقد أغلقت الحانات بأوامر مشدَّدة من قائد الحملة الإيمانية؛ ولذا هرعا تحت جسر الصالحية بعد شرائهما لأربع قناني جعة من محل قريب، ما كادا ينتهيان من كرع القارورة الأولى حتى داهمهما زورق أحمر، هبط منهُ شرطيان من الدفاع المدني وبلهجة بذيئة طلب أحدهما إبراز هويتيهما، كان صديق الغجري يحمل هوية جريدة العراق، أمَّا كزار فكان بلا هوية ولا جنسية، بعد حوار متوتر لا يخلو من التهديد والوعيد أمرهما بالانصراف على وجه السرعة من المكان، فغادرا لاهثين وهما يحملان ما تبقى من لوازمهما؛ عبرا الجسر إلى الضفة الأخرى ليهبطا نحو أنبوب ضخم كان يطلق مياه آسنة إلى نهر دجلة، كرعا شرابهما على عجل وقد غاصت أقدامهم في الوحل؛ كأنَّ الحملة الإيمانية عاقبتهما وصبَّتْ جام غضبها على هذين التعيسين لتناولهما المنكر؛ بالوقت الذي كانت الحفلات الماجنة والخليعة لأبن الرئيس يتردد صداها في بقاع البلاد بأسرها. أجل لم يكن ذلك الجندي الثمل الذي طردوهُ من القاعة سوى صديق الغجري؛ ومجدهُ كان بملابس الجبهة الرثَّة ولم يكن يحمل بيده سلاحاً؛ إنما رواية وداعاً للسلاح.
يتبع…


 الشاعر والبلاد (36)
الشاعر والبلاد (36)
 الشاعر والبلاد (35)
الشاعر والبلاد (35)
 الشاعر والبلاد (33)
الشاعر والبلاد (33)
 الشاعر والبلاد (32)
الشاعر والبلاد (32)
 الشاعر والبلاد 31
الشاعر والبلاد 31
 الشاعر والبلاد (30)
الشاعر والبلاد (30)
 الشاعر والبلاد (29)
الشاعر والبلاد (29)
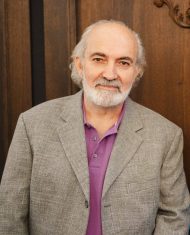 غربتك ايها الشاعر كوردستانك
غربتك ايها الشاعر كوردستانك
