
حكاية فيها مواعظ
جبارعبد الزهرة
حكاية فيها موعظة وارشاد ونصحية وتحذير لأهل الانتماء الديني المختلف تدعو كل واحد الى احترام خصوصيات الآخر وعدم التجاوز عليها وخاصة اكثر المسائل حساسية وهي الإنتماء الديني وقد حذر الله تعالى أهل الأرض داعيا الناس على مختلف مستويات الحياة ذات الهويات الفرعية مثل الدين والثقافة والفكر والتراث الشعبي وغيرها الى عدم الصدام وافتعال النزاع على خلفية هي تلك الإنتماءات الفرعية لأن الإنتماء الإنساني العام هو مطلوب اعتماده بين الناس واقامة علاقات الإحترام ورعاية السلم الأهلي على اساسه فاحترام الانتماء العام الى الإنسانية بصورتها الكاملة يقضي على كل المشاكل والنزاعات بين البشر وهكذا كانت دعوة الله سبحانه الى عباده لنبذ الإنتماءات الفرعية والتمسك بالانتماء العام للبشرية وذلك بقوله تعالى (لكم دينكم ولي ديني ) فما اوسعها وما اعمقها من حكمة في توجيه الإنسان نحو السعي لتوفير مستلزمات السلامة لنفسه وللوسط الإجتماعي الذي يعيش فيه والبحث عنها في سلوكه اليومي تجاه الآخر وحث الآخر على بنائها في نفسه وتنمية التشبث بها كخلفية توجيهية وارشادية له نحو التعامل مع الآخرعلى طريق محاسن الأخلاق وسلامة السلوك
في هذه الحكاية التي ادت الى اندلاع حرب قاسية بين الكاثوليك وبين الارثدوكس التي راح ضحيتها اكثر من عشرة ملايين انسان بريء فيها دعوة لتغليب الإحساس الوطني لدى شعوب البلد الواحد التي تكون تركيبته السكانية فيها انتماءات مختلفة المشارب الفرعية بالاحساس الوطني يمكن جمعهم تحت خيمة الوطن الواحد الذي ينتمون إليه لنشرالسلم الأهلي بينهم والإستقرار واستثمار جهودهم لبناء وطنهم وتفوير الحياة الحرة السعيدة والآمنة لجميع.
صراعات دينية
في عام 1648، كانت أوروبا تشبه مريضاً يحتضر، يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط ركام من الدخان والرماد. كانت القارة العجوز قد قضت ثلاثين عاماً كاملة في «حرب الثلاثين عاماً»، وهي من أبشع الصراعات الدينية التي عرفتها البشرية، حيث تحولت سهول ألمانيا ومدن بوهيميا إلى مسالخ مفتوحة، واختلطت دماء الكاثوليك بدماء البروتستانت حتى لم يعد بالإمكان التمييز بينهما. في تلك السنوات السوداء، انخفض عدد سكان ألمانيا بحوالي 20بالمئة، وانتشرت المجاعات لدرجة أن الناس أكلوا العشب والجلود، وسادت قناعة عدمية بأن «يوم القيامة» قد حل بالفعل، وأن الرب قد تخلى عن قارة تقتل نفسها باسمه.
ولكن، من رحم هذا اليأس المطلق والإنهاك الشامل، ولدت المعجزة الدبلوماسية التي أنقذت الحضارة الغربية. أدرك الملوك والأمراء، سواء في فيينا أو باريس أو ستوكهولم، الحقيقةً الواقعية التي غابت عنهم لقرون: «لا أحد يمكنه الانتصار في حرب العقائد، وأن الاستمرار يعني فناء الجميع». ولأول مرة، قرروا وضع السيوف جانباً والجلوس إلى الطاولات.
في مدينتي «مونستر» و»أوسنابروك» في منطقة وستفاليا، اجتمع مئات الدبلوماسيين الذين يمثلون كل القوى المتحاربة. كان الجو مشحوناً بالكراهية والشك، لدرجة أنهم قضوا أسابيع يتجادلون فقط حول «من يجلس أين» ومن يدخل القاعة أولاً. لكن الضرورة كانت أقوى من الكبرياء. فبعد مفاوضات ماراثونية وشاقة استمرت لسنوات، تمخض الجبل عن «صلح وستفاليا».
ظلام سياسي
لقد كانت هذه المعاهدة بمثامبة «شهادة ميلاد» لأوروبا الحديثة ونهاية لعصور الظلام السياسي. لأول مرة، تجرأ السياسيون على تحييد الدين عن السياسة الخارجية.
فقد أقروا مبدأ «سيادة الدولة»، حيث لا يحق لأي إمبراطور أو بابا أن يتدخل في شؤون دولة أخرى بحجة الدين. تم الاعتراف بحق الكاثوليك واللوثريين والكالفينيين في العيش وممارسة طقوسهم (وإن كان بشكل نسبي يتبع حاكم المنطقة)، وتم رسم الحدود بناءً على المصالح الوطنية لا الانتماءات المذهبية. وكانت اللحظة الأكثر رمزية ودلالة على هذا التحول التاريخي، حين أصدر البابا «إنوسنت العاشر» مرسوماً غاضباً يعلن فيه أن معاهدة وستفاليا «باطلة، ملعونة، وغير شرعية» لأنها قلصت نفوذ الكنيسة.
لكن الصدمة كانت أن ملوك أوروبا، حتى الكاثوليك منهم، تجاهلوا صراخ البابا تماماً ومضوا في توقيع الاتفاق. كانت تلك هي اللحظة التي ماتت فيها سلطة الدين السياسية في أوروبا، وولد مفهوم «الدولة القومية».
وهكذا، خرجت أوروبا من وحل الحروب الدينية منهكة ولكن أكثر نضجاً.
لم يختفِ الدين من قلوب الناس، لكنه انسحب من ساحات المعارك ليعود إلى الكنائس والضمائر، وتــــــــــــــعلمت القارة الدرس الأقسى في تاريخها: أن دمج السيف بالصليب (أو الكتاب المقدس) لا ينجب إلا المقابر، وأن التعايش ليس خياراً أخلاقياً رفيعاً، بل هو ضرورة براغماتية للبقاء على قيد الحياة.


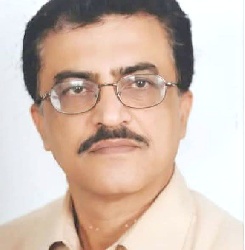 حين يصبح الموت مولِّدًا للأسئلة يأتي شوقي ليقف على الحكاية بوصفها مقاومة للفناء
حين يصبح الموت مولِّدًا للأسئلة يأتي شوقي ليقف على الحكاية بوصفها مقاومة للفناء
 حسن الجنابي قدم من الرمادي ودفن فيها
حسن الجنابي قدم من الرمادي ودفن فيها
 حكاية رمضانية
حكاية رمضانية
 الجزيرة ليست كل الحكاية: لماذا نصرخ هناك ونصمت هنا؟
الجزيرة ليست كل الحكاية: لماذا نصرخ هناك ونصمت هنا؟
 سمر الحاجي محمد حكاية البدايات وأثر الفقد وعبور أفق جديد: الشعر طريقتي لفهم الغياب
سمر الحاجي محمد حكاية البدايات وأثر الفقد وعبور أفق جديد: الشعر طريقتي لفهم الغياب
 جبار وفوزية.. حكاية حب ملأت العمارة حزناً مطلع ستينيات القرن الماضي
جبار وفوزية.. حكاية حب ملأت العمارة حزناً مطلع ستينيات القرن الماضي
 العراقية للأزياء تضيًف معرض كرمسن.. تجربة بصرية تلتقي فيها المعاني الكامنة خلف الألوان
العراقية للأزياء تضيًف معرض كرمسن.. تجربة بصرية تلتقي فيها المعاني الكامنة خلف الألوان
 حكاية علي بابا
حكاية علي بابا
