
سباق الصغار والبنية العميقة للعملية السياسية
محمد عبد الجبار الشبوط
تمهيد
جاء مصطلح «سباق الصغار» بوصفه الوصف الأكثر دقة للخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، حيث لم تظهر في المشهد أي كتلة كبيرة قادرة على قيادة الدولة أو تشكيل الحكومة من موقع قوة، بل تبيّن أن جميع القوى التي أعلنت «فوزها» تمتلك مقاعد محدودة لا تتجاوز العشرات، وأن أكبر كتلة لا تصل إلى ربع ما تحتاجه لتشكيل حكومة أغلبية، الأمر الذي يحوّل العملية السياسية برمتها إلى سباق محموم بين كيانات صغيرة تتنافس في الحجم، لا في المشروع، وتتبارى في عدد المقاعد، لا في القدرة على صنع الدولة.
لقد بدا واضحًا أن الساحة السياسية العراقية تعيش حالة «تذرر» غير مسبوقة: كل حزب يحصل على أربعة أو ستة أو ثمانية مقاعد يخرج إلى الإعلام محتفيًا بما حققه، وكأنه أمسك بمفاتيح القرار الوطني، بينما الحقيقة أن هذه الأعداد الهزيلة لا تستطيع — لا من حيث الحجم ولا من حيث الرؤية — أن تدير وزارة واحدة بصورة فعالة، فكيف بإدارة دولة معقّدة مثل العراق. وهكذا يتحول «النصر» عند هذه الكتل إلى مجرد رقم صغير يُضاف إلى رصيدها، لا إلى قدرة حقيقية على الإصلاح، لأن كل كتلة، مهما صغرت، تتعامل مع مقاعدها بوصفها إنجازًا وجوديًا يكفل لها البقاء، فتتشبث به وتتحصن داخله، بدل أن ترى نفسها جزءًا من مشروع وطني أكبر.
إن استخدام مصطلح «سباق الصغار» ليس وصفًا ساخرًا ولا حكمًا قيميًا، بل قراءة تحليلية لجوهر الأزمة السياسية؛ فحين تتراجع السياسة إلى مجرد منافسة بين كيانات صغيرة، يبحث كل منها عن عدد يكفي لمقعد وزاري أو منصب إداري، يغيب المشروع الوطني، وتضيع فكرة الدولة، ويتحول الحكم إلى عملية تجميع ميكانيكي لكتل لا يجمع بينها برنامج ولا رؤية. وفي مثل هذه البيئة لا يمكن أن تظهر أغلبية سياسية، ولا حكومة مستقرة، ولا معارضة مسؤولة، لأن الجميع يتحرك بمنطق «الحصة»، لا بمنطق «الواجب الوطني»، ويحتفل بالمقاعد القليلة وكأنها مفاتيح مستقبل العراق. وهكذا يصبح «سباق الصغار» العنوان الحقيقي لمرحلة كاملة، عنوانًا يكشف هشاشة البنية السياسية، ويشرح لماذا تتكرر الأزمات، ولماذا تبدو الحكومات ضعيفة، ولماذا يغيب الاتجاه العام للدولة؛ فحين تتقدم الكتل الصغيرة إلى الواجهة، يتراجع المشروع الوطني إلى الخلف، وتبقى البلاد عالقة بين مقاعد قليلة ورؤى أقل.
تفكيك ديمقراطية
وهذه المقدمة ليست إلا مفتاحًا لقراءة أعمق في المقالات اللاحقة، التي تشرح كيف يؤدي تفتت الكتل إلى إرباك مفهوم «الكتلة الأكبر»، وتفكيك الديمقراطية، وتعطيل الحكومة، ولماذا لا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا عبر الانتقال من سباق الأحجام الصغيرة إلى مشروع الدولة الحضارية الحديثة.
1
قراءة في دلالات تفتت الكتل البرلمانية وأثره على الديمقراطية العراقية
تكشف النتائج الأولية للانتخابات العراقية عن خريطة سياسية غير مسبوقة من حيث حجم التفكك وتعدد الكتل المتوسطة والصغيرة، إذ جاءت أكبر كتلة حاصلة على المقاعد بـ46 نائبًا فقط، تليها كتل بمقاعد تتراوح بين 29 و27 و28، ثم عدد كبير من القوى التي تتوزع بين 18 و4 مقاعد. وفي نظام برلماني يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على 165 مقعدًا (النصف زائد واحد من مجموع أعضاء مجلس النواب)، فإن أي كتلة لا تقترب حتى من ثلث هذا الرقم، الأمر الذي يجعل مفهوم «الكتلة الأكبر» ذاته يدخل مرحلة جديدة من الغموض والالتباس. إن أبرز ما تكشفه هذه الأرقام هو دخول الحياة البرلمانية العراقية في حالة «تفتيت تشريعي» واضح، بحيث لم تعد هناك قوة سياسية كبرى تستطيع الادعاء بأنها تمثل الاتجاه العام أو تمتلك القدرة على قيادة الدولة منفردة، بينما تتحول كل كتلة ـ مهما صغرت ـ إلى عنصر تفاوضي مؤثر في تشكيل الحكومات وإدامة توازناتها. وهذا التفتيت لا يعكس تنوعًا سياسيًا حقيقيًا بقدر ما يعكس ضعفًا بنيويًا في الحياة الحزبية، ويكرس حالة من عدم الاستقرار السياسي، لأن الحكومة القادمة ستقوم على ائتلافات عريضة ومتشظية، قابلة للتفكك عند أول خلاف حقيقي في السياسات أو المصالح. وفي ضوء هذه الخريطة، يتعرض مفهوم «الكتلة الأكبر» إلى تحوّل جوهري، فهي لم تعد كتلة انتخابية نابعة من صناديق الاقتراع، بل أصبحت «كتلة مفاوضات» تُصنع بعد الانتخابات عبر تحالفات متغيرة، ما يؤدي إلى إفراغ هذا المفهوم من مضمونه الديمقراطي ويحوّله إلى أداة تفاوضية بدل أن يكون انعكاسًا لإرادة الناخبين. ومن النتائج الطبيعية لهذا التفتيت أن تتحول العملية السياسية إلى «إدارة يومية» بدل «حكم استراتيجي»، حيث تُستنزف طاقة الدولة في موازنة المطالب المتناقضة لعدد كبير من القوى، فيما تضيع إمكانية تشكيل أغلبية سياسية واضحة تمتلك برنامجًا حكوميًا قابلًا للتنفيذ. وبالتالي، لا تنتج الديمقراطية هنا اتجاهًا للحكم أو مشروعًا وطنيًا، بل تنتج حالة دائمة من المقايضات، وتؤدي إلى حكومات ضعيفة، وائتلافات مرهقة، وقرارات مؤجلة. إن طبيعة الكتل الصغيرة والمتناثرة تكشف مرة أخرى أن العراق ما يزال يمارس «ديمقراطية العدد» لا «ديمقراطية الدولة»، وأن النظام السياسي يقوم على التوافق الاضطراري لا على الأغلبية السياسية الناضجة، فالتوافق هنا ليس خيارًا فلسفيًا كما في بعض التجارب العالمية، بل ضرورة مفروضة بحكم غياب الكتلة القائدة القادرة على الحسم. وبذلك نكون أمام «تعددية سلبية» تعكس تنافس الهويات والمكونات أكثر مما تعكس تنافس البرامج والرؤى، الأمر الذي يجعل إصلاح الدولة أو تحديثها من داخل هذا النظام مهمة شبه مستحيلة في ظل غياب الأغلبية المستقرة وافتقار المؤسسات السياسية إلى العمق الفكري والبرامجي. إن هذه النتائج، بكل ما تحمله من دلالات، تؤكد الحاجة إلى التحول من «ديمقراطية التمثيل المكوناتي» إلى «ديمقراطية الدولة»، ومن تعددية المكونات إلى تعددية البرامج، ومن الصراع الجزئي إلى المشروع الوطني الجامع، وهو ما يجعل الدعوة إلى «الدولة الحضارية الحديثة» ضرورة تاريخية تتجاوز حدود السياسة اليومية إلى إعادة بناء مفهوم الدولة ذاته على أساس القيم، والوعي، والهوية المشتركة.
ديمقراطية مفككة
بهذه القراءة، يتضح أن المشكلة ليست في الانتخابات ذاتها، بل في البنية العميقة للنظام السياسي، وفي غياب الإطار الحضاري الذي يمنح العملية الديمقراطية اتجاهًا وهدفًا ومضمونًا، وهو ما تحتاجه الديمقراطية العراقية لكي تتحول من ديمقراطية مفككة إلى ديمقراطية دولة فاعلة.
2
كيف يمكن أن تتشكل الحكومة من هذه الخريطة؟ وما هو المخرج العملي وفق نموذج الدولة الحضارية الحديثة؟
تكشف الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة عن واقع معقد يجعل تشكيل الحكومة مهمة شاقة تتطلب تجميع عدد كبير من الكتل الصغيرة والمتوسطة داخل ائتلاف واحد، وهو ائتلاف لا يقوم على الانسجام السياسي أو وحدة البرامج، بل يعتمد على المقايضة السياسية وتبادل المنافع وسدّ الاحتياجات العددية للحصول على الأغلبية، الأمر الذي يضع البلاد أمام احتمالات ثلاثة: فإما حكومة ائتلاف عريض يضم خمسًا إلى ثمان كتل مختلفة، وهي حكومة تولد ضعيفة لأن بقاءها رهن برضى كل كتلة صغيرة داخل هذا الائتلاف، أو حكومة توازنات يومية تعتمد على الصفقات القصيرة والقرارات الآنية من دون رؤية واضحة.
أو حكومة توافق اضطراري بين الكتل الأكبر حجمًا مع ضمّ قوى صغيرة لتأمين النصاب، وهي صيغة أقل هشاشة لكنها لا تتمتع برؤية موحدة أو مشروع واحد لأنها تجمع أطرافًا متباعدة في الأصل. وفي جميع هذه الاحتمالات، تبدو ملامح الحكومة المقبلة غير مستقرة لأنها تفتقر إلى «المركز السياسي» القادر على توجيه الدولة وتنظيم أداء السلطات وتحويل الانتخابات إلى فرصة لبناء نظام سياسي متماسك.
ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: ما الذي يمكن فعله للخروج من هذا الواقع؟ وما هو المقترح العملي الذي يقدمه نموذج الدولة الحضارية الحديثة لإعادة بناء الديمقراطية العراقية على أسس صلبة؟ إن هذا النموذج لا يكتفي بالتحليل بل يقدم مسارًا واقعيًا للتجاوز يقوم على ثلاث خطوات تأسيسية مترابطة: الخطوة الأولى هي الانتقال من «ديمقراطية العدد» إلى «ديمقراطية الدولة» عبر صناعة أغلبية سياسية واحدة تحمل مشروعًا واضحًا للحكم وتخوض الانتخابات كقوة سياسية منظمة لا كتحالف عابر للزعامات والمكونات، لأن الديمقراطية لا تستقر إلا إذا وجدت كتلة مركزية كبرى تنشأ من خلال البرامج والاتجاهات الفكرية لا من خلال الولاءات الاجتماعية الضيقة، فالانتخابات ينبغي أن تنتج مشروع دولة لا مجموعة أصوات متناثرة. أما الخطوة الثانية فهي إعادة بناء النظام الحزبي على أساس البرامج بدل الهويات عبر تشجيع الاندماج الحزبي الطوعي واعتماد قانون انتخابي يحدّ من التشتت ويمنح الأفضلية للكيانات الكبيرة القادرة على تقديم برامج واضحة، مثل اعتماد الدوائر الواسعة أو القائمة الوطنية، مما يؤدي بمرور الوقت إلى ظهور كتلتين أو ثلاث قوى رئيسية تستطيع تشكيل حكومة أغلبية ومعارضة دستورية مسؤولة. والخطوة الثالثة هي ترسيخ القيم الحضارية الاثنتي عشرة بوصفها الإطار المرجعي لبناء الدولة الحديثة، فهذه القيم ليست مفردات أخلاقية فحسب، بل هي البنية التحتية السلوكية التي تجعل الديمقراطية قابلة للحياة، لأنها تنتج المواطن الرشيد، والحزب البرامجي، والحكومة القادرة على اتخاذ القرار.
وهكذا يقدم نموذج الدولة الحضارية الحديثة مخرجًا عمليًا من حالة التفكك السياسي، لأنه لا يكتفي بترميم الهياكل القائمة، بل يعيد صياغة السؤال من أساسه: أي ديمقراطية نريد؟ وهل نريد نظامًا يعيد إنتاج التشتت والمقايضة، أم دولة ذات أغلبية سياسية واضحة تمتلك مشروعًا حضاريًا وتجعل الانتخابات وسيلة لبناء المستقبل لا لاستمرار الدوران في الحلقة ذاتها؟ إن الطريق المقترح هو التحول من تعددية المكونات إلى تعددية البرامج، ومن حكومة اتفاقات مؤقتة إلى حكومة أغلبية تستند إلى رؤية، ومن برلمان متشظٍ إلى برلمان يمثل اتجاهات واضحة، لتتحول الديمقراطية العراقية من ممارسة شكلية إلى أداة حقيقية لبناء دولة حضارية حديثة
٣
هل تستطيع الكتل السياسية الحالية تطبيق نموذج الدولة الحضارية الحديثة؟
تكشف الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة عن واقع شديد التعقيد يتمحور حول تفتت غير مسبوق للكتل البرلمانية، وتوزع المقاعد بين قوى صغيرة ومحدودة التأثير، لا تملك أي منها القدرة على تشكيل الحكومة منفردة أو حتى قيادة مشروع سياسي وطني واسع. وبينما تتنافس هذه القوى على مقاعد محدودة، يظهر سؤال جوهري: من هي الجهة القادرة فعليًا على تنفيذ مقترحات الدولة الحضارية الحديثة للخروج من المأزق السياسي؟ وهل تستطيع الكتل الحالية التحرر من شرنقاتها الحزبية والطائفية للدخول في أفق المشروع الوطني الجامع؟
إن نظرة دقيقة للواقع السياسي تكشف أن هذه الكتل، مهما تنوعت أسماؤها، ما تزال أسيرة أطرها القديمة، وأنها لا تمتلك الدافع البنيوي ولا الإرادة الفكرية للتحول نحو مشروع حضاري وطني، لأن هذا التحول يتطلب منها التخلي عن قواعد نفوذها القائمة على الولاءات الضيقة والانتماءات الفرعية والمصالح المحلية، وهي أمور ترى الكتل السياسية فيها أساس وجودها وشرط بقائها.
ولأجل مقاربة هذا المشهد بوضوح، لا بد من تقديم تعريفات دقيقة لأهم المفاهيم المتداولة في الخطاب السياسي العراقي عند الحديث عن تشكيل الحكومات:
أولًا: تعريف المصطلحات
1. الكتلة الأكبر:
هي الكتلة البرلمانية التي تمتلك العدد الأعلى من المقاعد فور إعلان النتائج (١٦٥ مقعدا فما فوق) أو تلك التي تتشكل لاحقًا عبر تحالفات متعددة لتصبح صاحبة الحق الدستوري في ترشيح رئيس الوزراء. وفي العراق تتحول «الكتلة الأكبر» إلى كتلة تفاوضية تُصنع بعد الانتخابات، لا كتلة انتخابية تعبر عن إرادة الناخبين.
2. الكتلة الكبيرة:
هي كتلة تمتلك ما بين 40 إلى 60 مقعدًا، لكنها تبقى أقل بكثير من الأغلبية البالغة 165، وبالتالي لا تمتلك القدرة على الحسم، لكنها تُعدّ ركيزة لأي ائتلاف حكومي، وتمتلك وزنًا تفاوضيًا مهمًا.
3. الكتلة المتوسطة:
تتراوح عادة بين 15 و30 مقعدًا، وتمثل شريحة واسعة من الكتل العراقية. وهي كتل لا تمتلك القدرة على تشكيل الحكومة ولا على إسقاطها منفردة، لكنها قادرة على ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك، وتمارس تأثيرًا يتجاوز حجمها الانتخابي.
4. الكتلة الصغيرة:
تملك ما بين 5 و14 مقعدًا، وهي كتل غالبًا ما تقوم على زعامات محلية أو هويات فرعية، وتدخل في الائتلافات بوصفها «مكمِّل عدد» أكثر مما تدخل بوصفها «شريك رؤية». وتعدّ هذه الكتل جزءًا أساسيًا من ظاهرة التفتت السياسي.
5. الكتلة المجهرية التي لا تُرى بالعين المجرّدة:
هي الكتلة التي يحصل تمثيلها على 1–4 مقاعد فقط، وغالبًا ما تكون تشكيلات شخصية أو مناطقية أو انتخابية طارئة، لا تمتلك وزنًا سياسيًا واضحًا، لكن وجودها يفاقم التشتت ويشتت الأصوات ويعقّد مهمة تشكيل الحكومة؛ فهي كتلة صغيرة جدًا لكنها مزعجة جدًا في الحسابات السياسية.
ثانيًا: لماذا تعجز هذه الكتل عن تطبيق مشروع الدولة الحضارية الحديثة؟
يكمن جوهر المشكلة في أن نموذج الدولة الحضارية الحديثة يقوم على الاندماج والإرادة الجامعة والهوية الوطنية والمشروع البرامجي، بينما تقوم الكتل العراقية — من أكبرها إلى مجهرية الحجم — على التشظي والهوية الفئوية والمنفعة الآنية.
لذلك توجد أربعة أسباب تجعل هذه الكتل عاجزة بنيويًا عن قيادة التحول:
1. لأنها نتاج الانقسام وليست ضحيته فقط
الكتل العراقية ليست جزءًا من الحل، بل هي التعبير السياسي الواضح عن طبيعة المجتمع المنقسم، فهي تستمد قوتها من الطائفة والمنطقة والعشيرة والرمز المحلي، وبالتالي فإن دعوتها للاندماج ضمن مشروع وطني جامع يعني مطالبتها بالتخلي عن أساس وجودها.
2. لأن مكاسبها الصغيرة أهم عندها من المشاريع الكبيرة
الكتلة التي تحصل على 4 أو 6 مقاعد تعتبر نفسها منتصرة، وتجد في هذا العدد المحدود رمزًا لقوتها واستمرارها، ولذلك تتمسك به بشدة، لأنها تدرك أن الاندماج داخل مشروع وطني واسع سيذيب وجودها السياسي، ويجردها من نفوذها.
3. لأن خطابها السياسي لا يحمل برنامج دولة بل برنامج جماعة
الخطاب السياسي للكتل العراقية يقوم — في الغالب — على الهوية لا على البرامج، وعلى تمثيل الفئات لا على بناء الدولة، وعلى رد الفعل لا على التخطيط، وهذا بطبيعته يناقض نموذج الدولة الحضارية الحديثة القائم على البرنامج والفلسفة والقيم.
4. لأن إرادة المجتمع لا تضغط عليها بالاتجاه الصحيح بعد
القوى السياسية لا تتغير من تلقاء نفسها، بل تتغير تحت ضغط المجتمع، والمعادلة السياسية الحالية ما تزال قائمة على الولاء لا على الوعي، وعلى الثقة بالرموز لا بالبرامج، ما يمنح هذه الكتل شعورًا بأنها ليست مضطرة للتغيير.
ثالثًا: من يطبّق إذن مشروع الدولة الحضارية الحديثة؟
إن نموذج الدولة الحضارية الحديثة لا يراهن على أن الكتل الحالية ستتبناه، بل يراهن على شيء أعمق وأكثر ثباتًا: تحول وعي المجتمع العراقي نفسه.
وتطبيقه سيكون عبر ثلاثة مسارات:
1. نشوء كتلة وطنية جديدة تنتمي للمستقبل لا للماضي
كتلة تحمل برنامج الدولة الحضارية منذ البداية، وتُبنى على قيم الاندماج والمواطنة، وتخوض الانتخابات بروح المشروع لا بروح الهوية.
2. تراكم الوعي المجتمعي باتجاه المشروع الوطني الحضاري
حين يدرك الناخبون أن الدولة لا تُبنى عبر الكتل المجهرية، ولا عبر الهويات الطائفية، بل عبر مشروع وطني متكامل، عندها فقط تتغير قواعد اللعبة السياسية.
3. ضغط الرأي العام لصناعة أغلبية سياسية وطنية
فالمجتمع هو الذي يجبر الأحزاب على الاندماج، وعلى التحول من التشتت إلى التجمع، ومن الفئوية إلى الوطنية، ومن الصراع على المواقع إلى العمل على بناء الدولة.
الخلاصة
إن الكتل السياسية الحالية — على اختلاف أحجامها: كبيرة، متوسطة، صغيرة، مجهرية — غير قادرة على تطبيق نموذج الدولة الحضارية الحديثة لأنها جزء من المشكلة، لا جزء من الحل.
والمشروع الحضاري لا ينتظر منها أن تتغير، بل ينتظر أن يتغير المجتمع نفسه، لأن التغيير السياسي الحقيقي يأتي دائمًا من وعي الناس لا من إرادة النخب.
وحين ينضج هذا الوعي، ستولد في العراق كتلة سياسية وطنية جديدة، تحمل مشروع الدولة الحضارية الحديثة، وتحوّل الديمقراطية من لعبة مقاعد إلى مشروع دولة.
#الدولة_الحضارية_الحديثة


 بين المرونة السياسية والجمود
بين المرونة السياسية والجمود
 ما أريد برشلوني ينتخبني.. مرشّحة مدريدية تودّع السباق الإنتخابي
ما أريد برشلوني ينتخبني.. مرشّحة مدريدية تودّع السباق الإنتخابي
 وزير الصدر ينشر عتباً على الكربلائي ويذكّره بالدولة العميقة
وزير الصدر ينشر عتباً على الكربلائي ويذكّره بالدولة العميقة
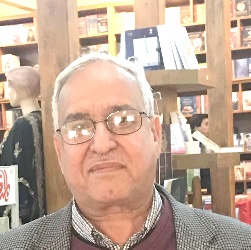 الركض إلى عبادان… سباق الدراهم الذي لا ينتهي!
الركض إلى عبادان… سباق الدراهم الذي لا ينتهي!
 الإعلام النفسي.. سلاح خفي في سباق الانتخابات
الإعلام النفسي.. سلاح خفي في سباق الانتخابات
 النسوية السياسية المحمية
النسوية السياسية المحمية
 خبراء: إتساع الفساد وتبديد أموال الدولة يدخل سباق الإنتخابات
خبراء: إتساع الفساد وتبديد أموال الدولة يدخل سباق الإنتخابات
 إعادة عرب للسباق تثير الجدل بعد مطالبته بإستبعاد السوداني
إعادة عرب للسباق تثير الجدل بعد مطالبته بإستبعاد السوداني
