

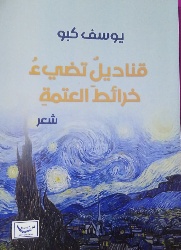

كبو يحتفي بإصدار مجموعته قناديل تضيء خرائط العتمة
بالشعر يلخص حياة الانبياء وأساطير الفلسفة والفن
امجاد ناصر - اربيل
ليس من السهل ان ينجز الشاعر ديوانه الذي يعبرعن افكاره و خلجاته و ما يريد ان يبوح به من رسالة بغض النظر كان شعرا عاطفيا او وطنيا , فكيف اذا كان الديوان مكرس لحياة الانبياء و العظماء وأساطير الفلسفة والفن من الخوالد اصحاب المنجزات التي ما زالت راسخة في عقول البشرية منذ نزول سيدنا ادم و حواء الى الارض امتدادا للملك كلكامش و النبي نوح و المسيح عليهما السلام , و سقراط و افلاطون و فرويد وانشتاين و اديسون و نيوتن , تنقل الشاعر بين قدسية المرسلين من الله عز وجل الى المفكرين و الفلاسفة و اصحاب النظريات و الابتكارات التي غيرت حياة البشرية من العتمة الى النور , و لم ينسى الحب و العشق و الجمال لفاتنة السينما مالرين مونور , وعبقري الكوميديا الصامتة شارلي شابلن و كبار الشعراء المتنبي و امرؤ القيس و مظفر النواب و ليلى العامرية و بصمات الرسامين دافنشي و فان كوخ و اصحاب السمفونيات بيتهوفن و باخ و صوت نسيم الصباح و الحب السيدة فيروز، و القائمة تطول الى 78 قنديلا اختارهم الشاعر يوسف كبو في مجموعته الشعرية ( قناديل تضيء خرائط العتمة ) الصادر عن دار أمل الجديدة , والذي احتفى بتوقيعه على قاعة المركز الأكاديمي الإجتماعي عنكاوا / أربيل ، بالتعاون مع أتحاد الأدباء و الكتاب السريان .
بدأت الأحتفالية بكلمة ترحيب للأديب روند بولص رئيس الأدباء و الكتاب السريان , لضيوف الأمسية من الادباء و الاكادميين و الاعلاميين , و رئيس مكتب الثقافة والدراسات في الأمانة العامة للمنظمة الأثورية الديمقراطية (مطكستا) بشير أسحاق سعدي , من مدينة قامشلي سوريا , ثم ادارة الجلسة الأعلامي والشاعر حسن عبدالحميد قائلا : قناديلٌ الشاعر يوسف كبو وهي تضيءُ خرائطَ العتمةِ , من العنوان يثير القارئ لمتعة الاطلاع على النصوص النثرية الغنية بمضامنيها و افكراها وطبيعة رموزها الذين اختارهم الشاعر من عباقرة المفكرين و كبار الرسامين و الموسيقين و الفنانيين و الشعراء فضلا الى الانبياء ليسلط عليهم بكل براعة بأسلوبه الشعري و هذا ما يدل على ثقافته و اطلاعة ودراسته لهذه الشخصيات بكل دقة و تفاصيل بما حملته تلك القامات التي أضائت طريق البشرية , وحتى لوحة الغلاف ليلة النجوم للفنان فان كوخ اختيار مميز .
سايكولوجية الشعر
قراءة سايكولوجية
كما قدم الدكتور قاسم حسين صالح مؤسس و رئيس الجمعية النفسية العراقية , قراءة سايكولوجية لديوان يوسف كبو مشيرا : تنوع الشاعر بقناديله التي تضمن 78 قنديلا بين الفلسفة ، الدين ، الموسيقى ، الشعر، الادب ، الرقص ، العلم , فمنهم من الاسماء التي نعرفها جيدا و اخرون لم نسمع بهم ولكن الشاعر عرفنا عليهم مشكورا , من ضمنهم (رينيه شار) شاعر وكاتب فرنسي (يسنين) شاعر روسي صعلوك (هايدن) موسيقار نمساوي وآخرين , و نحن نتحدث عن سايكولوجية الشعر و بالمناسبة لم يحضى الشعر العراقي و العربي بدراسة سايكولوجية و اول كتاب يصدر عن الشعر سايكولوجيا اصدرة الاتحاد العام للادباء و الكتاب في العراق في سايكولوجيا الشعر و الشاعر , و في مهرجان المربد القيت محاضرة بهذا الخصوص بعنوان الشعر و الشاعر و المتلقي من منظور التحليل النفسي , و المقصود بسايكولوجيا الشعر هناك من يرى ان الشعر لا يكتب الا عند حالة من التوحد او التشبع بروح ما , تقوم على الاحساس بالقدرة و الامتلاك والسيطرة على الانفعال او العاطفة أو مثير او دافع , وهناك من يقول ان الشعر يتخذ موقفا واحدا من الحياة , اما يكون منطلقا في رحابها كالشمس او يكون منطويا على نفسه فهو اما متفائل فرح او يكون متشائم مفعم قلبه بالحسرة و الحزن , او يكون حكيما يحكم بعقل يتمتع بعقل سليم و بصيرة قوية واما عاطفي يتعامل مع الحياة بشعور واحساس فنان و شاعر , و هذا ما ينطبق على المحتفى به بهذه الجلسة و أشير عنه بجملة ( ان العراق موعود بشاعر اسمه يوسف كبو, سيكون استثناءا عراقيا وعربيا ايضا .
ذخيرة معرفية
كما اشار المحتفى به الشاعر يوسف كبو : منذ بدايتي كنت أقرأ الأدب العالمي وحياة وكتابات الفلاسفة و الشعراء و اصبح لدي تراكم و ذخيرة معرفية كبيرة وهذا ما ظل يراودني للكتابة عنهم بالشعر و بذلت جهد طويل و بحث عميق عن كل شخصية تناولتها بالجموعة حتى نضجت الفكرة لدي و قمت بالكتابة لمدة خمسة سنوات لانجز هذه المجموعة الرابعة , و لدي ثلاثة مجموعات ستصدر قريبا , و الرسالة مبطنة كشاعر كوني دائما بحالة قلق أمام العالم بانه يقوم بأصلاح اضطراب هذا العالم و بين يجد عالم بديل و بهذا القلق كتبت هذه المجموعة و ما زال هذا الهاجس و القلق العميق يراودني .
مضيفا : اللغة خطرة ؟ بأستطاعتك تضع اللغة في خطر و ممكن ان تفتح مجازات هائلة على الاشياء , و اصدرت ديواني باللغة العربية لاني متمكن باللغة و لو اخترت لغتي السريانية لتعرضت الى اخفاق شديد بالرغم من محاولتي .
و تخللت الجلسة التي أدارها المهندس عماد متي توما المدير الاداري للمركز الاكاديمي , العزف على آلة الطنبورة للعازف باسم فرنسيس ومداخلات و مشاركات للحضور ومنهم الدكتور رمزي روفائيل رئيس جمعية حدياب للكفاءات , و الناقد طالب زعيان و الشاعرة فالنتينا يوآرش و الدكتور بالبارسكولجيا رفيق حنا , و فائزة ذياب نائب رئيس الجمعية الثقافية المندائية .
البُعد الفلسفي للصورة
جاسم عاصي
يبدو أن للصورة علاقة متينة بالتاريخ ، بسبب علاقتها بالذاكرة . والذاكرة ذات صلة بالزمان والمكان ، وهما من مقومات التاريخ وسداه ولحمته . من هذا يمكننا التعامل مع هذا الفن من باب الأرخنة والتوثيق .
وهذا التوثيق بطبيعة الحال يتخذ له مجالا ً فنيا ً ، تدخل فيه أحيانا ً التقنية المباشرة ، لتصوغ نسقه الجمالي ، في استكمال الدلالات التي تنوجد من أجلها الصورة أساسا ً ، بمعنى أن تكون لها رسالة شأنها شأن الأجناس الثقافية والمعرفية الأخرى ، فالعين بطبيعة الحال تنظر بما هو مرئي أو مُشاهـَد ، لكنها تـُقيم عاقة جدلية مع الأشياء الموجودة ، حد اتخاذها رموز لها ، تبين من خلالها بناها الأساسية المتمركزة في اللامرئي ، أو غير المنظور ، الذي تؤشره وتكشف عنه الرموز والعلامات ــ سيميائيات الصورة ــ .
هذه العلامات التي يتعامل معها الفنان توافقا ً مع جوّانياته ، أو بناه التحتانية غير المرئية ، وغير المحسوسة .
وهي من قبيل قطعة الثلج المغمورة . كل هذه الحراكات تستكمل الرؤية الفلسفية لفحص الظواهر التي تعنى بها الصورة .
أي أنها تتداخل مع مكوناتها المرئية وغير المرئية . فإذا كانت الأولى مكشوفة للعين ، فإنها تؤشر إلى الثانية عبر علاماتها ، والثانية تستلم مكوناتها من الذهن الذي يمتلك قدرة صياغة التكامل للدلالة التي تنتهجها للصور كاملة .
إن ما تـُقيمه الصورة ، لهو الدأب على إقامة هذه العلاقة الجدلية ، بين المنظور واللامنظور ، وبالتالي تقيم علاقة بوسيلة الحوار الذي يقود هو الآخر إلى بنية فلسفية ، قوامها طبيعة النظرات الفاحصة للمشهد في الصورة ، والبحث عن مكوناته ، وخفاياه ، وما تدل بنيته الظاهرة ،عن بنيته العميقة غير المنظورة .
من هذا نرى أن هذه العلاقة ، غير محددة بما هو ملزِم بحيثيات التوثيق ، إنما يخضع الفنان إلى التوفر على ما يجده أكثر قدرة على التعبير والتأثير . فالصورة لدى الفنان الناظر إلى الفوتو باعتباره نصا ً ، يعطي لفنه قدرة العمل على مستويات متعددة ، سواء في نظرة الفنان كرائي للمشهد ، أو نظرة الرائي للصورة كناتج إبداعي يتوجب قراءته على وفق مستويات تخضع إلى البعد المعرفي التحليلي لما تظمره جدلية الصورة برؤية المستقبِل .
إن نظرة ( ميرلو ــ بونتي ) لفن الصورة أعطى وظيفة جديدة لها ، وذلك من اعتبارها وظيفة ( إبلاغ ، تمثيل ، مفاجأة ، تدليل ، إثارة الرغبة ) . هذه مجتمعة تـُلزِم الفنان بشروط مرنة ، وليس العمل على وفق أيقونات ذات اعتبارات مقدسة . فـ (ميرلوبو ــ نتيّ ) إنما يحفز الفنان على النظر إلى الاهتمام بوظيفته ، وما ينبغي عليه في مجال التفكير في وظائف أخرى لعمله تستدعيه المتغيرات والكشوفات المعرفية التي تقود إلى اتساع الرؤى، الناتجة عن التجربة والعمل في هذا الحقل .
من هذا نجد أن الفنان صاحب مشروع نظري يعين كاميرته على إنتاج له مكانة ومميزات في التعبير والكشف ، وإن لم يبح بذلك مباشرة . فقط ترشح لوحاته مثل هذه الشذرات النظرية التي تنطوي على بنى معرفية ــ ثقافية للتصويرــ مجموعة الرؤى ــ ، أو لنقل الرؤى التي أكدها ( ميرلو ــ بونتي ّ ) منطلقا ً من الجسد ، ومبتدئا ّ باليد المستعينة بالعين المجردة للمصوّر وانسحاب هذا إلى مجمل مكونات الجسد البشري .
إن الفنان بهذه الرؤية ؛ إنما يصوّر جسده ، لكنه لا يقع في وهم المشابهة أو المفارقة . وهي عودة إلى أسطورة ( نرسيس ) حين وجد وجهه على سطح الماء لأول مرة ، فأوهمته الرؤية على أنه الآخر ، وليس ذاته . هذا الفزع ، يكون ملازما ً للفنان ، ويتحقق حين يكون الفنان رائيا ً من بعد أن كان منتجا ً للصورة .
فهو ذو رؤيتين ، رؤية ما قبل وأخرى ما بعد . لحظتها تكون له قراءة تصطف مع قراءة الرائيين الآخرين ، وتفترق عن نظرتهم في الخصائص الذاتية للقراءة . من هذا يكون فن التصوير هو الفلسفة التي تتناول العالم بأسلوب الفنان الخاص ، والمصوّر وحده الذي يدرك العالم ويجعلنا ندرك العالم ( العين والعقل ص7).
من هذا نرى أن الفنان ( كفاح الأمين ) ينطلق في صورته من فهم فلسفي ، خاضع لجدلية الوجود . وهذه النظرة محددة بحرية امتلاك الحركة في كلا الطرفين ، المصوّر والرائي . فالفنان وهو ينتج الصورة ، يعتمد أولا ً على رؤى مسبقة . وهي في مجملها رؤى فلسفية ، ترشحها ثقافته . أي أنه يأتي المشهد من باب نظرته للحياة .
لذا يكون ثانيا ً رصده إلى العوامل التي تؤثر سلبا ً على أسس الحياة ، وصفاء ديمومتها . ولعل التخريب الذي تُسقطه الحروب واحد من مركزيات صور الفنان ( الأمين ) فهو ينظر من خلال استخدام جسده متمثلا ً في ــ العين واليد والذاكرة المعرفية ــ ومن التجربة التي خاضها مع جمع الأقران في ظروف صعبة ( ينظر من أجل هذا إلى البوركَرام الذي حرره الفنان عن عمله في فصائل الأنصار في كردستان العراق ) لكي يقف على أهم ركيزة يعمل من أجلها الفنان .
كذلك يقف على ما تشكله الآلة ــ الكاميرا ــ في حقل رؤاه الفنية وما هي سوى وسيط ، ينظّم مثل هذه التوافقات الرؤيوية ، لكنه وسيط ذكي ، يرتبط مباشرة بالعقل . يقابل هذا ما يحدثه الرائي المُستقبِل للصورة ، فهو الآخر ينطلق من وعي ذاتي ، محفوف بمعرفة خاصة ، تعينه على كشف عما هو خارج المُشاهَد ، معتمدا ً على فرضية معرفية ؛ كون المنتج ينطوي على مضمر لابد من البحث عنه . مثله مثل المنقب الآثاري الذي يُخضع أداته في التنقيب إلى الفرضية المعرفية . فالذاتين ــ ذات المصوّر وذات الرائي ــ غير منفصلتين تماما ً ، بل كلاهما يحاور الآخر ، لأن كلاهما يخضع لجدل المعرفة والفهم لوظيفة الصورة ، وطبيعة عين المصوّر وعين الكاميرا .
وبهذا تتسع الرؤية الناظرة إلى المستقِل. أي أن الناظر ــ الرائي ــ يفحص نتاج المصوّر برؤى جديدة ومكتملة الآلية المعرفية . فنحن أمام حركتين نشطتين ، حركة جسد الفنان ، وحركة جسد الرائي . وكلاهما يتفاعل مع الآخر عبر الصورة المرئية . فـ ( الأمين ) يحاول وهو يراقب المشهد ، تسليط الضوء على مكوناته ، فقد اختاره من منطلق حساسيته إزاء الأشياء ومكونات الوجود , وفهمه لجدليته . فهو لا ينظر إلى الظاهرة التي تتبناها الصورة ، من منطلق اجتماعي فحسب ، بل من كونها فعلا ً كونيا ً له محمولاته ودلالاته ، لاسيّما غياب الإنسان في أغلب صوره . وإن وجد فهو يعكس حالة التغييب ــ المطرود من مكانه ــ حسب رؤية الباحث ( ناجح المعموري )، مع احتساب ما يعبّر عنه ، في ما يخص الأثر والتأثير ، كونه ــ أي محتوى الصورة ــ هو نتاج حركة المجتمع سلبا ً أو إيجابا ً ، وإنها نـُخضع ذلك إلى وعي المركز في عين الكاميرا بعد أن يتمخض في حقل عينه الفاحصة المجردة في النظر إلى المشهد . ولديه في عين كاميرته بعدا ً آخر مضاف إلى ما تراه عينه ، لأنه على يقين من كونه بإزاء الاستعانة بعين ثانية تمتلك تقنية وحساسية ذاتية ، تتمثل في التقنية من جهة ، وما خلقته عينه التي لها علاقة بالعقل من جهة أخرى. فنحن أمام حساسيتين ، الأولى حساسية عين المصوّر ، والثاني حساسية عين الكاميرا ــ عدسة الكاميرا ــ إن عين الكاميرا بطبيعة الحال تخضع لرؤية عين ( الأمين ) لكنها لا تتعامل مع ذلك من باب الأمر وتنفيذه ، بقدر ما هو نوع من الحوار المعرفي بين قطبين حيويين . هذا ما هو ظاهر من الوظيفة ، وواضح في المعطى من الفن .
في الفعل ورد الفعل ، لكن في حقيقة الرؤى ، تكون عين الكاميرا محفـّز للتخييل ، وتـتسقط ما هو مضمر ، أو الكشف عن المسكوت عنه في المشهد ، وذلك بالاستعانة بما هو مُشاهّدْ . أي كشف المضمر ، ليكون ظاهرا ً ومعبرا ً عن فعاليات كبيرة مضمرة في المغمور من الحركة في الصورة . وهذا ما نعنيه الجدلية الفلسفية في نتاج ( الأمين ) من الصور، فهي لا تقبل السكون لعالمها ، بل تنتهج الحركة والنماء من خلال ما تنتجه العين من علامات ، تكون شفيع الرائي في القراءة والمشاهدة بما تتركه من أثر يصوغ رؤى الرائي وتفعّل نظرته الفاحصة للصورة ، بحيث لا تمر رموزها واستعمالاتها عن مجال جدلية رؤيته المشاهِدة اعتباطا ً، بقدر ما تـُشكـّل علامة لوقفة فحص في مجال دراسة الصورة . إذ نرى أن عملية التفاعل بين عين المصوّر وعين الكاميرا ، ماهي إلا عملية إيقاظ لما هو كامن في الذات الإنسانية ، وكشف المفارقات عبر تلك السيمياء التي تتوزع وتواكب حيوية عناصر الصورة ، النابعة من ذات ناقدة ، تنظر لتنتج ، لا تنظر من أجل المتعة والتطلع فحسب .
إن إنسان ( الأمين ) في لوحاته ما هو إلا نتاج بيئة اجتماعية وسياسية ، عملت عبر الأزمنة والأمكنة على أن تضع ذات الآخر ضمن حقل التهميش ، الإنسان الذي يدور في فلك الفراغ والاحباط ، وتراكم البؤس الموروث . إنه مقتول الإرادة ، وهو ينظر إلى المكان الذي لحقه الخراب مثلا ً جرّاء الحروب ، أو جرّاء العمليات إلإرهابية . لذا نتوقف على وجود النموذج الإنساني من هذا الخراب ، وهذا البؤس ، والإرادة المسلوبة المتحكمة بالإنسان . فلوحات الفنان تستعيد الذاكرة للإنسان لما افتقده من أسس أسرية واجتماعية من جرّاء الفعل السياسي والاجتماعي . من هذا نرى إن صوره ما هي إلا نصوص تـُعطي ما هو مرئي ومعايَن ، وتـُحيل إلى ما هو خارج وضمن الكادر من ثراء في الرؤى المبنية عليها اللقطة ــ المشهد ــ . بمعنى يكون منطلقه من مثابة التعبير المباشر للوصول إلى ما هو أعمق منه . أما ضمن سياق العمل من أجزاء ، فهي ما تستكمل بها الصورة وجودها . كل ذلك يحدث بفعل الجدلية التي تـُقيمها الصورة ، لأسباب كامنة فيها ، ومتحركة ضمن ذهنية الرائي ، الذي يأخذ المحتوى مأخذ الفعل المخلـّق في التعبير ,. الصورة كما نراها عند ( الأمين ) عبارة عن كون مستمر الحركة ، وإن بدا ساكنا ً للوهلة الأولى أو الذي توجده الصورة بالمفهوم العام لها ، وليس بمفهوم القراءة الفاحصة. إن العلامات التي تتركها عين الفنان وعين الكاميرا في المـُنتـَج ، هو الذي يشي بمحمولات علاماتية ينبغي فحصها ليس بمعزل عن المكونات الأخرى في الكادر ، وإنما تحريك الساكن المفترض ، ودمجه مع المتحرك الذهني جرّاء الفحص . إن دائرة الفحص ، تتشكل من عناصر متآزرة ، لا تنفصل عن المصدر المنتج ــ العين ــ وذلك لا يعني أننا نتعامل معه بصورة مباشرة ، بقدر ما نعطي لكل فعل شارك في انتاج الصورة دوره . ولعل فعل التماثل مع الموجودات المتوفرة لعين المصوّر ، وتلك التي تتحفز بمعزل عن عينه ، لابد من أخذها بنظر الاعتبار . إن كل مقتربات الصورة ومقوماتها وسبل انتاجها تتظافر في عين المصوّر، وعين الرائي مع اختلاف الأزمنة والأمكنة .
يبقى الإنسان الذي هو رمز كل هذه الأفعال والبنى الفنية والموضوعية في لوحات ( الأمين ) الذي يلعب الوجود والعدم دوره في حضوره وغيابه في الصوّر . إنه حاضر غائب كما ذكرنا . وحضوره يكون من خلال شهادته على خراب المكان وإهماله ، ثم غيابه الحاضر أيضا ً ناتج عن الأثر الذي يتركه تبعثر مكونات المكان ، ونعني بها أثر الأشياء التي هي من آثار الإنسان المطرود من مكانه . والطرد كما نراه يخضع إلى منبع فلسفي ، وإن تكلل بفعل التدمير العام ، إلا أن سلب الحرية مثلا ً عند ( سارتر ) لا تعني الفرد لوحده ، وإنما تعني الفرد من المجموعة الإنسانية المستلبة الإرادة والحرية . فالفرد هنا مطرود من بين جمع المطرودين على صعيد الفعل السياسي والاجتماعي والثقافي . ولعل الطرد الأهم ، هو تخريب المكان الذي يماثل عش الطائر على حد تحليلات ( باشلار ) . من هذا نجد أن المطرود عند ( الأمين ) يكون من مكانه ومن حقل معارفه أيضا ً . أي تخريب بنيته المعرفية ، لكي يتمكن المخرّب الهيمنة على وجوده في الزمن ، فالتهميش الاجتماعي طرد ، والعزل السياسي طرد ، وتخريب المكان بفعل الحرب طرد ٌ أيضا ً . فالإنسان العراقي مثلا ً واصل الطرد والإبعاد والتهجير والقمع عبر الأزمنة الطويلة المنصرمة ، وما زال يعاني منه ولكن بأساليب مختلفة . كل هذا وجد الفنان ( الأمين ) في ما يراه معابر في معبر مركزي واحد هو الطرد ، وهو مفهوم فلسفي في نظرنا ، لأنه يتعامل بأكثر من ذراع ، ولعل الطرد المعرفي ــ الثقافي ــ واحد من أهم مسببات الطرد ، لأنه يتعلق بالحرية ، الحرية التي تنتج كل جماليات الوجود ، لأنها توفر لغة تقرّب الإنسان من بر الأمان ، وتوفر له مساحة لبناء نفسه والمشاركة في بناء العالم من حوله . إن إنسان الفنان هنا ؛ هو ليس فردا ً منعزلا ً عن وجوده ، بل مطرودا ً منه . وأجد أن تعبير ( المعموري ) ينطوي على بلاغة في اجتراح المصطلح . بمعنى مبتعد قسرا ً بفعل العوامل المؤدية إلى مثل هذا العزل المتعَمـَـدْ ، الذي اختار المتَعمِدْ وسائل مختلفة وأسباب متعددة اختلقها للمباشرة بمشروعه التدميري هذا ، إلا أنها تصب في مركز واحد ، هو سلب الإرادة الفردية ، وبالتالي من مجموع الأفراد بما تنتج حالة مصادرة للإرادة الجمعية . وهذا ما نراه في والواقع العراقي منذ عام 2003 . إنه مصادرة متلاحقة ، وأفعال سلبية متراكمة ، تتعدد مصادرها ، إلا أنها ذات مصدر واحد يشكـّل المركزي في خلق بنيات متعددة تـُعطي نتائج متقاربة ، تتركز في تغييب الإنسان . فالاحتلال مثلا ً وهو مركز انتاج تلك البنيات مصاغ ومزوق بألوان متعددة ، لعل الحرية والديمقراطية المعطاة أبرزها وأساسها ، الحرية التي تمنحك مفهوما ً عائما ً ، وتقيـّدك بأفعال أخرى ، لعل تخريب المكان ومحو الذاكرة المركز الذ ي يشتغل عليه المحرك هذا . فبعد أن كانت الحرية تؤخذ ، أصبحت تـُعطى وتـُمنح من بين مجموع المِنـَح المعطاة للشعوب . فكيف يكون شكل المترشحات من هذا العطاء ، وعلى سبيل المثال ( الديمقراطية ) . هذا المركز ما تلاحقه صورة الفنان ( كفاح الأمين ) . فهي تحاكي الخراب المرسوم عل مقاسات المفاهيم الوهمية والمُظلِلَة والخالقة لكون ووجود وهمي ، ينكفئ باستمرار، ولا يمنح سوى الخراب الناتج من الحراك اليومي الذي ترصده عين كاميرة الفنان .


 مهرجان كتارا لآلة العود يحتفي بالقصبجي
مهرجان كتارا لآلة العود يحتفي بالقصبجي
 نساء لوركا يحتفين بالزيدي
نساء لوركا يحتفين بالزيدي
 فيكتوريا وديفيد بيكهام يحتفيان بنهاية عام وقدوم آخر
فيكتوريا وديفيد بيكهام يحتفيان بنهاية عام وقدوم آخر
 المركز الثقافي البغدادي يحتفي بإفتتاح مكتبة سالم الآلوسي
المركز الثقافي البغدادي يحتفي بإفتتاح مكتبة سالم الآلوسي
 برلمان الطفل يحتفي بيوم المثقف العراقي و يطالب بمقر له
برلمان الطفل يحتفي بيوم المثقف العراقي و يطالب بمقر له
 العلمين يحتفي بتخرّج الدفعة الرابعة بحضور أكاديمي بارز
العلمين يحتفي بتخرّج الدفعة الرابعة بحضور أكاديمي بارز
 العراق يفوز على عُمان ويقفز للمركز الثاني في مجموعته
العراق يفوز على عُمان ويقفز للمركز الثاني في مجموعته
 مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45 يحتفي بالسينما الفلسطينية
مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45 يحتفي بالسينما الفلسطينية
