
الوجه الآخر للحرب
محمد زكي ابراهيم
لم أكن في يوم من الأيام من هواة الحرب، ولا داعية من دعاة العنف، فالسلام في نظري يعني الحياة والحرية. وهو حاجة إنسانية لا غنى عنها، رغم أننا لم نذق طعمه لسنوات طوال، ولم نتفيأ ظلاله لوقت غير يسير، وكان ذلك كافياً ليقنعنا بعدمية الحروب، وكراهة القتال، ونبذ العدوان.
وكنت كغيري من العرب أعتقد أن البلدان التي تنأى بنفسها عن الحرب، ويخلد أبناؤها للدعة، تنصرف للبناء والعمران، ويجد الناس فيها الفرصة للتقدم، وأرى أن إنفاق الأموال على شراء الأسلحة، وإعمار ما خلفته المعارك، وتعويض ما خسرته البلاد من فرص، هي مجتمعة السبب في ما وصلنا إليه من تخلف.
لكني أنعمت النظر في البلدان التي حظيت بمثل هذا السلام، فلم أجد فيها بلداً متقدماً، ذا حول وطول، ولم أقع على شعب منها يتقلب في الغنى والثراء، فهي جميعاً – تقريباً – دول فقيرة، أو متخلفة، أو غير ذات شأن!.
أي أن السلام لم يكن على الدوام أداة من أدوات التنمية، أو وسيلة من وسائل المدنية، إذا ما رافقه خنوع أو استسلام، أو قلة تبصر وحكمة، أو حدث عن تهاون وتوان.
هذه المفارقة جعلتني أعيد النظر بما كنت أسلم به، وأظنه حقيقة دامغة، وزاد من شكي هذا أن الدول التي خاضت حروباً (عالمية) طاحنة في القرن الماضي، نهضت كأفضل ما تكون النهضة، وتقدمت بأعظم ما يكون التقدم، ولم تشكل لديها هذه الحروب سوى تاريخ غابر تستمد منه العبر والدروس، وتعمل على عدم تكراره في المستقبل.
بل أن الدولة التي تلقت أول ضربة في التاريخ بالقنابل النووية، وقدمت ضحايا يتجاوز عددهم مئات الألوف، وورثت تشوهات خلقية مستديمة لأعداد لا تحصى من المدنيين، وهي اليابان، باتت الآن من أكثر دول العالم تمدناً وحضارة، وأضحت العملاق الآسيوي الأكبر، الذي ينعم بمستوى راق من العيش، وقدر عال من الرفاهية، ولم يكن هناك في آسيا من يضاهيها في التنمية والعمران حتى سنوات قريبة، حينما أزاحها المارد الصيني عن الصدارة.
حتى الصين هذه، كانت ضحية حروب كثيرة لم يكن آخرها الاحتلال الياباني، فقد جارت عليها دول كثيرة، وشهدت حروباً أهلية، ونزاعات عقائدية، وكان أن خرجت منها جميعاً في هذا القرن قوية متماسكة، وهي تخطو الآن خطوات سريعة نحو زعامة العالم.
ومعنى ذلك أن هناك مقومات أخرى لتجاوز حالة الضعف تملكها الشعوب عادة، وحينما تتعرض لتحديات وجودية، تنطلق هذه المقومات من عقالها، وتقوم بالتعويض عما لحق بالبلاد من أذى، أي أن الحرب العادلة تقوم بدور المحفز الذي يعطي المجتمع طاقة خلاقة للتغلب على آثار الخسارة أو الهزيمة أو فقدان الأرواح والأموال، وتحمل الجميع على تصحيح ما وقعوا فيه من أخطاء وتراجعات.
وربما لا تنال هذه الميزة شعوب أخرى، لأسباب ذاتية وموضوعية، حينما تستشري روح الهزيمة في أوصالها، أو تخوض حروباً عبثية لا طائل منها ولا داع، مثلما فعل العراق في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
وصفوة القول، أن الحروب لا تشكل سبباً معقولاً للانهيار أو التراجع أو الدمار، إلا حينما تحوي الشعوب في داخلها القابلية لمثل هذا المصير، أو تعجز عن استيعاب ما تخلفه من عبر ودروس، أما الشعوب التي تمتلك العزيمة الصادقة، والإيمان الراسخ، فهي قادرة على تحويل الهزيمة إلى نصر، والحزن إلى قوة، والخسارة البشرية أو المادية، إلى حافز للتغيير والنضج والابتكار.


 احترام الرأي والرأي الآخر
احترام الرأي والرأي الآخر
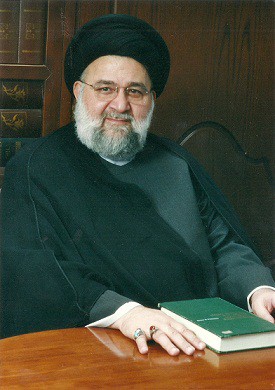 الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال
الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال
 من الخرائط إلى التجسس الشخصي.. الوجه المظلم لخدمات GPS في الهواتف المحمولة
من الخرائط إلى التجسس الشخصي.. الوجه المظلم لخدمات GPS في الهواتف المحمولة
 على حافة الآخرة لسامي النصراوي.. نصيحة من دفان لا تصاحب الميتين
على حافة الآخرة لسامي النصراوي.. نصيحة من دفان لا تصاحب الميتين
 الوحدة .. الوجه الخفي للألم
الوحدة .. الوجه الخفي للألم
 الوجه الثقافي للعراق
الوجه الثقافي للعراق
 فلسفة الوجود والإعتراف بالآخر
فلسفة الوجود والإعتراف بالآخر
 السامرائي يفكّك طلاسم الآخرين في سريالية فكرية
السامرائي يفكّك طلاسم الآخرين في سريالية فكرية
