
الناخب بين العقل والعاطفة: مقاربة أنثروبولوجية في الوعي السياسي والثقافة الانتخابية
نصير فكري الربيعي
يشكّل سلوك الناخب لحظة رمزية تتجاوز حدود السياسة لتدخل في عمق الثقافة. فالإنسان لا يصوت بعقله وحده، ولا بعاطفته فقط، بل بما تختزنه ذاكرته الجماعية من قيم وانتماءات وتجارب.
ومن منظور أنثروبولوجي، يُعدّ التصويت فعلاً ثقافياً يعكس الوعي الجمعي أكثر مما يعكس الحسابات الفردية.
العقل في القرار الانتخابي يمثل الجانب التحليلي المرتبط بالمصلحة والمقارنة بين البرامج، أما العاطفة فهي الجانب الرمزي الذي يتصل بالانتماء والهوية والذاكرة الاجتماعية. وفي كثير من المجتمعات، خاصة تلك الخارجة من أزمات أو حروب، تميل الكفة لصالح العاطفة، لأن الناخب يبحث عن الأمان والانتماء قبل البحث عن الكفاءة.
يرى عالم الاجتماع (بيير بورديو ) أن الأفراد لا يختارون بحرية مطلقة، بل داخل ما يسميه (الهابتوس) ، أي المنظومة الثقافية التي تشكل سلوكهم دون وعي. وبهذا المعنى، حين يصوت الفرد فهو يعيد إنتاج ثقافته السياسية لا أكثر . هذه الفكرة تفسر كيف يصبح التصويت أحيانا “واجباً هوياتياً ” لا خياراً عقلانياً
في التجربة العراقية بعد عام 2003، تجلى هذا التداخل بين العقل والعاطفة بوضوح. فالكثير من الناخبين اختاروا وفق روابط عشائرية أو طائفية أو مناطقية، لا وفق البرامج الانتخابية. التصويت هنا تحوّل إلى فعل رمزي يُعبّر عن الولاء والانتماء أكثر مما يعبر عن القناعة. فحين يقول الفرد “ صوّت لأبناء منطقتي” فهو يكرّس هوية جماعية تتقدّم على التفكير البرامجي.
غير أن العاطفة ليست دائماً سلبية. فقد تكون حافزاً وطنياً نحو المشاركة السياسية عندما ترتبط بقيم المصلحة العامة والمواطنة. وهنا يبرز دور التربية السياسية والإعلام الواعي في نقل العاطفة من مستوى الولاء الضيق إلى مستوى الانتماء للوطن.
تلعب وسائل الإعلام دوراً محورياً في صياغة هذا المزج بين العقل والعاطفة. فالحملات الانتخابية المعاصرة تعتمد على الرموز والألوان والموسيقى بقدر اعتمادها على الخطاب العقلاني. وتُظهر التجارب أن الخطاب الذي يوازن بين المنطق والعاطفة هو الأكثر تأثيرًا في الناخبين، لأنه يخاطبهم بوصفهم كائنات ثقافية تتفاعل بالعقل والشعور معاً .
أما الفضاء الرقمي، فقد أضاف بعداً جديداً للفعل الانتخابي. فوسائل التواصل الاجتماعي تُعيد تشكيل الرأي العام عبر “ فقاعات رقمية ” تجمع الأفراد المتشابهين في الانتماء، مما يعزز التفكير العاطفي الجمعي ويحدّ من النقاش العقلاني. وهنا يظهر التحدي الثقافي الجديد للديمقراطية في العصر الرقمي.
إنّ دراسة سلوك الناخب من منظور أنثروبولوجي تعني فهم البنية الثقافية التي تجعل هذا السلوك ممكناً . فالسؤال الأعمق ليس “ لِمَ صوّت الفرد بهذا الشكل ؟”، بل “ أي ثقافة أنتجت هذا الاختيار ؟”. بذلك يتحول التحليل من تفسير القرار الفردي إلى فهم الوعي الجمعي.
الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق فقط بوجود صناديق اقتراع، بل حين يتحول التصويت إلى ممارسة ثقافية ناضجة قائمة على التفكير النقدي والوعي بالمصلحة العامة. فكلما ترسخ هذا الوعي، اقترب الفعل الانتخابي من العقلانية، وكلما هيمنت العاطفة الضيقة، تحوّل الانتخاب إلى طقس رمزي بلا مضمون.
في النهاية، الناخب هو مرآة لثقافته؛ فحيث تسود الثقافة النقدية، ينتصر العقل، وحيث تهيمن العصبية والانفعال، تتراجع الديمقراطية. ومن هنا تبقى الأنثروبولوجيا مفتاحاً لفهم السياسة بوصفها فعلاً ثقافياً يعكس صورة الإنسان ومجتمعه أكثر مما يعكس لعبة السلطة.


 الانتخابات، صناديق الخوف والطائفية
الانتخابات، صناديق الخوف والطائفية
 من باب الدرب إلى القصيدة.. سيرة وطنٍ في القلب
من باب الدرب إلى القصيدة.. سيرة وطنٍ في القلب
 دردشه ممتعة مع الدكتور علي الوردي..هن الجنة والنار وحياته في القبور!
دردشه ممتعة مع الدكتور علي الوردي..هن الجنة والنار وحياته في القبور!
 نائب سابق: ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى
نائب سابق: ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى
 المالية تنفي قطع رواتب الاعانة
المالية تنفي قطع رواتب الاعانة
 ديالى أولاً في مخيم الجوالة الدليلات للإستدامة البيئية
ديالى أولاً في مخيم الجوالة الدليلات للإستدامة البيئية
 بسبب مصنع في سوريا.. بدء محاكمة شركة لافارج بتهمة تمويل داعش وجبهة النصرة
بسبب مصنع في سوريا.. بدء محاكمة شركة لافارج بتهمة تمويل داعش وجبهة النصرة
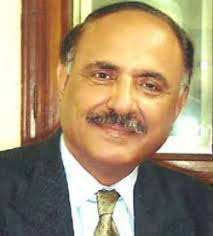 تراجع مخزون المياهفي ثاني كبرى المدن الإيرانية
تراجع مخزون المياهفي ثاني كبرى المدن الإيرانية
