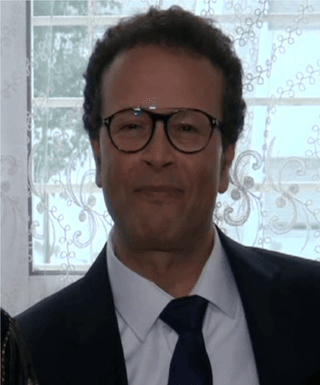
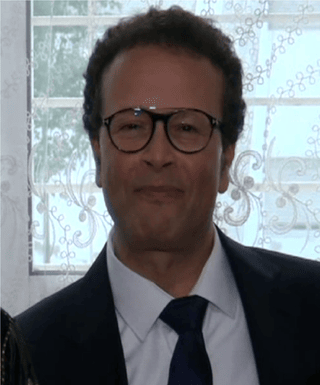

حوار صحفي مع أورهان أوغوز.. قاصّ تّركي يتنفس أدباً عربياً
مُحمد سعيد الرّيْحاني
تخيل كاتبًا تركيًا ينهض كل صباح مع أول خيوط الشمس، يسير بين الأشجار ثم يجلس ليكتب بالعربية تحت تغريد الطيور، كأنما يهب العالم نصيبًا من دفء روحه.
ليس غريبًا إذن أن يجد أورهان أوغوز نفسه موزعًا بين ثلاث هويات متداخلة: الإنسان الحالم، والقاص الذي يغزل من تفاصيل الحياة اليومية حكايات نابضة، والأكاديمي الذي يرى في البحث العلمي طريقًا طويلًا لكنه ممتلئ بالثمر.
في هذا الحوار الصحفي، يأخذنا أوغوز من قونيا – المدينة العريقة التي ولد فيها – إلى رحلته الأكاديمية التي أوصلته إلى كرسي الأستاذ الجامعي، ثم إلى تجربته الأدبية الفريدة: الكتابة بالعربية بدلًا من التركية، واستلهام القصص من أبسط المواقف التي تتحول بين يديه إلى عوالم كاملة.
كيف انطلقت أولى قصصه من حوار قصير بين أب وابنته؟ ولماذا آثر القصة القصيرة في زمن الرواية؟ وما الذي يجعله يكتب بالعربية حبًا لا تكليفًا؟
أسئلة يجيب عنها أورهان أوغوز بصراحة ودفء، كاشفًا عن عالم يوازن بين البحث العلمي وسحر الأدب، وبين الجذور التركية واللسان العربي.
حضارات عدة
□ من هو أورهان أوغوز: الإنسان والقاص والأكاديمي؟
- وُلدتُ في مدينة قونيا الواقعة في وسط تركيا، والتي تُعَدّ مهدًا لحضارات عديدة عبر التاريخ. درستُ المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في قونيا، ثم التحقتُ بكلية الإلهيات التي تُدرّس اللغة العربية في مستوى جامعي. وأثناء دراستي الجامعية في أنقرة، عاصمة تركيا، تلقيتُ دروسًا خاصة من علماء اللغة العربية. وبعد إتمام دراستي، عملتُ معلّمًا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
أكملتُ دراساتي العليا في قسم اللغة العربية بجامعة سلجوق في قونيا. وبعدها بدأتُ العمل محاضرًا في كلية الآداب بجامعة كليس، وخلال عملي هناك التحقت ببرنامج الدكتورة. ثم انتقلتُ إلى جامعة بوزوك في يوزغات، وبعد حصولي على الدكتورة بدأت العمل بجامعة كرمان أوغلو محمد بك، حيث أعمل حتى الآن في كلية الآداب، بقسم الترجمة التحريرية والشفوية اللغة العربية.
أنا متزوّج ولدي ابن وابنة.
فبوصفي مؤلّف قصص، أرى أن الكتابة هي أثمن ما في حياتي. كل يوم تقريبًا أخرج مع أول خيوط الشمس، أمشي قليلًا بين الأشجار، ثم أجلس تحت ظلالها وأبدأ الكتابة على أنغام تغريد الطيور. إذا استهللتُ يومي بهذه الطريقة أشعر أنني أنجزتُ شيئًا نافعًا لي وللعالم، فأقضي يومي ممتلئًا بالرضا والسرور. لذلك أوصي كل شخص أن يبدأ يومه بعملٍ يُبهجه ويمنحه معنى.
كتابة القصة هي أهم ما في حياتي، لأنني أُودِع في كل قصةٍ شيئًا من حياتي، ومن أفكاري، ومن مشاعري، من غير أن يدرك القارئ ذلك صراحة. أحبّ أن أقرأ ما كتبتُ مرارًا، وأجد في إعادة قراءته سرورًا لا مثيل له.
وأما أنا كأكاديمي، فأجد سعادتي بين الشباب الذين تعلّقت قلوبهم بالبحث والقراءة. فالأكاديمية طريق طويل ووعر، لكنها تغدق على السالك فيها علماً يزداد يوماً بعد يوم. ونحن كأساتذة الجامعة، حين نجتمع ونتبادل أطراف الحديث في شؤون الحياة اليومية، لا يلبث أن ينقلب حديثنا إلى أفكار عميقة تستدعي دراسات وبحوثاً علمية. لذلك أذهب إلى عملي مسروراً، وحياة الأكاديمية تملأ أيامي بالبحث والقراءة والكتابة، وتمنحها ثمرتها الحقيقية.
□ لماذا اخترت الكتابة باللغة العربية بدل الكتابة باللغة الأم، اللغة التركية؟
- هناك عدة أسباب دفعتني إلى اختيار الكتابة بالعربية، لا بالتركية التي هي لغتي الأم.
فأول هذه الأسباب أنني متخصص في اللغة العربية، وقد قضيت سنوات عمري منذ بداية دراستي الجامعية حتى يومنا هذا منكبًّا على العربية، علمًا وأدبًا. أقرأ المقالات والكتب العلمية، وأستمتع بالمطالعة في الأدب، من قصص وروايات وحِكم ونوادر وغيرها. ثم قلت لنفسي: ما دمت تقرأ بالعربية، فعليك أن تكتب بها أيضًا.
وحين أعود إلى ما كتبته في بداية الكتابة، ثم أقارن ذلك بما أكتبه الآن، أرى فرقًا شاسعًا وتطورًا ملحوظًا. وهذا يمنحني أملًا كبيرًا، ويعزز ثقتي بقدرتي على المضيّ قُدمًا في كتابة القصة، بل الرواية. أعلم أن الطريق ما زال طويلًا أمامي، لكنني أحب أن أسير فيه بخطى ثابتة، فمتعة الكتابة نفسها هي ما يجعل هذا الطريق يستحق أن يُعاش.
وأما السبب الثاني، فهو أنني رأيت – من خلال النشاطات العلمية – أن كثيرًا من علماء العجم، سواء كان تركيا أو فارسيا، قد ألّفوا كتبهم باللغة العربية، وجعلوا منها لسانًا للعلم والحكمة. فاتبعت سبيلهم، واتخذت قرارًا حاسمًا أن أخدم هذه اللغة قدر ما أستطيع، ولو كان ذلك بمقدار ذرة.
وأختم هذا القسم بنكتة لطيفة سمعتها من أحد أساتذتنا في الجامعة، إذ كان يقول:
اتقنوا تعلّم اللغة العربية، فهي في الحقيقة لغتنا الأم جميعًا، نحن المسلمين في أي بلد كنا ومن أي جنسية انحدرنا. وكيف ذلك؟ لأن زوجات الرسول هنّ أمهات المؤمنين، ولغتهن العربية… وبناءً على ذلك فاللغة العربية هي لغتنا الأم!
مقالات اكاديمية
□ من ألهمك الكتابة القصصية؟ ومِمّاذا تستمد قضايا نصوصك وتيماتها؟
- كنت أنشغل طويلًا بالنشاطات العلمية، فأقرأ الكتب والمقولات الأكاديمية أكثر من قراءتي للأدب. ومع ذلك، لم أكن أغفل عن القصص والروايات، خاصة من أعمال كبار الأدباء العرب مثل محمد حسين ومحمد تيمور ونجيب محفوظ ونجيب الكيلاني وغيرهم. وبعد أن أنهيت دراسة الدكتوراه وحصلت على منصب أستاذ مشارك، وجدت نفسي أميل أكثر فأكثر إلى قراءة القصص، حتى صارت جزءًا رئيسيًا من يومي.
وقد كتبتُ مقالة علمية باللغة التركية عن الحرية في قصص محمد سعيد الريحاني، وكان ذلك نقطة تحوّل جعلتني أفكر جديًا في كتابة القصص بنفسي. عندها تساءلت:
هل أكتب قصصًا تاريخية؟ أم قصصًا للأطفال؟ أم قصصًا بوليسية؟ أم قصصًا سياسية؟
لكنني كنت عاجزًا عن اتخاذ القرار، لأن أياً من هذه الأجناس لم يكن يعكسني أنا ولا أحاسيسي العميقة.
ذات يوم رأيت رجلاً وابنته يملآن الماء. وكانت البنت تحدّث أباها بحماس عن عمل الخير الذي قامت به في المدرسة؛ أمرٌ رأته هي عظيمًا، بينما بدا بسيطًا في نظر غيرها. كانت تروي التفاصيل بعاطفة طفولية صادقة، لكن الأب لم يصغِ إليها جيدًا، إذ كان مشغولًا بعمله. وعندما سألته: يا أبي، أليس هذا من عمل الخير؟ أجابها ببرود: يا ابنتي، الخير الحقيقي ستفعلينه حين تصيرين طبيبة.
وأنا قررتُ أن أدوّن ما دار بين الأب وابنته، وظننت أن ما في داخلي بحر لا ينفد بالكتابة. وضعت الحاسوب أمامي وبدأت أسطر الكلمات، فإذا بالنتيجة لا تتجاوز صفحة واحدة، حوارًا مقتضبًا بين الأب والبنت.
لكنني لم أتوقف عند هذا الحد؛ إذ أخذتُ أتساءل: ما الأسباب التي جعلت الأب يقلّل من شأن ما فعلته ابنته؟ غصتُ في مخيلتي أستعيد أيام شبابه، وأتأمل الآمال التي لم تتحقق، والانكسارات التي حملها.
ومن هنا انفتح أمامي عالمه الداخلي؛ فصغتُ حياة الرجل كما تخيّلتها، وأضفت إليها من حياتي الخاصة، من آمالي وآلامي، ومن الأشياء التي أحبها وتلك التي أنفر منها.وهكذا، تحوّلت صفحة واحدة إلى قصة من عشرين صفحة، تحمل في طياتها مزيجًا من الواقع والخيال، ومن التجربة الذاتية والرؤية الإنسانية..
وكانت هذه أول قصة كتبتها، وعنونتها «الطبيب». ثم تتابعت القصص واحدة تلو الأخرى. «الحب»، وهي قصة طالِبتي حين كنتُ معلّمًا في الثانوية. لا تهتم بالدروس، وعلمت أن أباها قد مات وهي تحب أباها حبا جما. «الله يعلم»، وهي قصة رجل غني يساعد من يحتاج إليه سرا.
«السيارة»، وهي قصة دارت بيني وبين طبيب الأسنان صديقي... هكذا أستوحي مواضيع القصص من الحياة، سواء من تجاربي الشخصية أو مما رأيت أو سمعت. ثم أقوم بتحليل الأسباب معتمدًا على علم النفس وعلم الاجتماع، وأضيف إليها الكثير من حياتي وتجربتي الشخصية، لتصبح القصة ممتلئة بالأبعاد الإنسانية والعاطفية.
□ تركيا أرض الرواية والروائيين الكبار المشهود لهم عالميا بالنبوغ في المجال، لماذا اخترت خوض تجربة القصة القصيرة في بلد الرواية وزمن الرواية؟
- في الحقيقة، كنتُ أفكر في أن أكتب القصص فقط، ولم أرغب في كتابة الروايات. وهذه الفكرة كانت تستند إلى عدة أسباب شخصية.
أولاً، أردت أن أتناول مواضيع متعددة عبر كتابة القصص، بينما الرواية عادة تدور حول موضوع واحد فقط. فعلى سبيل المثال، في كتابي «الحب قصص عن الحياة» تناولت سبع قصص مختلفة عن الحياة، وكل قصة تعالج مشكلة هامة تواجه الفرد والمجتمع. ففي قصة «الطبيب»، الرجل لا يهتم بما فعلته ابنته، ويرى أنما فعله من خير كشيء بسيط، إنما الخير بالنسبة له حين اتخذت مهنة وهي الطبيب، وفي نهاية القصة يلاحظ القارء أهمية اعطاء القيمة بما فعل الأولاد.
مثال آخر، في قصة «السيارة»، هناك شاب يحب السيارات ويتمنى أن يكون صاحب سيارة فاخرة في أحدث موديلات، يقارن حياته دائما بهذا الحلم، حين يذهب إلى بلدة بالحافلة يتمنى أن يكون له سيارة حتى يصل إلى ما يريد في أسرع وقت، وكان غير سعيد لأنه لم يصل إلى هدفه، وحين رأى أن طبيب الأسنان الذي عرفه في بلدة عين إليه للعمل. له سيارة فاخرة ولكن له ابن لا يمشي، يلاحظ القارء أن السعادة ليست بما يتخيل بل بما يملكه
ثانيا، أنا بدأت الكتابة باللغة العربية وهي ليست لغة الأم، وفي البداية رأيت أن الرواية صعب لي، ولكنني حين انتهيت من كتابة القصص، شعرت بطمأنينة غامرة وبدأت كتابة رواية عنونتها «مطعم ف & ق» وصل حجمها المائة صفحة. وهي تدور حول حياة صديقين.
بعدها، بدأت رواية أخرى عنونتها «شريفة». وهي تحكي عن حياة أمي الحبيبة.
ومن مؤلفاتي: «الحب» قصص عن الحياة (مجموعة قصص)، «كلمات الحب» (مجموعة قصص)، «إنسان طيب» (مجموعة قصص)، «مطعم ف & ق» (رواية)، «شريفة» (رواية)...
□ كلمة أخيرة؟
- أتوجّه بخالص الشكر والعرفان إلى الأستاذ محمد سعيد الريحاني على اهتمامه بكتابي، كما أشكر كل من شجعني وساندني في هذا الطريق الطويل والصعب، فبفضلهم يزداد إصراري على المضي قدمًا في درب الكتابة.


 البناء العمودي ..بمعزل عن التخطيط
البناء العمودي ..بمعزل عن التخطيط
 سازوكي و معلمه الأبيض
سازوكي و معلمه الأبيض
 الدورة 26 من معرض بغداد الدولي تواصل فعالياتها
الدورة 26 من معرض بغداد الدولي تواصل فعالياتها
 إفتتاح معرض للتشكيلي المغترب علاء سريح
إفتتاح معرض للتشكيلي المغترب علاء سريح
 النَّصُّ المُستَشْرفُ.. قراءاتْ بلاغيَّة نقديّة في تحولاتِ القصيدة المعاصرةِ
النَّصُّ المُستَشْرفُ.. قراءاتْ بلاغيَّة نقديّة في تحولاتِ القصيدة المعاصرةِ
 زيدان يناقش مع الأمم المتحدة إستعدادات الإنتخابات
زيدان يناقش مع الأمم المتحدة إستعدادات الإنتخابات
 الاتفاقية والمعاهدة ومذكرة التفاهم في ضوء قانون فيينا للمعاهدات
الاتفاقية والمعاهدة ومذكرة التفاهم في ضوء قانون فيينا للمعاهدات
 التعليم يعزّز الشراكة الأكاديمية مع الأوربي عبر برنامج إيراسموس
التعليم يعزّز الشراكة الأكاديمية مع الأوربي عبر برنامج إيراسموس
