


حين يصبح الغياب لغة للسماء
قراءة ميتافيزيقية - فلسفية - سيميائية لنص “نشيد لأبي” للشاعرة بشائر الشراد
عبد الكريم الحلو
* لايفهم النص كاملا إلا بقراءتين منفصلتين
* الكتابة بقراءتين تعني تقديم مستويين من التحليل النقدي لنص واحد،
* بحيث يضيء كل مستوى زاوية مختلفة من العمل الأدبي،
* وكأنك تكتب بعيون عدستين مختلفتين
* أو تتعامل مع النص كلوحة فنية
* تُشاهد اللوحة من زاويتين مختلفتين.
القراءة الاولى :
+++++++++
القراءة السيميائية والفلسفية :
ءء=================
مقدمة :
حين يتحوّل الغياب إلى لغة سرّية
-------------------------------
في نص “نشيد لأبي”
* يتحول الغياب من مجرّد حدث شخصي إلى خطاب كوني.
* لا نقرأ هنا رثاءً كلاسيكيًا للأب،
* بل نواجه ملحمة وجدانية تُعيد رسم العلاقة بين الإنسان والله، بين الحلم والواقع، بين الجذور والغياب.
* النص مكتوب بنبرة تُشبه الصلاة المتمرّدة:
* دعاء يحمل احتجاجًا،
* وحزنًا يتصاعد حتى يصير فلسفة.
* الشاعرة المبهرة بشائر الشراد تكتب كما لو كانت تمسك جمر الغياب، تصهره لتكوّن منه قلائد من صورٍ مشعّة، حيث يختلط الرمز بالملموس، والعاطفي بالميتافيزيقي، لتصنع نصًا لا يُقرأ بعيون باردة، بل يُحسّ كأنّه ينهض من رماد القلب.
أولاً: الأب كمرآة للكون :
-------------------
العنوان: “نشيد لأبي”
* يوحي مباشرة بطقس قداسي، أقرب إلى تراتيل الخلود، لكنه هنا يحمل رمزية أوسع من الأب الشخصي:
* الأب هو الوطن:
* حين تقول :
* “ نبحث عنه في عربة بائع الخضار… وفي بطاقات التموين”،
* تتحول صورة الأب إلى وطنٍ مغيّب تُبحث عنه ملامحه في كل زاوية حياة.
* الأب هو الحامي الميتافيزيقي:
* في جملة :
* “وأنت ذاهب إلى الله، قل له…”،
* يصبح الأب وسيطًا بين الشاعرة والسماء، رسولًا للحلم المؤجل.
* الأب هو الجذر:
* النص يحاول الإمساك بظل الأب كجذر مفقود، كحبل سرّي يربط الحاضر بالماضي.
ثانيًا:
العصافير والسنابل
سيمياء الحياة المقهورة
----------------------
افتتاحية النص :
“ يا خيبة العصافير،
حين تقايض زقزقات الروح
بكسرة دخن يابس…”
* هنا نواجه رمز العصافير التي تُحيل إلى الحرية والحياة البسيطة،
* لكن “كسرة الدخن اليابس” تجعل هذه الحرية مجرّد شظايا جوع.
• العصافير = الروح، البراءة، الحلم.
• الدخن اليابس = القهر، الجوع، الانكسار.
* أما “دمعة السنابل”
* فهي صورة مذهلة تختزل فكرة الأرض والخصب حين يتحولان إلى بكاء،
* كأن الحقل نفسه يندب الأب الغائب والوطن المتشظي.
ثالثًا:
اللغة ككائن يعانق الإنسان
-------------------------
في جملة:
“ وفي لثغات أغاني السويحلية
نشتهي تجانس اللغة،
لا لشيء…
إلا لأن اللغة تُربّت على أكتافنا،
وتندب.”
* هنا تتحول اللغة إلى كائن أمومي، تمسح على كتف البشر وتبكي معهم. هذا التصوير الفلسفي للغة يجعل النص أقرب إلى ميتافيزيقا الكلام: فالكلمات ليست مجرد أدوات تعبير،
* بل كائنات حيّة تبكي وتهدّئ وتربّت.
رابعًا:
أبوة المعنى وميتافيزيقا الوجود
----------------------------
* القصيدة تبدأ من الأرض
* بائع الخضار،
* بطاقات التموين،
* السنابل،
* التنانير الطينية
* ثم تصعد تدريجيًا نحو السماء
* (الله، المغفرة، الفرمان الإلهي).
* هذه الحركة العمودية
* تمنح النص بنية “المأساة المقدسة”، كأننا أمام صلاة تنقش الألم على جدار الغياب.
* “ نحمل فرمانًا إلهيًا بالمغفرة”:
* هنا الغياب يكتسب سلطة دينية، وكأن موت الأب ليس مجرد فقد، بل حدث يتطلب أن تُرفع الأحلام إلى الله كوثيقة احتجاج.
خامسًا:
الفلسفة الشعورية
الحلم أم الصحو؟
-----------------
ختام النص:
“والآن لا نعرف: أيّها أصدق:
الحلم أم الصحو؟
أم ذلك الفراغ،
الذي نُسمّيه أبًا لنا حين لا تعود…!”
* هذا السؤال يُدخل النص إلى فضاء فلسفي وجودي:
* هل الغياب الحقيقي هو موت الأب،
* أم موت الحلم؟
* هل الحلم (وهو بقاء الأب في الذاكرة) أصدق من الواقع الذي يواجهنا بالفراغ؟
* هذه الأسئلة تضع النص في منطقة هايدغرية (فلسفة الوجود والعدم)، حيث يصبح الأب كائنًا بين الظل والفراغ، حاضرًا كغياب، وغائبًا كذكرى حية.
سادسًا:
البناء الصوتي – النشيد كطقس لغوي
-----------------------------------
تكرار النداء “يا أبي…”
* يمنح النص بُعدًا طقسيًا،
* أشبه بالتراتيل الدينية.
هذا التكرار يعمل على:
1. تثبيت الألم:
كل نداء يُعيد فتح جرح الغياب.
2. خلق إيقاع داخلي:
يجعل النص كأنه موجة وجدانية،
ترتفع وتهبط بين الحلم والخذلان.
سابعًا:
الصورة الشعرية – عبقرية الانزياح
-------------------------------
من أجمل صور النص:
• “سنابل صفراء تمشّطها الريح.” (تشخيص الريح كأم تمشط شعر الحقول).
• “أحلامنا كبيرة أغلقنا عليها النوافذ.” (تجسيد الحلم ككائن محبوس ينتظر الانفراج).
• “وردة لا تأكلها ماكينات البلاد.” (رمزية الورد كبراءة تُسحق بقسوة السياسات والحروب).
* هذه الصور لا تكتفي بوصف الواقع،
* بل تفككه وتعكس هشاشته أمام براءة الحلم.
ثامنًا:
البعد السياسي والاجتماعي
------------------------
* النص يخفي تحت رثائه للأب صرخة سياسية مبطنة:
* الحديث عن بطاقات التموين، بائع الخضار، جرارات الحقول، يشير إلى قهر اجتماعي/اقتصادي.
* “ ماكينات البلاد” ترمز للآلة السياسية القاسية التي تسحق الحياة البسيطة.
* هذا يجعل النص ليس فقط رثاءً للأب،
* بل شهادة على عصرٍ مريض، حيث الغياب الأبوي يتوازى مع غياب الوطن العادل.
تاسعًا:
لماذا النص استثنائي؟
--------------------
1. لأنه يمزج البساطة الشعبية (السويحلية، بائع الخضار) مع الرمزية الفلسفية (اللغة، الحلم، الله).
2. لأنه يكتب الوجع بصور غير مألوفة،
لا تقع في فخ البكائية التقليدية.
3. لأنه يخلق فضاءً روحيًا وسياسيًا واجتماعيًا في آن واحد.
الخاتمة:
النشيد كوثيقة خلود
-------------------
“نشيد لأبي”
* ليس مجرد نص شعري، بل حالة وجدانية كاملة، نص يمكن أن يُعلّق على جدار القلب كوثيقة لا تشيخ.
* هو نص عن البحث الأبدي عن المعنى، عن الظل الذي لا يسقط، عن اللغة التي تُربّت على أكتافنا حين يمضي الآباء.
* إنه قصيدة تذكّرنا بأن الغياب قد يكون أحيانًا أعظم حضور.
****************************
القراءة الثانية :
+++++++++
الدراسة النقدية الانطباعية والتحليلية :
=========================
مقدمة :
--------
عندما يصبح الغياب كائنًا شعريًا
في نص “نشيد لأبي”
* تقف الشاعرة بشائر الشراد
* عند تخوم اللغة لتبتكر رثاءً ليس كأي رثاء، نصًا مشبعًا بالدهشة والوجع والبحث عن “الأب” الذي صار رمزًا للظل، للحماية، ولذاكرة البيت الأولى.
* النص أشبه بمرثية تتجاوز الفردي إلى الكوني، حيث يتقاطع الغياب مع الحلم، والبحث عن الأب يتحول إلى بحث عن الوطن، والهوية، واللغة، وحتى عن الله.
* هذا النص ليس فقط صرخة حنين،
* بل هو بناء شعري متماسك يحمل دلالات نفسية واجتماعية وسياسية،
* وهو يندرج ضمن النصوص التي تتجاوز الإطار الكلاسيكي للرثاء إلى نص فانتازي واقعي، يمزج بين البنية الرمزية واللغة اليومية في صور مذهلة.
أولًا:
الغياب كمعمار نصي
-------------------
* العنوان “نشيد لأبي” يعكس حالة من التمجيد والترتيل، لكنه لا ينغلق على البكائية المعتادة،
* بل ينفتح على خطاب احتجاجي-روحي.
* فالأب ليس مجرد شخص غاب، بل هو معنى انطفأ، ظلّ اختفى، سقف انهار.
تقول:
“يا أبي… وأنتَ ذاهبٌ إلى الله،
قُل له: إنّ أحلامنا كثيرة…”
هنا يتحول الأب إلى رسول،
حامل لآلام العائلة أمام الإله،
* كأن الشاعرة تصعد بغيابه إلى مقام كوني، تعيد ترتيب العلاقة بين الغياب والحلم.
الغياب ليس موتًا فقط،
بل “فرمان إلهي”،
أي أمر سيادي يتجاوز قدرة البشر،
* وهذه المفارقة بين “الأمر الإلهي” و”قهر الواقع” تصنع توتر النص، وتجعل صوت الشاعرة أقرب إلى الابتهال.
ثانيًا:
شعرية التفاصيل اليومية
------------------------
* يمتاز النص بقدرته على تحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى رموز عاطفية:
“نبحثُ عنه
في عربة بائع الخضار،
في تعرّق الدوّارين،
في بطاقات التموين…”
* هذه الصور تقحم الأب في تفاصيل المجتمع، في الفقر، في رائحة العرق والحاجة، كأنه ليس رمزًا للعائلة وحدها، بل رمزًا للوطن المفقود والمغيب.
* ثم تأتي صور أخرى تعمّق هذا الحسّ الواقعي المتداخل مع الرمز:
نُريد بنفسجًا
لا تمسّه الأزاميل،
ولا تجرحهُ الفؤوس
* إنها استعارة للحياة البسيطة النقية، التي لا تدنسها قسوة السياسة ولا عنف الواقع.
ثالثًا:
الرمزية المزدوجة
( الأب – الوطن – الله)
---------------------
النص يتحرك بثلاث دوائر متداخلة:
1. الأب الشخصي:
كظل، كحماية، كبيت أول.
2. الأب الرمزي (الوطن):
إذ تتحول صور البحث عن الأب إلى بحث عن وطن حنون، عن بيت رطب لا يسقط، عن سنابل تشبه الخير والوفرة.
3. الأب الكوني (الله):
في مقطع:
“يا أبي…
وأنت ذاهب إلى الله،
قل له: إنّ أحلامنا كثيرة.”
* هنا تنتقل القصيدة إلى حوار كوني، حيث يُحمّل الأب رسالة البشرية - العائلة أمام الإله.
رابعًا:
ال لغة ككائن حيّ
-----------------
* لغة النص ليست ساكنة،
* بل تنبض بنبرة شعورية متصاعدة،
تبدأ من :
“ يا خيبة العصافير…”
لتنتقل إلى :
“ نحن نريد ظلّك !”
ثم تتصاعد نحو :
“ ها نحن يا أبي…
نمنا طويلًا بين الكتب القديمة .”
* هذه القفزات تجعل النص أشبه بموجة، تنكسر على حواف الذاكرة ثم تعود أقوى.
* اللغة تمزج بين حس شعري فطري ولغة الحياة اليومية:
• “تنانير الطين الحارّة”
صورة عبقرية :
تربط الذاكرة بالحنين والحرارة
• “نتهجّى ألف بائها”
( دلالة على الطفولة والتعليم والحب البدائي للحياة).
• “وفي لثغات أغاني السويحلية”
(استدعاء محلي شعبي للهوية الثقافية).
خامسًا:
الدلالات النفسية – الحنين كألم عضوي
------------------------------------
النص يقوم على فكرة أن الحنين ليس مجرد شعور، بل ألم عضوي يسكن الجسد:
“نبحثُ عنه
في عربة بائع الخضار،
في ألبومات الصور القديمة،
في نوروز…”
* هذا الحنين يتجاوز الأب الشخصي ليصبح بحثًا عن الدفء، عن أصلٍ تاه، عن جذور ضاعت في متاهة الغياب.
* الصوت الشعري هنا
* ليس صوت ابنة لأب غائب فقط،
* بل صوت مجتمع يُحاور ذاكرته الممزقة.
سادسًا:
البنية الموسيقية – نشيد الغياب
-----------------------------
النص مكتوب بنسق أقرب إلى :
نشيد جنائزي ممزوج بتضرع،
حيث التكرارات:
“يا أبي…”
“قل له يا أبي…”
* تخلق إيقاعًا موجيًّا، أشبه بتراتيل تُتلى على قبر الأب، أو على أبواب السماء.
* القصيدة تتحرك بين النداء (يا أبي) والأمنيات (نريد… نبحث… نحمل)، فيتصاعد النص كما لو كان دعاءً طويلاً محمّلًا بالدموع.
سابعًا:
الصورة الشعرية – كيمياء الرموز
-----------------------------
* الصورة الشعرية لدى الشاعرة بشائر الشراد تقوم على مزاوجة المتناقضات:
*
• “دمعة السنابل”
( امتزاج الحزن بالحياة).
• “اللغة تُربّت على أكتافنا” (لغة كائن حي، أمّ تحتضن أبناءها).
• “ورد لا تأكله ماكينات البلاد”
( رفض للخراب الصناعي والسياسي للحياة).
ثامنًا:
البعد الفلسفي – الحلم/الغياب/الصحو
-------------------------------------
النص ينتهي بأسئلة ميتافيزيقية:
“أيّها أصدق:
الحلم أم الصحو؟
أم ذلك الفراغ الذي نسمّيه أبًا؟”
* إنها ذروة النص، حيث يتحول الغياب إلى سؤال وجودي، ويغدو الأب فكرة مُعلّقة بين الحقيقة والوهم.
* بهذا تتحول القصيدة من نص رثائي إلى نص فلسفي وجودي يلامس جوهر الفقد والإنسان.
الخاتمة:
----------
* لماذا هذا النص يشبه قلائد الذهب
* لأنه مكتوب بروح صافية،
* لا تزييف فيها.
* لأنه يزاوج بين الرمزية العالية واللغة اليومية.
* لأنه يملك بُعدًا وجوديًا عميقًا
* يلمس القارئ في مكانه الأكثر وجعًا :
* غياب الأب - الوطن - المعنى.
* لأنه يقدم صورًا شعرية “تُدَحرج الدموع من أعماق القلب”
وتبقى عالقة في الذاكرة.


 نداء الحكمة قراءة معاصرة في فكر إخوان الصفا .
نداء الحكمة قراءة معاصرة في فكر إخوان الصفا .
 قراءة نقدية وفق مقاربة ميتاشعريَّة في قصيدة: “نهرٌ تعرَّى من الماء للشاعر نمر سعدي
قراءة نقدية وفق مقاربة ميتاشعريَّة في قصيدة: “نهرٌ تعرَّى من الماء للشاعر نمر سعدي
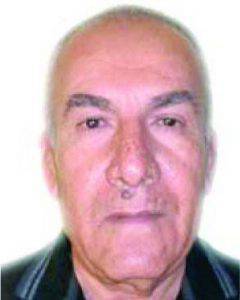 قراءة في دراسة شخصية الفرد
قراءة في دراسة شخصية الفرد
 قراءة في الإنتقال إلى إقتصاد السوق
قراءة في الإنتقال إلى إقتصاد السوق
 رائعة مدني النخلي..قراءة نقدية
رائعة مدني النخلي..قراءة نقدية
 قراءة نقدية ثلالثية الابعاد في خطاب التمرد الشعري الاديب سليمان أحمد العوجي
قراءة نقدية ثلالثية الابعاد في خطاب التمرد الشعري الاديب سليمان أحمد العوجي
 قراءة في مجموعة هدير الجبوري القصصية (خطوات وذكرى)
قراءة في مجموعة هدير الجبوري القصصية (خطوات وذكرى)
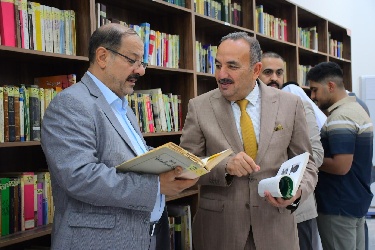 الفلوجة تشهد ساعة قراءة بحضور نخبوي
الفلوجة تشهد ساعة قراءة بحضور نخبوي
