

جيل الطيبين .. التاريخ يكتب نفسه
عماد المعيني
كثيرا ما نسمع عن جيل الطيبين من عاش شبابه فترة السبعينات والثمانينات باعتباره جيلاً طيباً وراقياً وناجحاً وغالباً ما تذكر هذه المفردة عند المقارنة بين هذا الجيل ومن تبعه من الاجيال الاخرى ومن المؤكد لا تعني هذه المقارنة بعدم طيبة الاجيال اللاحقة بقدر ما تعني التقلبات الحادة في الكثير من سلوكياته ومن المؤكد لها اسبابها .
وحين ننظر الى مكونات المجتمع لتلك الاجيال نجدها ذات المكونات من اب وام واخوة وجيران واصدقاء وزملاء, ومن المنطق ان تكون ذات النتائج حين تكون ذات المكونات, ولكن حين ندقق بتلك النتائج وفق الظواهر والمعطيات نجدها تختلف بشكل كبير عما سبقها. وبتحليل بسيط نجد ان السلوكيات الغريبة والمستهجنة لا تستفحل عادة سواء في الفرد او المجتمع الا بضعف وسائل الوقاية والحماية منها , وحين نقول وسائل وليست وسيلة واحدة هذا يعني ان ضعفت احداها اضعفت الاخرى بقدر معين, فحين تكون وسائل الحماية تبدا من الاسرة المتمثلة بالمتابعة الدقيقة للأب لسلوك اولادة والرقابة الصارمة للأم وابلاغ الاب بكل سلوك غير متزن من اجل الـتأديب, وما ان يخرج الابن من بيته حتى تتلقفه الوسيلة الثانية حيث الجار الحريص على ابناء جاره والمتابع والمحاسب لهم وكأنهم اولاده ويشعر هذا الابن بذات الرهبة من والده حين يرى جاره, ثم الوسيلة الثالثة المتمثلة بمدير المدرسة تلك الشخصية الرهيبة المخيفة التي ان تبسمت لنا وكأننا ملكنا الدنيا ومافيها والمدرسين اللذين حقاً ترجموا في سلوكهم معنى التربية والتعليم, فلا عطف مع الاهمال ولا مسامحة مع التقصير ولا اعتبار لأحد مع التقاعس.
وبنفس الطريق المحفوف بتلك المحاذير والممنوعات نعود الى البيت ولا يتجرأ احد ان يسأل عن نوع الغداء او تسول له نفسه ويمد يده على الطعام قبل جلوس الوالد ومن الكبائر ان نطلب من الاب مبلغاً غير (اليومية) التي لم تتغير الا بالانتقال من مرحلة دراسية الى مرحلة اعلى, لنبدأ مباشرة بعد الغداء متابعة واجباتنا الدراسية ليس حباً بها انما لنحصل على موافقة العائلة المالكة على الذهاب وقت العصر للعب كرة القدم, وابن امه الذي يدخل البيت بعد المغرب.
مراجعة الدروس
وما هي الا ساعة من الزمن ليحين وقت العشاء الذي لم نسال ايضا عن تفاصيله ثم نبدا مراجعة دروسنا على عجل لناخذ بعض الوقت مع التلفزيون الذي نعرف مافي القناتين 9 و 7 على مدى الاسبوع كله ونعرف توقيتات البرامج التي نحبها برغم ندرتها وكان اقدسها الرياضة في اسبوع .
ولا ندري لماذا كنا نسمع في اليوم مئة مرة كلمة (عيب), ومن تلك المعيبات ان تأكل قبل الاب او ان تقف في الباب او في رأس الشارع او تتحدث بحضور الكبار او تقرأ في سطح الدار او لا تساعد جارك بحمل الاكياس عنه او تضحك بصوت عال او تناقش او تعترض.
واذكر ان والدي رحمه الله قد منعني ذات مره من التواصل مع احد الاصدقاء رحمه الله لأنه وجده واقف عند موقف مصلحة نقل الركاب وحين سالته عن السبب قال لأنه ( سرسري) وهذه التسمية يقيناً لن ترفع عنه لو حفظ القران كله بعد ذلك.
واذا صادف ان قام احد الاصدقاء بالتحرش بأحدى بنات المنطقة ولو بنظرة نفر منه كأنه مصاب بالجرب او بكورونا هذا العصر خشية ان يصل خبر لأهلنا وحينها لن يصدق احد اننا لا علاقة لنا لو تعلقنا بستار الكعبة.ولا اتذكر ان احداً قد نصحنا او علمنا كيف نكون على خلق وادب بل هي الدنيا كلها كانت على خلق وادب فلا نحتاج من يحذرنا لأننا لم نصادف ما يستوجب الحذرحين كانت الدنيا كلها خير والناس كلهم ( من اهل الله) ولكن.. حين تنهار كل السدود مرة واحدة سيغرق الناس كلهم, وتهدم كل الصروح الخالدة وتطمس كل المتاحف العزيزة الغالية, فلا يظل منها الا الرسم والذكريات التي نقصّها على من لا يرغب في سماعها. وهذا ما حدث كله دفعة واحدة , وهنت منظومة الاسرة وحيّدت منظومة الجار وهمّشت منظومة المدرسة وتخلت منظومة الدولة, واستقوت منظومة الانتماء العرقي والطائفي والعشائري, وهنا الكارثة التي لا يمكن ان نعرف متى تنتهي ولا يمكن ان نتنبأ بالخسائر المترتبة عليها. فيأتي رجل الدين يفتي بفهمه الذي استقاه من مصادره الخاصة التي اغلبها لا حقيقة لها ويوجه العوام الى حيث يريده هو لا ما يريده الله لأن ما يريده الله واضح وبيّن مرتكزاته المحبة والالفة والتسامح وفعل الخير وبث روح الأخوة والتعاضد اما الواجبات الشرعية فلا تحتاج الى رجل دين, بل اصبح مقياس رجل الدين المؤثر في سلوك العوام هو الذي يعرف كيف يشحن العواطف ويثير ما في النفوس ويروض العقول حين يتكلم فيما يريده الجالسون ويرغبون سماعه لا ما يريده الله ان يسمعوه ولا ضير ان استشهد بامور ما انزل الله بها من سلطان ومن ثقة هذا الرجل بنفسه ان يشتم او يلعن فيخرج من تحت عباءته جيل لا يرى عيباً في السب او مثلمة في الاخلاق حين يشتم ومكمن هذه الكارثه لا يوجد من يقوّم رجل الدين هذا او يمنعه من اصحاب القرار او المؤثرين عليه.
خارج المائدة
واصبحت الاسرة اشبه بالنزلاء في فندق سياحي لا يلتقون الا على مائدة الطعام, نصفهم جالس والنصف الاخر قد بعث بأكله عن طريق الدلفري, وان جلسوا خارج المائدة فكل واحد مشغول بهاتفه لا يتكلمون بحرف وان سأل الاب يكون الجواب معه بكلمة سريعة وان تكرر السؤال امتعض الابن لأنه شغله عن اللعبة التي بين يديه او محادثته مع صديقه المشغول عن ابيه ايضاً وبنفس الطريقة. ومن غرائب وعجائب الزمن ان يعود الولد الى البيت بساعة متاخرة من الليل ويكفي الجواب لو سأله ابوه انه كان مع اصدقاءه, ولا توجيه اكثر من ان يأخذ معه مفتاح الدار في المرة القادمة, فلم تعد لرهبة الاب جذوة في نفس الابن ان يعود متأخراً, ولا يهم ان يلمحه الجيران من خلال الكاميرات التي تملىء البيوت, والتي اصبحت مهمتها مراقبة الجيران اكثر من حماية البيت.
وكلنا نعلم من خلال مانسمعه او نقرأه عن تجارب الدول التي مرت بنفس ظروفنا من حروب ودمار وجوع وعوز وانهيار اغلب النظم الاجتماعية ان تكون الدولة هي الوحيدة التي تستطيع ان تعيد الامور لنصابها لأنها تملك القوة والسلطة والنفوذ من خلال اساليب الردع بسن القوانين التي تحمي مكونات المجتمع وتحافظ على مرتكزاته وثوابته من النيل منها, فلا قوة للمدرسة بضعف الدولة ولا سطوة للمجتمع بضعف اجهزة الدولة الرقابية, بل اصبحت الدولة احياناً في موقع المتهم امام المواطن الذي يملك سلطة تفوق سلطة الدولة من خلال نفوذه او مسماه او انتمائه .
وربما تضعف الدولة في فترة من الزمن تحت وطأة ظرف معين ولكن ما ان ينجلي حتى تعود لقوتها وتعيد الامور لنصابها وغالبا ما تكون هذه الفترة محدودة جداً, ولكن حين يستمر الضعف والوهن لفترة سنوات طويلة من الزمن فهذا لا يدل الا على ان الدولة هي سبب هذا الضعف او انها لا تملك القدرة والمبادرة على التصحيح والتقويم, فإن كانت هي السبب فلا تصلح ان تقود وان كانت لا تملك القدرة فلا يحق لها ان تستمر بالقيادة, وهذا قد يحدث في الدولة ذات الانظمة المستبدة التي تسيّر الامور وفق اهواء الحاكم ونزواته, ولكن حين تمتلك الدولة كل السلطات الدستورية متمثلة بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مع توفير كافة مستلزمات القيام باعمالها بميزانيات تقترب من ميزانية الكثير من الدول فمن الصعب ان نستوعب هذا الوهن والترهل, ونحن في زمن لا مجال فيه لمزيد من الاخطاء والتجارب الفاشلة التي يدفع ثمنها المجتمع جيلاً بعد جيل.
امام الدولة بكافة مؤسساتها الدستورية مسؤولية قانونية واخلاقية ان تحافظ على كيان المجتمع من التشرذم والتشظي وان تعتبر شؤون البلد من مقدساتها التي لا اعتبار لأحد فوقها وتوفر للمواطن حياة يعيش فيها منعماً مكتفياً مطمئناً على مستقبل اولاده, ورب قائل يقول لم تأت بشيء جديد هذا الكلام قيل الف مره بما يكفي اوراق الشجر ورقاً للكتابة والبحر مداده, فأقول لنلقي عن كاهلنا حمل امانة النصح ولتبقى على اكتاف المتلقى امانة الوفاء بما اقسم عليه, واذكرّهم ببعض ما سمعناه من قسمهم ان يحققوا للمواطن حياة كريمة لا ان يزداد عدد المعتاشين على القمامة وان تحارب البطالة بتعيين المزيد من العاطلين وحملة الشهادات لا ان يصبح العاملين كمندوبين اكثر من ملاك وزارة العمل فمن المحزن جدأ ان يعمل طبيب الاسنان او الصيدلاني مندوبا لأحد المذاخر ويشترط عليه بيع كمية معينة كفترة اختبار له , او يتجاوز عدد المحامين المسجلين لدى نقابة المحامين اكثر من مئة الف محامي فاصبح المحامي الجديد يقف عند باب المحاكم يستعطف الداخلين بتمشية معاملاتهم مقابل خمسة وعشرون الف دينار, واذكر ان كل واحد فيهم اقسم على محاربة الفساد ولم تزل رائحته تملىء كل الاماكن وتزكم الانوف, واقسم ان يرفع كل الحواجز امام المواطن للوصول اليه لا ان يزيد في تضليل زجاج سياراته فلا نعرف من داخل السياره ان كان سيادته ام طفله الرضيع, واقسم ان يطوف على بيوت الايتام والارامل لا ان يطوف حول الكعبة فأن الله يحب ان يراه في بيت اليتيم اكثر من بيته, واقسم ان ينظر الى دول العالم المتطور ليقتدي به لا ان ينظرو الى جودة الاستثمار في عقاراتها, واقسم يان يكون متصدياً لا متصيداً ومتطوراً لا متورطاً .
اعظم ما في التاريخ انه يكتب نفسه بنفسه حيث لا متملقاً لسيده ولا قلماً مأجوراً يؤله فاسداً ولا تافهاً يبرر اخطاء التافهين ولا وضيعاً ترفعه عشيرته او ملته او حزبه, ستكتب الحقائق كما هي ويذكر الاشخاص بحقيقة افعالهم لمئات السنين, فاتركوا وراءكم ما يذكره التاريخ عنكم بما يتشرف به احفادكم حين يقرأون عنكم كما نقرأ عن عمر ابن الخطاب حين قال عندما تولى الخلافة مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم او قول الامام علي ظلم الضعيف افحش الظلم او قول غاندي ان القوة لا تأتي الا عن طريق الحق الذي يحميه القانون وقول جيفارا الذي باع بلاده وخان وطنه مثل الذي يسرق من بيت ابه ليطعم اللصوص فلا ابوه يسامحه ولا اللص يكافئه.


 المشهداني ينفي والتنسيقي يحسم الموقف: لا تأجيل للإنتخابات
المشهداني ينفي والتنسيقي يحسم الموقف: لا تأجيل للإنتخابات
 العالم .. يأكل نفسه
العالم .. يأكل نفسه
 مملكة الحرف.. أربعون ناقداً يكتبون عن تجربة كمال الدين
مملكة الحرف.. أربعون ناقداً يكتبون عن تجربة كمال الدين
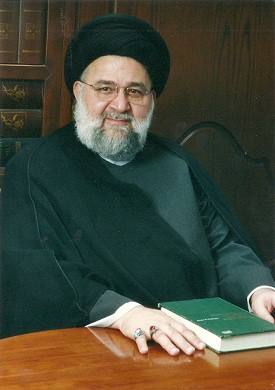 من التاريخ إلى الجغرافية
من التاريخ إلى الجغرافية
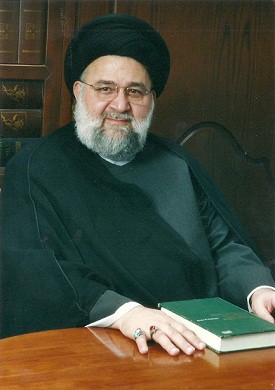 المجحفُ يُسقط نفسه مِنَ الأعين
المجحفُ يُسقط نفسه مِنَ الأعين
 تسجيل عودة 4500 لبناني إلى ديارهم
تسجيل عودة 4500 لبناني إلى ديارهم
 تمديد مهلة تسجيل المركبات ضمن المشروع الوطني
تمديد مهلة تسجيل المركبات ضمن المشروع الوطني
 تجوال في مركز بغداد التاريخي والثقافي
تجوال في مركز بغداد التاريخي والثقافي
