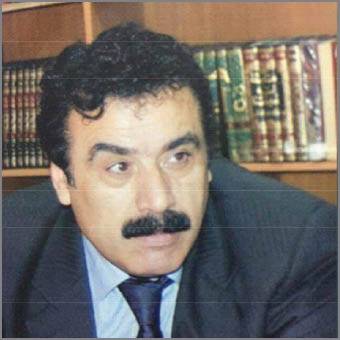

من عرصات الحظ والبخت إلى قناعات أهل القصور الفارهة ؟
مزهر الخفاجي
في ثلاثينيات القرن الماضي- العشرين بدأ زحف « قرويو العراق» المتوجعين من ضغط الفقر والجوع والعَوز، المُتضررين من نظام الإقطاع، الذي جعل أبناء العمومة عبيد. وهكذا بدأت بواكير الهجرة الأولى بأعدادها القليلة الى مراكز المحافظات خصوصاً الجنوبية، وبأعدادها الكبيرة الى العاصمة- بغداد من أجل الحصول على فرصة عمل والعيش بهناء والتخلص من المعانات، فضلاً عن وهج الأضواء التي سحبتهم إليها.
ما أنفّك جنوبيوا العراق من: ( الكوت والعمارة والبصرة والناصرية والنجف وكربلاء والديوانية والسماوة والحلة) الذين هاجروا الى بغداد بسرعة كبيرة الى ان يندمجوا بحياة القرويين الذين سبقوهم وسكنوا: ( الشاكرية والميزرة والكسرة) التي كانت شبه مستقلة عن مركز المدينة، والتي كانت بيوتاً من صفيح.
غرفة صغيرة
فضلاً عن اندماجهم مع سكان الأحياء الأصلية في العاصمة من أمثال: ( ابو سيفين وابو دودو وباب الشيخ والكاظمية و الكرادة)، وفيها اصبحوا مستأجرين لغرف صغيرة على الأغلب كانت في سطوح المنازل.
كانوا يحترمون طقوس وأدبيات سكان المدينة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يهضموها، ومن جانب آخر ان الحكومة لم تبخل عليهم، حيث استفاد ابنائهم من توفر فرصة الدخول الى المدارس للتعلّم ومن ثم الوصول الى الدراسة المتوسطة والاعدادية، وأيضاً الى الجامعات. طبعاً المحظوظين منهم.
لقد احتضنتهم المؤسسات التعليمية بحنوا الامهات الكبار. والغريب ان تقاليد سكان الريف قد أضفت على الحياة المدنية مِن مثل ما موجود في بغداد شيئاً من الغرابة. حيث تأثر نسق السكن عند سكان بغداد بنسق ( مفهوم السَلَفْ في الريف).
وهو ما يؤكد فرضية ان القبيلة لها شأن مساعد في الاستقرار، ولكنه، ونقصد هذا الدَور كان مهماً، وهكذا كانت تجمعات هؤلاء الفلاحين تأخذ شكل ( السَلَفْ) القرابي أو العشائري حتى المناطقي.
أحبَّ البغادلة، ونقصد أهل بغداد، هؤلاء الجنوبيون، لكنهم لم يرتاحوا لاعدادهم الكبيرة ولا لبعض طباعهم وتصرفاتهم حتى لهجتهم في التحدث، ووصل الامر الى عدم ارتياحهم الى لمسة الحزن التي كانت تضفي على سحناتهم ووجوههم.
وعلى الرغم من استغلال هؤلاء القرويون في محلات بغداد الصناعية والتجارية والأسواق، وخدمتهم لأهلها في مهن ( غير ذات شأن)، حيث توزعوا بين الاعـــــــــــــمال: ( الحارس و الكنّاس وفي اعمال خدمية اخرى). فضلاً عن تطوع الكثير منهم في سلك الشرطة والجندية.
جدير ذكره انه عندما يشتد الزعل بالبغادلة من كثرتهم وصعوبة الحياة التي يعيشونها يعيرونهم، كما هو شأنهم في التصنيف، أي التعليق بكلمات مستهزئين، وسموّهم باطلاق لقب: ( الشروگـيه) أو
( المِعدان) أو ( المشرگـه).
كل هذه التسميات لم تزعل السومريون الأوائل، ولم تمنعهم مِن أن يبحثوا عن حريتهم في بغداد ومراكز المدن الاخرى في العراق المختلفة. خصوصا في بغداد ازدادت الهجرة إليها مطلع الخمسينيات من القرن العشرين.
وقد حصل ذلك بعد اشتداد وطأة العَوز والفَقر والظلم في ظل تحالف النظام القائم حينها مع الاحتلال البريطاني والاولغيشارية المحلية الثلاثية، ونقصد: ( القبائلية والدينية وملاكي الأراضي).
فضلاً عن ازدياد ظاهرة تصحر الآراضي الزراعية ونقصانها بسبب الظروف المناخية وقطع المياه الواردة اليها من خلال الانهار الفرعية الواردة الى العراق، خصوصا المناطق الحدودية.
لقد شكلّت كل هذه العوامل بطرد الفلاحين في الجنوب، فشكلّت موجة هجرتهم الثانية لاهل الجنوب ( مُدن جديدة) ضايقت جغرافية بغداد، وشكلّت ما أطلق عليه بـــ ( حزام بغداد) أو بــ ( حزام الفَقر).
لقد صادفت هذه الهجرة الكبيرة مع انطلاق ثورة تموز في عام 1958، فكان شروگـيته ومعدانه ومشرگـته مَعيناً لثورة تموز وصمام استقرارها لسنواتها الخمس، مقابل رفض بغداد القديمة وأزقتها وأخلاصها للنظام الملكي ( 1921- 1958).
جدير ذكره يمكن ان يكون انتظامهم في الحزب بعد نظامهم القبلي الصارم وانتظامهم الجمعي في سَلف عشائرهم، كان له دَور مهم في الحياة السياسية الذي تمثّل في وجوه متنوعة كالدعم المادي لجهة سياسية ضد أخرى.
أو اشعال ثورة واضطرابات سياسية في منطقة ما، وتصويت وانحياز الى اتجاه سياسي معيّن. هذا الأمر هو الذي جعل الزعيم الجماهيري عبد الكريم قاسم ان ينتبه الى حجم راديكاليتهم.
وأن يُمارس شكلاً من أعمال الإنحياز من قبيل ( ابو دعير.. الكناية التي كان يلقبها قرويوا جنوب العراق على زعيمهم « عبد الكريم قاسم»). ممّا كان من الزعيم الى أن يشرّع في ترسيخ حزام الفقر، ويُنشأ مُدناً للفقراء، الذين ثار من أجلهم وأيدوه في ثورته.
فأسّس من أجلهم مُدن: ( الحرية والشعلة والعامل والبياع والزعفرانية والثورة)، فصارت بغداد مُحاطة لحزامين، من حزامه الاول الذي تمثل بالشاكرية والميزرة والوشاش والمنكوبين.
والحزام الثاني تمثل عبر المدن: الثورة والشعلة والحرية والبياع والوزيرية والألف دار. هذا الحزام البشري الجنوبي، الذي منه الفراتي والدجلاوي قد تعاملت معه بغداد بانتقائية مجتمعية عالية اتسمت بــــ:
1- لم تحتويه وان قبلوهم فيما بعد على مضض.
2- استثماره في سد الشواغر في مؤسسات الدولة، من خلال عزلهم في وظائف صغيرة
وحرفية خاصة، حتى وصل الأمر الى ان ابناء الجنوب كانوا نادراً ما يُقبَلون في الكليات العسكرية والشرطة والطب والحقوق.
وعلى الأغلب ان حجم مشاركتهم في قيادات الجماعة الوطنية أو في الخط الثاني.... الذي ييكاد أن يكون نادراً، وان يذهب بعض الباحثين الى القول، ان قلّة المشاركة أو انعدام الحالة إنما يعود الى فتوى دينية فحواها انها دولة مغصوبة، وليست دولة المعصوم.
والأمر الآخر، انما يعود الى غياب الوعي المجتمعي، الذي مارسته العوائل والعشائر، من خلال عدم دعمها لطموحات ابناء الفلاحين من أجل إكمال دراساتهم أو رغبتهم في تبؤا البعض من المناصب الادارية.
وربما كان السبب الأهم يكمن فيما يعانيه ابناء الجنوب والفرات من تجويع مارسه النظام الاقطاعي، وكذلك غياب الدولة الوطنية العادلة التي توفر لابنائهما الفرص المتساوية والعيش الكريم.
المهم ............ حزام الشرّ هذا
حزام الفقر هذا
حزام الجنوبيون هذا..........
المهم. ان هجرات قبائل حزام الفقر هذه بدأت منذ ثلاثينيات حتى خمسينيات القرن العشرين قد زاحمت أهل بغداد خاصة وان عرصاتهم ومحلاتهم القديمة من ابو سيفين حتى الفحامة ومن الداوودي حتى الوشاش عجّت بأحيائهم وضايقت وزاحمت معسكراتهم القديمة في الوشاش والمنكوبين وشطيط والشاكرية والميزرة والنهضة، التي كانت تزدحم بأفواجهم وتعج بصبيانهم.
اولاءِ الذين عُرِفَ عنهم اضفائهم بالعروة ورغبتهم في أنجاب الابناء بكثرة، فضاقت شوارع الباب الشرقي والنهضة والعلاوي وباب الشيخ والكرادة بالباعة من ابنائهم الذين جلّ المـگـاريد منهم.
وهم يبحثون عن موردٍ للرزق ثانٍ يعينهم على مستلزمات واحتياجات تكاثر الأفواه التي تبحث عن لقمة العيش، الذي تزامن مع انخفاض مداخيل أباء هذه العوائل، بسبب تعدّد حاجاتهم من أكل وشرب ومتطلبات التعليم ومستلزمات الحياة اليومية الاخرى.
وما ان أحسّ الزعيم عبد الكريم قاسم بتململ أهل بغداد الملكيّة من مضايقة الشروگـية الجمهوريون لهم، حتى فكّر في تأسيس مُدن الثورة والشعلة والألف دار وحي العامل والشعب والحرية والزعفرانية.... الخ.
فشرعَ قاسم بنشر مـــگـاريده على حزام بغداد الفقير، الذي احتضن الفقراء بمساحته، لكن الغريب وهو ما ذكره لي مدير مساحة بغداد، إن مدن أخرى ما عدى الثورة والشعب والشعلة والحرية... الى آخره.
وهي مدن من مثل: زيونة والبلديات وشارع فلسطين والمهندسين قد فرزت لها مساحة القطعة الواحدة من 300 حتى 600 متر، في حين لم تكن مساحة مدن الفقراء في حزام بغداد أكثر من مئة متر كمنطقة الألف دار، فضلا عن الثورة 140 متر.
بعد ان استوقفتني هذه المعلومة سألت مدير المساحة:
- تُرى لماذا هذا التفاوت؟.
أجاب:
- إنّه تمييز طبقي واجتماعي بإمتياز.
فأجبته:
- لكن الرجل... يساري / شعبوي / جماهيري / جنوبي الانتماء.
قال: لا.
وحين حاولت أن أقَلِبْ مبررات أن يمنح الزعيم قاسم المؤذن مع زوجته ارض في شارع فلسطين تبلغ مساحتها ( 300 متر)، في حين يمنح الزعيم نفسه نائب ضابط في الجيش العراقي مساحة ( 144 متر) في مدينة الثورة مع زوجته واولاده الخمسة كمعدل لتلك العوائل.
ورحت أبرر ذلك وفق خلفيتي التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية، فمرّة قلت ان عدد نفوس المهاجرين والوافدين من الجنوب والفرات كان كبيراً، حيث كانوا حوالي ثلاثة ملايين نسمة على أقل تقدير. وفي هذه الحالة الاراضي لن تتوفر لهم بهذه الكثرة.
شوارع مكتضة
لكن هذا الأمر لم يصمد، فلماذا تُركت مناطق قريبة من بغداد فارغة- خالية من البناء حتى السبعينيات من القرن العشرين على الرغم من البلديات شرقاً. حد صدر القناة والصليخ والكريعات شمالاً.ومرّة قلت، لا. ربما الرجل اراد انقاذ اهل شطيط والميزره وابو سيفين والوزيرية من هذا الحرمان، خاصة بعد أن كانوا يصفقون له في شوارعهم المكتظة بالباعة والفقراء من الناس.لذلك انتخى الزعيم كأي راديكالي لمنحهم هذه الاراضي من دون أن يَعي مقدار الضرر الذي سيلحق بهم في ظل هذا التوزيع العشوائي الغير عادل. أما القضية الاخرى التي فكرت بها هي محض خيال ثوري.هو أن الرجل كان يأمُل في أن نجاح قانون الاصلاح الزراعي وتطبيقه بشكل عادل يمهد الى تعافي الريف العراقي بعد الخلاص من الاقطاعيين والانتهازيين وملاكو الاراضي الذين اذاقوا الفلاحين الويل حين حولّوا ابناء عمومتهم الى عبيد.فضلا عن كونهم أداة بيد المستعمر. لذلك فكر الزعيم ان ذلك يمكن ان يعيدهم الى قراهم الخضراء ويسد نقص الايدي العاملة للفلاحة والزراعة وتربية الحيوانات، ومن ثم يُحقق الزعيم ما يرجوه من الاكتفاء الذاتي من الغلة في العراق. لن أسهب أكثر.. سَكّنَ وبَنى وعَمَّرَ للشروگـية والمعدان مدنهم الجديدة التي تزاحموا فيها على مقاعد الدراسة والوظائف والشوارع. لقد فكّر الزعيم في ذلك، وانه ومع مرور الوقت وبعد أن يتخرج ابناء المـگاريد من مدارس بغداد الملكية يمكن ان يتغير الوضع.
المدير العام وحسب المحسوبية والمنسوبية والطبقة الاجتماعية كان يخرج أو يُعين الكاتب او الرزام او ساعي بريد، في الوقت الذي فتحت الكليات العسكرية وكليات الشرطة أو الاختصاصات الأمنية الأخرى ليتخرج منها ضباط جيش وشرطة بكل صنوفها ومُدراء عاميين لكل الدوائر بمختلف انواعها.لم يحصل ابناء المدن ( مدن الحزام) الفرصة نفسها، إذ كانت أبواب هذه الكليات تكتفي بابناء بغداد والموصل وتكريت والانبار. إذاً فرصة اولاد المساكين كانت مغلقة بوجوههم حتى بعد الثورة.
وتدبير البعض هذا العامل لغياب الوعي الاجتماعي بهذه المناصب و للـــ ( الفُتيا) الدينية ان تحرمهم من الانخراط في هذه المؤسسات. ولا شك حتى ولو للحظة، ان البيوتات البغدادية والاوليغاريات الثلاث: القبائلية وملاكي الاراضي والمؤسسة الدينية، قد ساهمت بشكل فعاّل بهذه المواقع والمناصب لعوائلها.لا ريب ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي كان يعاني منها ابناء حزام بغداد قد جعلت عددا كبيرا من ابنائهم ان يتسربوا من المدارس او يعزفون عن الاستمرار فيها.
حيث ان ذلك تزامن مع شعورهم بعدم جدوى ما يبذلونه من جهد ووقت ومال من اجل ذلك، حسب نظرية ( السبع هو اللي يجيب لُـــگـمَه لأهله). وعلى حدِ قول أحد المـگــاريد:
- إنّ آباءنا تبرعوا بنا للعراق. وانهم لم يخلفونا لكي نكون قادة او زعماء او جنرالات.
فضخت في شوارع هذه المدن، الجندي والشرطي والحارس والكناس والجابي والسائق والمضمد وعامل البناء والحارس، بالمقابل كان اهالي بغداد الملكيين يضخون للشارع وفق منطق فيزياء مجتمعية وبيروقراطية حكومية وسياسية:
( المدير العام، الضابط، مدير الشرطة، الطبيب، المهندس، ومدير الناحية).
كل هذا لم يقطع سبيل المعروف بين بغداد الملكية وبغداد الجمهورية، ونقصد مدن حزام بغداد الفقيرة، الذين تسللوا الى مدن، حيث عاشوا بسلام ووئام:
الكاظمية- تجاور العـگيل وخفاجة وخزرج والتمايمه واهل الخالص.
الاعظمية ( الشماسية)- تجاور العزاوي.
الكسرة- تجاور السودان والحلفي والسواعد.
الوزيرية- تجاور آل ربيع و آل إزيرج وبني لام، فضلا عن الكروي والشمري.
الشيخ عمر- تجاور الصالحي والعباسي والجعفري والدوري والكربلائي مع الكعبي والعقابي
والحلفي.
جدير ذكره انه من الناحية الجغرافية فقد احترم اهل الشعلة تقاليد أهل الكاظمية، وان سكان الكسرة الجُدد لم يتجاوزوا على أهل الاعظمية بأي شكلٍ من الأشكال، حيث صار اهل الاعظمية يفهمون انه بسبب الجوع هؤلاء يقطعون شجرة الرارنج. فضلاً عن تطفلهم بعض الاحيان لان رائحة ورود حدائقهم كانت تستهويهم.
أما في الجغرافيا الاجتماعية الذي جعل زامل سعيد فتاح يقول:
نعيش للعراق
إحنه مرّه نعيش.... أو مره نموت
ولم نميز طائفته او عشيرته او منطقته وكان ابو عزيز في العلاوي ينشد فيها وهو من سكنة بغداد يغني للناصرية ابو جناغ- اريد وياك. وكانت قصائد شبابها المسكونون بالبغداديات تقطُر أدباً وتُبرر القطيعة.
فهذا المرواني، حسن في قصيدة أنا وليلى:
نفيتُ واستوطن الاغراب.... في وطني
ودمروا... كل أشيائي الحبيباتي
وهذا جبار الغزي الموهوم بعاطفته التي أدمنها:
يــگـولون غني بفرح
وآنه الهدم هواي
وهذا شمران الياسري ينشد صارِخاً:
زغيره وما تعرف اتحب
نعم. لقد قيل كل هذا من اهل بغداد الملكية وبغداد الجمهورية. وفيها قد حرص سكان مدن حزام بغداد وفق منطق عقلاني وانساني وتلقائي ووعي صارم بنتاجاتهم هذه، وفيها تعاهدوا على ان يحترموا رموز وثقافة وتقاليد وحدود وقيَم البغادلة!!.
إذن لم يُعكروا تقاليد الشارع البغدادي إلا في بعض النواحي، ومنها، تم استبدال بعض الكلمات المتداولة بين البغداديين مِن مثل:
خويه / بدل أخي
أخيتي / بدل باجي
مامش / بدل ماكو
كويك / بدل زين
غموس / بدل غرز
چـا ليش / بدل ليش
وبدأ سكان بغداد يتضايقون من زي الصايه والــچـاكيت والعـگـال، الذي بدأ يُزاحم الزي التقليدي لهم، الــچـاكيت والبنطرون والسدارة. وعلت أصوات، حضيري ابو عزيز وداخل حسن وجواد وادي وعبد الصاحب شراد وعبادي العماري وسيد محمد بدل المؤدين الذين تعودوا على سماعهم من مثل:
محمد القبانـچـي ورشيد القندرچـي ويوسف عمر وناظم الغزالي وسليمة مراد وزهور حسين وصديقة الملاّية.
نعم. ادرك هؤلاء الجنوبيون ان للمدينة عاداتها الخاصة بها وللحكومة قوانينها الخاصة بها ايضا، فما عليهم إلا أن يحترموا ذلك لكي يجنبوا انفسهم الملامة والتقريع ويحصلوا على ( السِتر والعافية).
لذلك لجأوا الى استعارة العيش وفق منطق ( العشيرة- السَلف). وهكذا حجزت الافخاذ والبيوت أزقة وشوارع هذه المدن. وإذا كان للدولة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية.
فقد كان لأزقة وقطاعات وشوارع مدن كالثورة والشعلة والحرية والشعب وغيرها من مدن الحزام نواميسها الخاصة بها. فقيل، ان تغيب الشمس كان لدواوين هذه المدن مثبتة على شوارع المدن وبسطهم ومخداتهم ومهفاتهم وشايهم وقهوتهم تملأ شوارع مدنهم حياةً وصخبا.
فكانت دواوينهم الواقعة على قارعة الطريق، او في غرفهم المزدانة بالسِبَحْ ورائحة القهوة، التي يسمونها ( مدارس) بجمرها وبقيم قبائلها او بأخلاق المضيف، فكان كِبار القوم أو عليتهم، الذي كان من الممكن ان يكون في وظيفة ( حارس حكومي) مثلاً. وهو شيخ قبيلته او كبيراً لأحد أفخاذهم. يوصي اولاده والسَلف المحاط حول بيته، يوجههم قائلا:
- شلونك باليخبط.. جبرهه بيده وايد تعصر لگـمه بكل الحلوگ... آنه الماريده... گلبي ما يريده... واذا رف گلي... اشعله من العروگ... اخوتي اياكم والعيبه... تره تثلم كل تاريخ اهلنه وتسوون شرخ بگلوب البغادله!!.
وفي ديوان لعشيرة اخرى من مدن الحزام المحيطة ببغداد ما زال الشروگيه يحتفظون بثقافتهم وتقاليدهم الريفية. فقد تسمع صوت احدهم معاتباً أخاه بأبوذيه:
ويزود: تره اليحـچـي ما يلف ويدور
ويزود: ويزمخ زمخ بالديوان
ويزود: أخوي الماذكرني بماي
ويزود: باچـر بالكبر لا يوگف عليّه؟؟؟
واخبار مضيف آخر: عجوز طاعن في السِن ينصح ابناء عشيرته:
- وِلديْ
منو گللك الزنگين والفقير سواسيه، لا ابني.. نعم همّ سواسيه عد الله، فقط بالدنيه مو سواسيه، الزنگين ياكل حته يضوگ والفقير ياكل حتى يسد جوعه. و الزنگين يلبس علمود يتزين، والفقير يلبس علمود يسد عورته، الزنگين ينام يتمتع بيه، الفقير ينام حتى يرتاح من التعب.
ولدي مسامعين اليغنون من يـگولون:
أنه مهموم... واصبح مستعد لهمّ!!
هذوله احنه المساچـين الشروگيه.
نعم. كانت الثقافة القبلية تتمتع بتجدد لتقديمها للحاضنة الجديدة، اي تقديم القيم كما يقول الباحث عبد العزيز الحيص ويشاركه في ذلك خلدون حسن النقيب الذي نضيف:
تجود الثقافة القبلية بمزيد من الاهتمام والتركيز، ومشكلة العرب، مدناً ودولاً، بدواً وحضراً تكمن في ظاهر تنامي علاقات التشكل المجتمعي اكثر مما هي مشكلات المجتمعات فبنية العلاقة وشبكتها في الوقت الحاضر تتمتع بانماط تقليدية.
وقديما كانت حيوية، في زمان ومكان معين، كل هذه الروابط صارت معرقلة ومعطلة اكثر مما هي معينة ومساعدة لفكرة الاندماج او الذوبان في المجتمعات الحاضنة. وعلى الرغم من هذا البَون الشاسع في نمط سلوكية وافكار وثقافة وذائقة المجتمع.
لكن كل منهما قَبِلَ الآخر، فأصحاب ( الحظ والبخت) بعرصاتهم الهرمة وبيوتهم الزقاقية المزدحمة وبَسطاتهُم المنتشرة على أرصفة شوارعهم غير المبلطة، المليئة بما لذّ وطاب من تراب وذباب.
لمْ يغِبْ عن بالهم انهم ضيوف، وفي الوقت نفسه أهل الوطن الذي خدموه لمدة تزيد على المئة عام ونيف بالموارد البشرية مضحين بالدماء آباءاً وأبنائاً وأحفاداً متصلة بما قبل هؤلاء من أجله.
متناسين ما عانوه من حرمان وغياب عن العدالة حرمتهم من حصولهم على عيشٍ كريم. فقد تأخر عنهم قانون الاصلاح الزراعي، وانحازت سلكات الحكومة للاولـگاريات القبيلة وملاكي الاراضي.
فضلاً عن حرمانهم من سُبل العيش الكريم في بغداد، ولكن مع كل هذا كوفؤا بــ ( 140 م) ومدن الحزام التي ينظر اليها البغادلة الطيبون على انها يمكن ان تليق بهم اي انهم غير مقتنعين بذلك.
لقد خدم الكثير منهم السلطات في نظام الخدمة الالزامية، فكانت مدنهم مثل الناصرية، التي تسمى مدينة المليون نائب ضابط، ومدينة الثورة التي سميّت ( مدينة الفراريه)، والشعلة التي سميّت بمدينة النـگريه وهلم جرا بأمثال تلك التسميات.
لكن مدن حزام بغداد وأبناءها من الهاربين والبريكيه والبزاخه والنـچـاخه، في مدن الـگـياره والداخل ومريدي وحي الاكراد والحرية والشعب والميزره والشاكريه وشطيط والمنكوبين والبياع والوشاش.
هؤلاء كلهم اصبحوا قرابين وطن تبرع بهم في كل حين، حيث كانوا منذ العام ( 1948) في مقدمة تلك القوات، وابنائهم عنفوان اسماء آبائهم الشروگـيه الشهداء، لكنهم لم يعرفوا بأي زاوية من زوايا فلسطين، في التي سالت فيها دمائهم أو مكان دفنهم. التي دفنوا فيها مثل جنين ونابلس او طولكرم.
وايضا كانت ساحات بغداد تملأ بساعات من قبل اهل الغيرة من ابناء بغداد الشروگيه استنكاراً للعدوان الثلاثي على مصر، أو رفضاً لاستقالة الرئيس المصري جمال عبد الناصر عام 1967، فضلاً عن مساندة الثورة الجزائرية وتخليدهم لجميلة بوحيرد.
فضلاً عن رفضهم لتطبيع العلاقات مع اسرائيل من قبل الرئيس التونسي ابو رگيبه، وهم وليسوا غيرهم كانوا في مقدمة من حث الخُطى للدفاع عن دمشق في حرب تشرين / اكتوبر في العام 1973.
وساهموا ايضاً في قتال الأخوة العرب والكورد التي كانت تفتعلها الانظمة المتعاقبة من اجل مصالحها الخاصة في كوردستان العراق، التي لم تكن لهم الطرفين فيها أي يد، بل دفعوا الاثمان.
وقد انطلت تلك الاكاذيب على الناس البسطاء حتى وصل الامر الى ان بعض أمهات احد الجنود المگاريد ان تقول:
طرگاعه اللفت برزان... بَيَس بأهل العماره
وهم وليس غيرهم. نعم ابناء حزام بغداد الجمهوريين قاتلوا الجارة ايران دفاعاً عن العراق كما ادّعت سلطات النظام السابق، وكانت نسبة شهدائهم قياساً الى شهداء العراق كلّه نسبة كبيرة جداً.
وكان الشهيد المگرود حين يجلبوه مخضباً بدمائه تردح أمّهُ قائلة:
يَمْ الواحد... لا تبـچـين
الموت من الله مقيد!!.
نعم. هم كانوا يستلمون جثث مگاريدهم الواحد تلو الآخر، يقدمونهم قرابين للوطن، الذي لا يعرفون فيه شيئاً سوى ( محفوظ- بيگ- باشا- سيدي). ومن حقوقهم الاجتماعية والقانونية لا يحصلون على سوى:
شروگي
معيدي
مسكين
هارب
جاهل
جوعان
موالي
لن أكون عاطفياً كثيراً، حين أعترف أني منحازاً لمگاريد حزام الفقر واهله، الذين ظلت بهم السُبل سياسياً واقتصادياً واجتماعيا. لانهم اصبحوا ضحية مركزيات ثلاث كما يقول الدكتور عبد الله ابراهيم:
- النصوص الجاهزة.
- تاريخ المأزومين والمنتصرين.
- تراث قبلي مُنفر للوعي المخلص لغايات التسطيح الذي يحوّل الافراد الى عبيد من خلال
نشر انماط ثقافات اجتماعية بالية أكل عليها الدهر وشرب.
نعم. كان اهلي من مگاريد الجنوب والفرات، حتى الذين التحقوا بهم اواخر الخمسينيات من القرن العشرين من الكورد الفيلية.
نعم. لقد كُنّا أسارى اولگاريات ثلاث: شيوخ القبائل و رجال الدِين وملاكي الأراضي. ومنذ العام 1921 حتى الآن خذلتهم السلطات الحاكمة، حيث انهم على الدوام في تاريخهم السياسي منحازين لما ذكرناهم. كونهم اسهل عند الانقياد لهم.
وقد تورطت السلطات العراقية في حرمان الاغلبية الاجتماعية التي تكوّن 85 % من سكان العراق، الذين هم من الفلاحين والكادحين من أبسط حقوقهم، والقصد هنا العيش الكريم والسكن الملائم ومورد رزق يكفي للبقاء على قيد الحياة.
هذه السلطات التي أخلّت بعقدها الاجتماعي مع الناس وتحديداً مع فقرائها في الشمال والوسط والجنوب. والغريب ان الجماعة الوطنية كانت ترفع شعارات تغازل بها فقراء العراق عامّة.
إلا أنهم عاملوهم بأسوء من معاملتهم من قبل المحتلون وتمسكهم بما تسميهم بالاشراف واهل العامة والمعدان، وكرست بعد ان تمكن ما يسمى وطنييها الوزارات تلو الأخرى الى فعل الخذلان والخيانة لمدن الكحلاء والغراف وابو الخصيب والعشار وقلعة سكر والشطرة والحي والشامية والقاسم والشوملي والكوفة والشامية.
يذكر الدكتور احمد الخشاب في كتابه ( حاجات المجتمع):
- « إذ يعتبر أهل علم النفس الاجتماعي، خاصية أساسية تتميز بها الحياة الاجتماعية، لانها
سبيل بقائها وعزها وهذا يتهيأ عن طريق التوافق مع الواقع الذي يحقق التوازن
والاستقرار الاجتماعي عن طريقه وتواجه متطلبات افرادها وحاجاتهم المتجددة».
ان التغيير الاجتماعي الذي
فشلت فيه الدولة وفعالياتها الاجتماعية الاخرى في المسك بملامح تغيير مجتمع حزام بغداد الجنوبي تمثل في، حتى وان بدى هذا المجتمع ساكناً مستقراً سائراً في العيش في تفاصيل قوانين حياته طوال أجيال متعاقبة.
لكنه حتى يصل الى درجة من التجمع المجتمعي وتزداد مكانته ومعرفته بكواليس الحياة ويغامر في استثمار حريته وقدراته الى حدّ الغوص، وقد يستهدف هذا التغيير غير المتوازن مع قابليات وقدرات وامكانيات هذه المجمعات الى شكلا من اشكال ( الهياج- التمرد).
او القيام بثورة على منظومة القيم ومنها قيم الدين والعشيرة. ويظهر هذا التغيير من خلال تبني وعي يغير كل قوانين المجتمع لصالحه، وهنا يحل عقد قائم على ثــــــــــلاثية ( وطن- شعب- نظام حكم) الى ثلاثية ( سلطة وقوة ومال).
ويحل بدل الوعي، التسطيح. وبدل التنافس، مبدأ الخداع والتزوير، وبدل الديمقراطية، دكتاتورية، لذلك لن اذهب بكم بعيدا، فأقول:
ان اهل الاعظمية في بغداد عاشوا مع الشروگيه متجاورين ليس لانهم شغيلة او عمال شطار او اهل معشر، بل لانهم اهل حظ وبخت. واهل الكسرة احبوا اهل الوزيرية ليس لانهم باشوات القوم.


 قاتل الصدر الأول بقبضة الأمن بعد عملية إستدراج من الخارج
قاتل الصدر الأول بقبضة الأمن بعد عملية إستدراج من الخارج
 الشيخ عبد الواحد ال سكر وثورة العشرين : ما أسباب تقديم موعد ساعة الصفر للثورة من 2 تموز إلى 30 حزيران ؟
الشيخ عبد الواحد ال سكر وثورة العشرين : ما أسباب تقديم موعد ساعة الصفر للثورة من 2 تموز إلى 30 حزيران ؟
 عملية طارئة لإستخراج عملة معدنية من أحشاء طفلة
عملية طارئة لإستخراج عملة معدنية من أحشاء طفلة
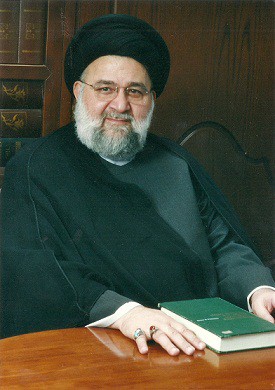 من غرائب القوافي
من غرائب القوافي
 مواطنون يدعون إلى إجراء تأهيل الطرق أثناء الليل
مواطنون يدعون إلى إجراء تأهيل الطرق أثناء الليل
 فريق تعبئة وخدمات الغاز يقدّم الدعم الفني للتحميل من الحلفاية
فريق تعبئة وخدمات الغاز يقدّم الدعم الفني للتحميل من الحلفاية
 النقل: مضاعفة رحلات التفويج العكسي إلى مطاري بغداد والسليمانية
النقل: مضاعفة رحلات التفويج العكسي إلى مطاري بغداد والسليمانية
 تراجع عن إعفاء مسؤول أمن الحشد بعد ردود أفعال غاضبة
تراجع عن إعفاء مسؤول أمن الحشد بعد ردود أفعال غاضبة
