
أصداء القصدية: اعادة خلق المعنى في الترجمة
عادل الثامري
المقدمة
الترجمة فعلٌ قصديٌّ أدائيٌّ يُعيد بناء المعنى النصي، لا تمثيله. تنبثق هذه العملية من التفاعل بين نية المؤلف، وقصدية المترجم، والسياقات الثقافية الشاملة، مُنتجةً واقعًا نصيًا مُحوَّلًا. تواجه دراسات الترجمة الحديثة أسئلةً تتجاوز الإشكالات التقنية للنقل بين اللغات، لتركّز على التفاعلات بين الذوات المنتجة للمعنى. ففي ظل تزايد الاهتمام بالقصدية كإطار فلسفي لفهم العلاقات بين الفكر واللغة والعالم، تظهر الترجمة كفعل تأويلي قصدي، وليس مجرد تحويل لغوي محايد. يسعى هذا المقال إلى مساءلة العلاقة بين "نية المؤلف" و"قصدية المترجم"، وتحليل التكوين المركب للمعنى أثناء الانتقال من النص المصدر إلى النص الهدف. وعبر تأطير الترجمة كعملية تفاوضية تشمل طبقات قصدية متعددة، نقترح فهمًا لإنتاج المعنى لا يحصره في نية او قصدية أحادية، بل ينظر إليه كتجسد لفاعلية متعددة: مؤلف ومترجم وسياق ثقافي. ينطلق هذا المقال من المفاهيم الفلسفية للقصدية كما طُورت في الفكر الظاهراتي وما بعد البنيوي، لتُعيد تموضع المترجم بوصفه فاعلًا تأويليًا يُعيد خلق النص في ضوء بنى ثقافية وأنظمة دلالية متشابكة. هكذا، تتبلور الترجمة ليس كفعل تابع، بل كموقع خلاّق لإعادة تشكيل المعنى وإنتاج واقع نصي جديد.
من المؤلف الى الترجمة
ينبثق المعنى من المؤلف، الذي تُرمِّز نواياه المحتوى الدلالي والتداولي الأولي للنص المصدر. تظهر النوايا الواعية في الأهداف الموضوعاتية الصريحة التي توجه التأويل. كما تؤثر العناصر اللاواعية، مثل الافتراضات الثقافية المضمرة التي تعكس السياق التاريخي للمؤلف، على المعاني الكامنة في النص. فعلى سبيل المثال، قد تُطبع آراء روائي من القرن التاسع عشر ،غير المعلنة ، عن الطبقة الاجتماعية عملية بناء الشخصيات والبنى السردية دون قصد صريح. تشكل هذه النوايا التأليفية المتنوعة التضاريس الدلالية المعقدة التي يواجهها المترجم.
من هذه النقطة، تتدخل قصدية المترجم ذاته، متشكلة بفعل عوامل لغوية وثقافية وموقفية مميزة. فعلى سبيل المثال، تتطلب ترجمة لغة تُميز نحوياً بين ضمير "نحن" الشامل والحصري اتخاذ خيارات مدروسة تعيد تشكيل الهوية الجماعية داخل النص الهدف، وهي قرارات لم يواجهها المؤلف الأصلي. وبالتالي، فإن الموقعية الخاصة بالمترجم تشكل المعنى بفعالية بدلاً من مجرد نقله.
تعريف القصدية
يعمل مفهوم القصدية على مستويين متمايزين ومترابطين ضمن الخطاب الفلسفي. على المستوى الأول، تشير النية إلى هدف أو خطة محددة وواعية، حالة ذهنية إرادية موجهة نحو فعل أو نتيجة مستقبلية تنبثق من العمليات الادراكية المتعمدة. وعلى المستوى الثاني، الأكثر جوهرية، تشير القصدية إلى القدرة الكامنة للعقل على التوجه نحو أو عن الأشياء والأحوال في العالم، وبذلك تشكل ما حدده برينتانو على انه خاصية 'الاشتمالية' المميزة للظواهر الذهنية. تتجلى هذه الخاصية الاتجاهية للوعي عبر عمليات ادراكية مختلفة، بما في ذلك الإدراك والاعتقاد والرغبة والتأويل، وهو ما يؤسس القصدية بوصفها الخاصية الأساسية التي تمكن الحالات الذهنية من امتلاك محتوى دلالي ومعنى مرجعي.
طور جون سيرل هذا التمييز عن طريق التفريق بين 'القصد المسبق' و'القصد-في-العمل'. يمثل 'القصد المسبق' هدفاً شاملاً ومدبراً مسبقاً، مثل الخيار الاستراتيجي للمترجم في اتباع التغريب. في المقابل، يشمل 'القصد-في-العمل' القرارات الفورية، وغالباً الحدسية، التي تتخذ أثناء فعل الترجمة. يكشف هذا المفهوم الأخير كيف تحمل حتى الخيارات المعجمية أو النحوية المحايدة ظاهرياً ثقلاً قصدياً، وتنتج تراكمياً المعنى العام للنص المترجم. يسهل هذا الإطار النظري تحليلاً مفصلاً لعاملية المترجم التأويلية على المستويين الكلي والجزئي معاً.
يدافع إ. د. هيرش عن موقف هرمنيوطيقي تقليدي يرى أن نية المؤلف تشكّل المصدر الشرعي الوحيد لتحديد المعنى الصحيح للنص. وبحسب هذا المنظور، فإن استعادة ما نواه المؤلف—بوصفه ذاتًا متماسكة وواعية—تُعدّ أساسًا لفهم النص وضمان استقراره الدلالي. لا يكتفي هيرش بهذا الادعاء، بل يربط مشروعية الفهم التأويلي بإمكانية إعادة بناء نية المؤلف الأصلية، معتبرًا أن المعنى ليس متاحًا إلا عبر استحضار تلك النية المرجعية التي تمنح النص وحدته وتماسكه. غير أن هذا التصور يواجه اعتراضًا جذريًا من التيارات ما بعد البنيوية، التي تقوّض مركزية المؤلف بوصفه سلطة معرفية مطلقة.
القوى الثقافية وفاعلية المترجم في إنتاج المعنى
تعمل السياقات الثقافية كعوامل فاعلة في إنتاج المعنى النصي، إذ انها تُشكّل الأعمال الأصلية وترجماتها على حدّ سواء. وتُمارَس هذه القصدية النسقية عبر منظومات ثقافية، تتألف من اللغة والأعراف الاجتماعية والعلاقات السلطوية والظروف التاريخية، تقوم بتوجيه القصدية الفردية والتأثير فيها، لا بمجرد احتوائها أو تقييدها.
هذه المنظومات الثقافية لا تكتفى بوظيفة الوسيط أو الخلفية، بل تعمل كبُنى منتِجة للمعنى، بما يشبه ما يسميه بعض المنظرين بـ"القصدية الموزّعة" أو "القصدية النسقية"، حيث تتخلل قيمُها وتوجّهاتها النصوص، فتُعيد صياغة بنيتها وتلوينها دون أن يُدرك الفاعل الترجمي (المترجم) دومًا ذلك.
فعلى سبيل المثال، تُظهر الترجمات التبشيرية للنصوص المقدسة ابان الحقبة الاستعمارية كيف أن القصدية الثقافية تتجاوز مجرد التحويل اللغوي. إذ إن اختيارات المترجمين للمفردات، والاستعارات، والتقنيات الأسلوبية كانت غالبًا انعكاسًا لبُنى السلطة المهيمنة وأهداف الهيمنة الثقافية، مما أدى إلى تشويه المعاني الأصلية والجماليات الثقافية للنصوص المصدر.
ضمن هذا الإطار النظري، قدّم إيتامار إيفن-زوهار مفهوم النسق الترجمي ، مؤكدًا أن الترجمة لا تقع خارج النظام الأدبي أو الثقافي، بل تشكل مكوّنًا داخليًا فيه. فالترجمات تُنتَج وتُقيَّم ضمن أنساق ثقافية معيّنة تتحكم في موقعها ووظيفتها: هل ستكون خاضعة للنصوص المهيمنة، أم ستعمل كأداة لتجديد الأدب والثقافة؟ وعليه، فإن المترجم لا يتحرك بوصفه فردًا حرًّا يختار بإرادته، بل هو جزء من شبكة نسقية تُحدِّد له ما يمكن وما لا يمكن ترجمته، وما يُسمح بتمثيله أو حجبه. في هذا السياق، تُصبح القصدية المترجمَة قصدية مزدوجة: قصدية الناص الأصلي، وقصدية النظام الثقافي الذي يُعيد إنتاج النص.
في السياق العربي الحديث، يمكن رصد مثل هذا التفاعل النسقي في الترجمات التي أُنجزت خلال القرن التاسع عشر او ما يعرف بالنهضة العربية. فاختيارات مترجمي النهضة لم تكن محض قرارات لغوية تقنية، بل كانت موجهة بقصدية ثقافية تتطلّع إلى "تمدين" المجتمع العربي وفق نماذج أوروبية. فتمت ترجمة الأعمال التي تعكس روح العقلانية والعلمنة والانضباط الاجتماعي، وتُركت أعمال أخرى أقلّ انسجامًا مع المشروع النهضوي. هذا ما يجعل من عملية الترجمة في تلك الفترة ليست فقط نقلاً للمعرفة، بل تدخلاً معرفيًا مؤدلجًا يُعيد إنتاج الثقافة في سياق محلي موجّه.
تعمل القصدية الثقافية كمنتج للنص والسياق، وتقوم بتوليد معانٍ ترتكز على بنى اجتماعية مشتركة وليس على الإدراك الفردي. إنها تُشكّل قصدية المؤلفين والمترجمين وتُقيّدها ، الامر الذي يُنتج إعادة صياغة عن طريق إعادة صياغة أيديولوجية حين تعكس قرارات الترجمة علاقات القوة الساندة.
التأويلية وما بعد القصدية والتوجهات المستقبلية
تُوضح مبادئ التأويل الطبيعة التأويلية للترجمة، لا سيما فيما يتعلق بتفاعل القصدية المتعددة. تُقدم ظاهراتية التأويل عند بول ريكور الترجمة باعتبارها حدث نقلِ للمعنى ينطوي على تفاعل بين نوايا المؤلف والنص والترجمة. يصف مفهوم هانز جورج غادامير "اندماج الآفاق" كيف يدخل الفهم المسبق للمترجم، المُشكّل بسياقه التاريخي والثقافي، في حوار مع الاختلاف الجوهري للنص. ولا تقتصر هذه العملية الحوارية على استعادة معنى أصلي فحسب، بل تُولّد فعلًا تأويليا جديدًا، تلتقي فيه القصدية المتنوعة لإنتاج شكل نصي جديد. يُتوّج هذا التوليف التأويلي بـإعادة الخلق عبر الحوار التأويلي، مُنتجًا معنى لا ينتمي إلى المؤلف ولا إلى المترجم وحدهما.
إن إطار ما بعد القصدية، الذي يتجلى في مقال بارت الشهير "موت المؤلف"، الذي يطرح تصورًا مغايرًا يعتبر أن النص، لحظة خروجه إلى الفضاء الخطابي، يتحرر من سطوة مؤلفه وينفتح على شبكة غير محدودة من التأويلات. لم يعد النص، في هذا المنظور، حاملاً لمعنى ثابت يُستعاد، بل يصبح فضاءً دلاليًا متعدّدًا تُنتجه علاقات القراء والسياقات. يُعزّز جاك دريدا هذا الاتجاه من خلال مفهومه لـ"القابلية للتكرار" (iterability)، حيث يرى أن العلامة اللغوية لا تملك معنى جوهريًا أصيلًا، بل تكتسب دلالتها من قابلية تكرارها في سياقات مختلفة. هذه القابلية، التي تنزع الاستقرار عن العلامة، تؤدي إلى تآكل مركزية المعنى المفترض، وتؤسس لفكرة أن كل قراءة هي إعادة كتابة، وأن كل ترجمة هي تأويل مشروط بسياقاتها الثقافية والمعرفية. في ضوء هذا الشد بين الرغبة في ضبط المعنى ضمن إطار نية المؤلف، والانفتاح على لانهائية التأويل، تظهر الترجمة كفعل قصدي تفاوضي. فالمترجم لا ينقل معنى جاهزًا، بل يواجه تعددية محتملة تتطلب منه اتخاذ قرارات تأويلية ذات طابع إبداعي وأخلاقي، يمارس عبرها عامليته ضمن فضاء يتأرجح بين النص الأصل وسياقات التلقي الجديدة.فبدلاً من خلق فراغ، يُمكّن هذا الفضاء ما بعد القصدية من "ميلاد المترجم كمبدع قوي للمعنى". بصفته فاعلًا اجتماعيًا وأخلاقيًا، يبني المترجم معانٍ جديدة بنشاط، ويحول النص من خلال قصدية مُحددة ومُستنيرة ثقافيًا. وتولد هذه العملية تعددًا من التأويلات ، وتشكل "إعادة الخلق عبر التأويل المحرر"، الذي تنشأ فيه الحرية التأويلية من السيولة المتأصلة في اللغة، وهو ما يمكّن المترجم من المشاركة في تأليف الوجود المستمر للنص.
الخاتمة
يُعيد النظر في الترجمة من منظور القصدية توجيه النقاش من هاجس الوفاء للنص الأصل إلى تحليل معقد للفاعليات التأويلية التي تشكل المعنى وتعيد إنتاجه. لا تُفهم الترجمة بوصفها فعلًا تواصليًا ساذجًا، بل كسيرورة معرفية تُمارس ضمن أنساق ثقافية متشابكة، تتقاطع فيها نية المؤلف وقرارات المترجم والبنى الثقافية المُضمرة. ومع الانفتاح على نظريات ما بعد القصدية، يتبدى المترجم بوصفه شريكًا خلاقًا في إنتاج النص، لا مجرد وسيط. في هذا السياق، تتولد إمكانيات تأويلية جديدة تُعيد تعريف الترجمة كفعل إبداعي وثقافي وسياسي. تفتح هذه الرؤية إمكانيات بحثية واعدة تمتد إلى علم الأعصاب الادراكي وتحليل الأداء الترجمي والنقد الثقافي للترجمة الآلية. وفي قلب هذا كلّه، تبقى القصدية هي الخيط الناظم لفهم العلاقة بين اللغة والمعنى، وبين الترجمة والتأويل، وبين الفعل الترجمي والواقع الثقافي الذي يُعاد إنتاجه عبر اللغة. إن الترجمة، بهذا المعنى، ليست مجرد إعادة قول، بل هي إعادة وجود.


 دخول مشروع إستثمار غاز الناصرية والغراف مرحلة التنفيذ
دخول مشروع إستثمار غاز الناصرية والغراف مرحلة التنفيذ
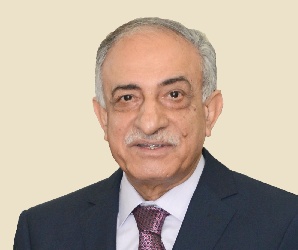 خطوط زمن البياتي.. سيرة ذاتية لخبير صحفي
خطوط زمن البياتي.. سيرة ذاتية لخبير صحفي
 إطلاق الموسوعة الشاملة لحلبجة في 9 أجزاء
إطلاق الموسوعة الشاملة لحلبجة في 9 أجزاء
 (كلام الناس) يواصل جولته الإستقصائية في مستشفى الرشاد
(كلام الناس) يواصل جولته الإستقصائية في مستشفى الرشاد
 العراق يشارك في إجتماع لجنة الناشئين والهواة
العراق يشارك في إجتماع لجنة الناشئين والهواة
 إنطلاق بطولة ألكان 2025 في ضيافة المغرب
إنطلاق بطولة ألكان 2025 في ضيافة المغرب
 الجوية تبحث عن الفوز السادس ودهوك يضيّف النجف في النجوم
الجوية تبحث عن الفوز السادس ودهوك يضيّف النجف في النجوم
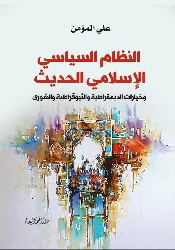 بمناسبة صدور طبعته الثالثة.. قراءة في كتاب النظام السياسي الإسلامي الحديث
بمناسبة صدور طبعته الثالثة.. قراءة في كتاب النظام السياسي الإسلامي الحديث
